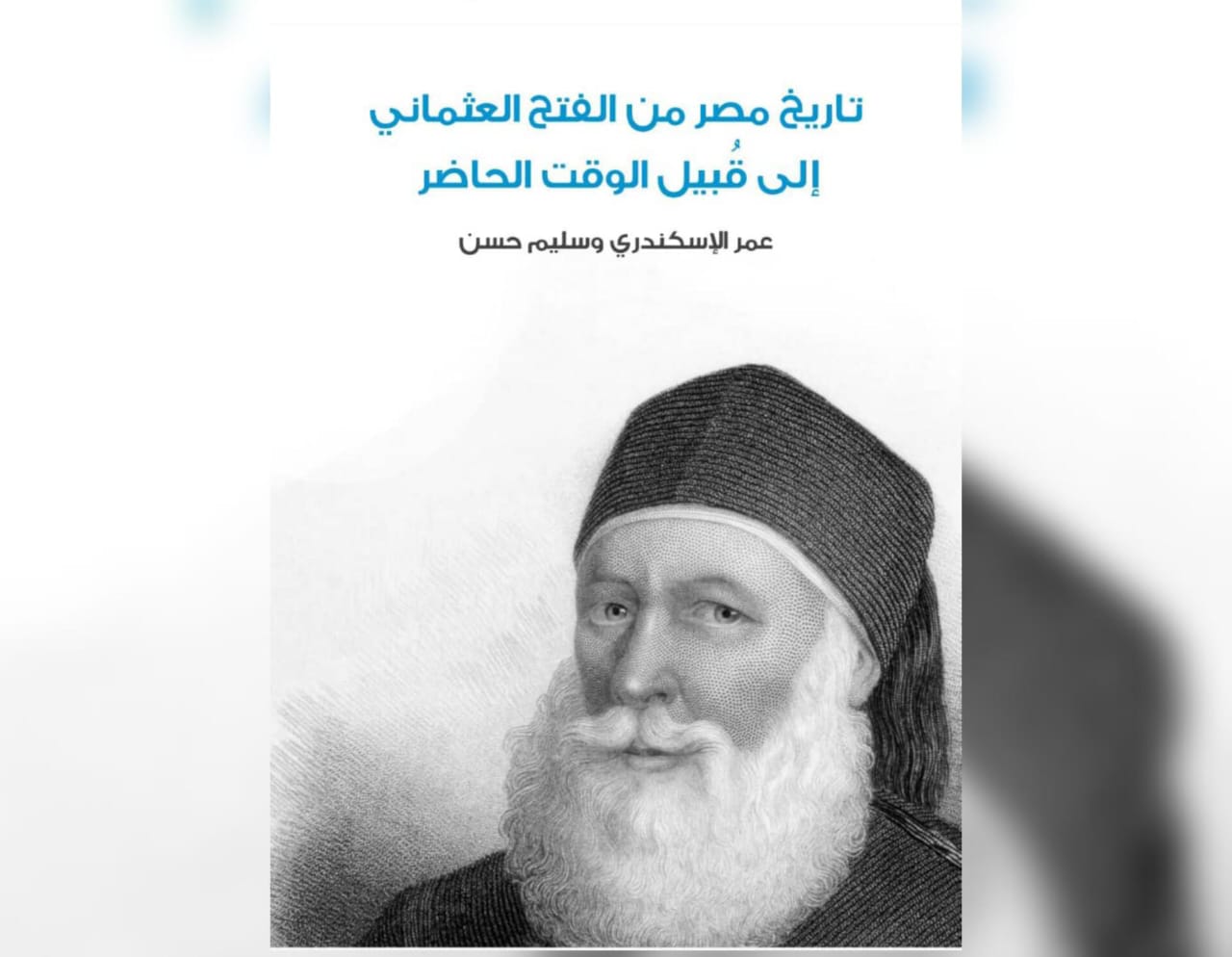
مقدمة
في إطار اهتمام مجلة بريم بتسليط الضوء على المؤلفات التاريخية التي أسهمت في توثيق مسيرة الشعوب العربية وتحولاتها الكبرى، يأتي هذا العرض لكتاب «تاريخ مصر من العهد العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر» تأليف عمر الإسكندري وسليم حسن، الصادر عن مؤسسة هنداوي عام 2014م، والذي يُعد من أبرز الأعمال التي تناولت التاريخ المصري الحديث بمنهج يجمع بين السرد الوقائعي والتحليل النقدي للأحداث.
يستعرض الكتاب، في ثلاثة أبواب متسلسلة، المراحل الكبرى التي مرت بها مصر منذ خضوعها للسيطرة العثمانية وحتى عهد محمد علي باشا وما بعده، متتبعًا جذور التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شكّلت ملامح الدولة الحديثة. ويتميز العمل بدقته في العرض، وثراء مصادره، وموضوعيته في قراءة العلاقة بين مصر والدولة العثمانية من جهة، وبين مصر وأوروبا من جهة أخرى.
وتسعى مجلة بريم من خلال هذا العرض إلى إبراز القيمة المعرفية لهذا المؤلف، وإعادة تقديمه للقارئ العربي المعاصر كأحد النصوص المؤسسة في دراسة التاريخ المصري الحديث، لما يحمله من رؤية تحليلية متماسكة، ولغته التي تجمع بين عمق المؤرخ ووعي المفكر الوطني.
كتاب “تاريخ مصر من العهد العثماني إلى قُبيل الوقت الحاضر”، تأليف عمر الإسكندري وسليم حسن، مراجعة أ. ج. سفدج، الناشر مؤسسة هندواي، 2014م، جاء الكتاب في ثلاثة أبواب، خُصِّص الباب الأول لتاريخ مصر في عهد الدولة العثمانية في ثلاثة فصول، وأُفرِد الباب الثاني لتاريخ مصر من الحملة الفرنسية إلى انتهاء عهد محمد علي باشا في ثلاثة فصول أيضًا، وجُعِل الباب الثالث لتاريخ مصر بعد محمد علي في أيام الخديوي إلى عهد الاحتلال البريطاني في سبعة فصول، ويُختَم كل باب بملخص لأبرز الأحداث التي شملتها المدة التي تناولها المؤلفان في الباب، وجاء الكتاب في 316 صفحة يمكن عرض متنه بشكل موجز على النحو الآتي:
الباب الأول: عهد الدولة العثمانية
الفصل الأول: الفتح العثماني لمصر
قامت بين الدولة العثمانية ودولة المماليك في مصر منذ عصر برقوق وبايزيد الأول صلات ودية ومعاهدات، وظلَّت حتى زمن بايزيد الثاني الذي توترت علاقته بالسلطان قايتباي بسبب إيواء الأمير «جم»، والنزاع على إمارة أبناء ذي الغادر، والهدايا الهندية، فاندلعت الحرب بين الطرفين في الشام، وانتصر المصريون أولًا، ثم عقد الصلح، إلَّا أنَّه أورث عداءً ومنافسة على زعامة العالم الإسلامي. فعمد العثمانيون إلى تحريض القبائل والإمارات التابعة لمصر على العصيان، وأعاقوا تجارتها، ومنعوا وصول الرقيق الجركسي وهو ما أضر بالجيش المصري، وآوى المماليك خصوم العثمانيين من الأمراء والسلاطين، كما تقاربوا مع الشاه إسماعيل الصفوي، مما زاد الشقاق، إذ سمح السلطان الغوري بمرور وفد صفوي إلى البندقية للتحالف ضد العثمانيين، فاستغل السلطان سليم الأول ذلك وعدَّ مصر خصمًا له، وبعد أن هزم الصفويين الصفويين، وجَّه أنظاره لمصر، خاصة بعد أن قطعت إمارة الغادرية الموالية لمصر إمداداته، فجهز الغوري جيشًا كبيرًا رغم ضعف الموارد، وخرج بنفسه ومعه كبار رجال الدولة والعلماء، أما سليم فقاد جيشًا يفوق عدده وعدته، ومعه مدافع وبنادق حديثة. والتقى الجيشان في مرج دابق (922هـ/ 1516م) شمالي حلب، وأظهر المصريون في البداية نصرًا على الميمنة والقلب، وكاد سليم يفر، لكن خيانة «خير بك» نائب حلب و«جان بردي الغزالي» نائب حماة قلبت الموازين، فانهار الجيش المصري تحت ضربات المدفعية العثمانية وتخاذل المماليك القدماء. وأصيب الغوري بالفالج ومات في ساحة القتال، وانتهت المعركة بانتصار ساحق للعثمانيين، فسقطت مدن الشام في أيديهم بلا مقاومة. انهزم المصريون وعاد الناجون إلى مصر، وانضم الخونة إلى العثمانيين. واستولى سليم على حلب ودمشق، ونظم شؤون الشام قبل التوجه إلى مصر. وتولى طومان باي الحكم بمصر بعد الغوري. فجمع جيشًا ودافع عن القاهرة بخنادق في الريدانية(922هـ/ 1517م)، لكن العثمانيين التفوا حول المصريين بثلاثة جيوش، فصمد المماليك قليلًا وقتلوا عددًا من القادة العثمانيين، ثم انهزموا تحت قصف المدافع، ودخل العثمانيون القاهرة، لكن طومان باي شن هجومًا مفاجئًا بمساعدة العامة وأوقع خسائر بالعثمانيين، قبل أن يُطرد مرة أخرى ويتحصن بالصليبة، وبعد حصار طويل انهزم وفر إلى الجيزة. وحاول طومان باي الصلح مع سليم على أن يبقى نائبًا له بمصر، لكن المماليك رفضوا، والتقى الجيشان مجددًا قرب «وردان» (ربيع الأول 923هـ)، وحقق المصريون تفوقًا أولًا، لكن المدافع العثمانية رجحت الكفة، فانكسر المماليك نهائيًا، وفر طومان باي إلى عرب البحيرة عند حسن بن مرعي الذي خانه وسلمه للعثمانيين، وأبقاه سليم عنده فترة يسأله عن أحوال مصر، فأوهمه بالأمان، ثم أمر بشنقه عند باب زويلة في 21 ربيع الأول 923هـ/ 1517م، ليكون السلطان المصري الوحيد الذي أعدم شنقًا. وأقام سليم نحو 8 أشهر متنقلًا بين بولاق، والقلعة، والجيزة، والروضة، والإسكندرية، فنقل النفائس والكتب والأعمدة إلى الأستانة، ونفى أبناء السلاطين وكبار العلماء والقضاة إلى القسطنطينية، وأخذ الصناع المهرة (نحو ألف) فأدَّى ذلك إلى تدهور كثير من الصناعات بمصر. وولى «خير بك» على مصر و«جان بردي الغزالي» على الشام. بسقوط طومان باي ودخول السلطان سليم، صارت مصر ولاية عثمانية، وفقدت استقلالها بعد أن كانت زعيمة العالم الإسلامي.
الفصل الثاني: نبذة في تاريخ الدولة العثمانية
1_ منشأ العثمانيين ونهوضهم
الأصول والنشأة:
العثمانيون فرع من القبائل التركية المنحدرة من الجنس المغولي، الذي خرج من أواسط آسيا وانتشر غربًا، ومن تلك القبائل “الأغوز” التي هاجرت إلى آسيا الصغرى هربًا من بطش المغول، وكان يرأسها أرطغرل. وعندما ساعد أرطغرل السلاجقة في قتال المغول، كافأه السلطان السلجوقي علاء الدين بمنحه أرضًا قرب “إسكي شهر”، وهناك ولد ابنه عثمان بن أرطغرل (656هـ/ 1258م) الذي أسس الدولة العثمانية. ومع سقوط الدولة السلجوقية (699هـ / 1300م)، استقلت إمارة عثمان، واندمجت فيها تدريجيًا بقية الإمارات التركية، بدأ عثمان وابنه أرخان بفتح أراضٍ من الدولة البيزنطية، وجعل الأخير مدينة “بروسة” عاصمة للدولة بعد فتحها (726هـ / 1326م). وتابع أرخان الفتوحات وأسس الجيش الإنكشاري، الذي ضم أبناء النصارى الذين أُخذوا صغارًا، وربيّوا تربية إسلامية وعسكرية صارمة، أصبحوا عماد القوة العثمانية لقرون، لكن فسادهم لاحقًا أدَّى إلى القضاء عليهم في عهد السلطان محمود الثاني (1826م).
وبدأ العثمانيون بالتوسع الأوروبي بفتح “غليبولي” (1357م). ثم تولى الحكم مراد الأول (761-792هـ / 1359-1389م) فوسع الدولة في البلقان، وجعل “أدرنة” عاصمة، وانتصر على الصرب والبلغار في معركة “قوصوة” (1389م) لكنه قُتل فيها. وجاء بعده بايزيد الأول (1389-1402م) الذي هزم جيوش أوروبا في “نيقوبوليس” (1396م)، وأخضع اليونان، وكان يتهيأ لفتح القسطنطينية لولا أن هزمه تيمورلنك في أنقرة (1402م) وأسره حتى وفاته. وبعد اضطرابات داخلية بين أبناء بايزيد، استقرت الدولة بيد محمد الأول (1413-1421م)، فأعاد تماسكها، ثم جاء مراد الثاني (1421-1451م) الذي واصل الفتوحات، وانتصر على الأوروبيين في معركة “وارنة” (1444م). وخلفه ابنه محمد الثاني (الفاتح) (1451-1481م)، الذي أعد جيشًا ضخمًا وتمكن سنة 1453م من فتح القسطنطينية، منهيًا الدولة البيزنطية ومعلنًا بداية العصر الحديث.
2_ اضمحلال الدولة البيزنطية وسقوط القسطنطينية في يد العثمانيين
نُقلت عاصمة الدولة الرومانية إلى القسطنطينية (330م)، وانقسمت الإمبراطورية إلى غربية (سقطت عام 476م) وشرقية (البيزنطية) التي استمرت قرونًا رغم غزوات الفرس والعرب والترك. وتعددت أسباب سقوطها، فكان أبرزها الحملة الصليبية الرابعة (1204م)، التي استولى الصليبيون فيها على القسطنطينية، وأسسوا “الدولة اللاتينية” التي استمرت ستين عامًا، خربوا فيها البلاد ونهبوا ثرواتها، وعندما استعاد البيزنطيون المدينة (1261م)، كانت قد ضعفت وانقسمت، فضلًا عن الهجمات التركية المستمرة: التي انتزعت معظم أراضيها في آسيا والبلقان، وأرهقت سكانها بالغزو والتشريد، والوباء الأسود (1347م) الذي اجتاح أوروبا وقضى على نصف سكان بعض المناطق، مما أضعف الدولة، وقلّل قدرتها على حشد الجيوش. وأدَّت محاولات توحيد الكنيستين الشرقية والغربية بإملاء من البابا إلى انقسام حاد داخل الدولة، واندلاع صراعات بين البطارقة والأباطرة. كما شهدت البلاد نزاعات متكررة على العرش منذ القرن الثالث عشر، مما زاد من الفوضى. وبعد الحملة اللاتينية، استقلت شعوب البلقان عن الحكم البيزنطي، وصارت تستعين بالأتراك ضد الإمبراطورية. ومع ضعف السكان بسبب الوباء، لم تعد القسطنطينية قادرة على الصمود أمام القوة العثمانية الصاعدة. وكل هذه العوامل مهدت لفتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية عام (857هـ/ 1453م)، فسقطت الدولة البيزنطية نهائيًا بعد أن دامت أكثر من ألف عام.
وهكذا نشأت الدولة العثمانية من قبيلة تركية صغيرة لتصبح قوة عالمية بفضل التنظيم العسكري والفتوحات المتواصلة، حتى تمكنت بقيادة محمد الفاتح من إسقاط القسطنطينية. وفي المقابل، أدَّى ضعف الدولة البيزنطية نتيجة الغزو الصليبي، والتفكك الداخلي، والوباء، والهجمات التركية المستمرة، إلى سقوطها النهائي، وهو الحدث الذي عُدَّ بداية التاريخ الحديث.
3_ الدولة العثمانية في أوج عظمتها (857-974هـ / 1453-1566م)
جلس السلطان محمد الثاني (الفاتح) على العرش عام 857هـ/1453م، فاتخذ فتح القسطنطينية هدفه الأول، وبعد استعداد عسكري غير مسبوق نجح في اقتحام المدينة بعد حصار عظيم، مستخدمًا المدافع الضخمة وحيلة نقل الأسطول إلى القرن الذهبي. وبمقتله إمبراطور الروم سقطت الدولة البيزنطية، وأصبحت القسطنطينية عاصمة آل عثمان، واتخذت اسم إسلامبول. واستمر الفاتح في الفتوح، فأخضع المورة، والصرب، والبوسنة، وطرابزون، كما توسع في أملاك البندقية، وحاول غزو إيطاليا فأخفق بسبب مقاومة ألبانيا وهزيمته عند بلغراد، فمات سنة 886هـ/1481م بعد أن وصل العثمانيون إلى ذروة مجد جديد، فجاء بعده عهد بايزيد الثاني (886-918هـ/1481-1512م) وكان بايزيد ميالًا للسلم، منشغلًا بالصراع مع أخيه جم، فلم يزد في أملاك الدولة إلا قليلًا. لكن البحرية العثمانية تقوّت في عهده وبدأت تهدد سواحل أوروبا، وانتهى حكمه بتنازله لابنه سليم بعد ضغط الإنكشارية، فكان عهد سليم الأول (918-926هـ/1512-1520م) الذي برز كأعظم سلاطين آل عثمان، فهزم الصفويين في الشرق في موقعة جالديران (920هـ/1514م)، وسيطر على ديار بكر وكردستان، وفي الجنوب: فتح الشام ومصر (923هـ/1517م)، وحصل على الشرعية الدينية بتنازل آخر الخلفاء العباسيين عن الخلافة له، فأصبح العثمانيون زعماء العالم الإسلامي. وكان سليم شديد البأس، لكنه توفي قبل أن يكمل فتوحه، فجاء بعده عصر سليمان القانوني (926-974هـ/1520-1566م) الذي يُعد عصره ذروة المجد العثماني، إذ جمع بين قوة الدولة في السياسة والعسكر والبحرية، وبين مكانتها الروحية كزعيمة للعالم الإسلامي، فاستولى على بلغراد (927هـ/1521م)، وفتح رودس (928هـ/1522م) من فرسان القديس يوحنا، وانتصر على المجر في موقعة موهاكس (932هـ/1526م)، فقُتل ملكهم لويس الثاني، وأصبحت المجر تابعة للعثمانيين، وحاصر فيينا (935هـ/1529م) لكنه فشل بسبب الشتاء ونقص المدافع، وانتهت الحروب مع النمسا بتقسيم المجر، ثم خضعت ترنسلفانيا والجزء الأكبر من المجر للعثمانيين مع دفع جزية، ذلك كان في أوروبا. أما في الشرق فقد استولى على العراق وبغداد وأجزاء من أرمينية، وصارت الدولة صاحبة نفوذ واسع من البحر الأدرياتيكي حتى الخليج العربي. وقد ازدهرت البحرية العثمانية وبلغت قوة هائلة بفضل قادة بارزين، منهم: خير الدين بربروس الذي قهر الأساطيل الإسبانية والبندقية، وانتصر في بروزة (945هـ/1538م). ودراغوت (طرغود) الذي سيطر على المهدية وحقق انتصارات بارزة. وبيالة باشا الذي هزم دوريا في معركة جربة (967هـ/1560م). كما ظهر الملاحان الكبيران بيري ريس وسيدي علي، ومع ذلك فشل العثمانيون في الاستيلاء على مالطة بعد حصار طويل (973هـ/1565م).
وهكذا أصبح العثمانيون القوة الأعظم في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي. كما ارتبطوا بعلاقات سياسية مع فرنسا ضد إسبانيا، وفرضوا هيمنتهم على معظم أوروبا الشرقية. وبوفاة السلطان سليمان القانوني عام 974هـ/1566م أثناء حملته الأخيرة على المجر عن عمر 76 سنة، انتهى أزهى عصور الدولة العثمانية، حيث بلغت آنذاك أوسع حدودها وأقوى هيبتها العسكرية والسياسية.
4 _ ابتداء اضمحلال الدولة العثمانية (974 _ 1049هـ/ 1566 _ 1640م)
بلغت الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني (سليمان الأكبر) ذروة مجدها، فامتدت سيطرتها من مكة إلى بودا، ومن بغداد إلى الجزائر، وهيمنت على معظم سواحل البحر المتوسط والبحر الأسود والأحمر. لكن بوفاته عام 974 هـ بدأ عهد الانحطاط، لعدة أسباب داخلية وخارجية، فكانت أبرز الأسباب الخارجية تتمثل في صعود القوى الأوروبية (روسيا، والمجر، والنمسا، وبولندا) وظهور قواد بارزين فيها. والأسباب الداخلية تنوع شعوب الدولة وصعوبة ضبطها، وفساد الإدارة بعد سليمان، وضعف السلاطين، وانغماسهم في اللهو، وانحلال الإنكشارية الذين استبدوا بالسلطة وتراجع مستواهم الحربي. كما غاب الإصلاح العسكري مقارنة بالدول الأوروبية، فكان سليم الثاني (974 _ 982هـ): سلطان ضعيف، لقب بالمجنون، مراد الثالث (982 _ 1003هـ): ضعيف خاضع لنساء القصر، خاصة زوجته صفية ذات الأصل البندقي، فشهد عهده بداية الفوضى الداخلية. ومحمد الثالث (1003 _ 1012هـ) استمر نفوذ والدته صفية. وأحمد الأول (1012 _ 1026هـ): عقد صلحًا مع النمسا اعترف فيها بالندية، ما أظهر ضعف الدولة. ومراد الرابع (1032 _ 1049): آخر السلاطين الحربيين، قوي البأس. فرض النظام بالقوة، قضى على تمرد الإنكشارية بقتل الآلاف منهم. وأعاد فتح أريوان (1635م) واستعاد بغداد من الصفويين (1638م) بعد حملة ناجحة، لكنه توفي شابًا (28 عامًا)، وبموته انتهى عهد القوة العسكرية للسلاطين.
٥ _ عهد سلطة الوزراء – أسرة كبريلي (1049 _ 1103هـ/ 1640 _ 1691م)
بعد مراد الرابع تولى السلطان إبراهيم الأول (1049 _ 1058هـ)، وكان ضعيفًا، فانتشر الفساد وسوء الإدارة، وعجز عن فتح جزيرة كريت، ثم عُزل وقُتل، وخلفه محمد الرابع (1058 _ 1099هـ) الذي عاصر اضطرابات داخلية وهزائم بحرية، حتى برز دور أسرة كبريلي، فتولى محمد كبريلي (1066هـ/ 1656م) الصدارة العظمى بشرط الاستقلال التام في الإدارة، وأعاد النظام بحزم شديد وقتل آلاف المفسدين، وحرر الدردنيل، ومهد الطريق لفتح كريت. وواصل أحمد كبريلي (1072 _ 1087هـ) سياسة أبيه، فقاد حربًا ضد النمسا (1663م) وانتهت بصلح فرفار (1664م)، ثم استكمل فتح كريت (1669م)، ودخل في حرب مع بولندا بسبب القوزاق، وانتزع حصونًا وأراضي، لكنه واجه مقاومة عنيفة من القائد جون سوبيسكي، وعقد صلح زرانو (1676م) الذي ثبت مكاسب عثمانية في بادوليا وأوكرانيا، ثم جاء بعدهما قرة مصطفى باشا (1087هـ/ 1676م): صهر الأسرة، فكان طموحًا لكنه مغرور، فخطط لغزو فيينا (1683م) بجيش ضخم، وحاصرها، لكنه توانى في اقتحامها. وتدخل جون سوبيسكي ملك بولندا وأنقذ المدينة، فانكسر الجيش العثماني هزيمة ساحقة، وكانت بداية الانحسار العثماني في أوروبا. وأُعدم قره مصطفى، وجاء بعده مصطفى كبريلي (1098 _ 1103هـ) الذي حاول إصلاح الجيش، وحقق بعض الانتصارات باسترجاع بلغراد (1690م)، لكنه هُزم وقُتل في معركة سلانكمن (1691م)، وهكذا شكلت أسرة كبريلي مرحلة انتعاش نسبي وسط الانحطاط، لكن بعد موت مصطفى كبريلي فقدت الدولة الأمل في استعادة قوتها. وتكوّن الحلف المقدس (النمسا، وبولندا، والبندقية، وروسيا)، فانتزع من العثمانيين المجر وكرواتيا وسلافونيا وترانسلفانيا واليونان وأزمير، وهزم الجيش العثماني بقيادة السلطان مصطفى الثاني في معركة زنتا (1697م)، واختُتمت هذه المرحلة بصلح كارلوفيتز (1699م) الذي أفقد الدولة العثمانية معظم ممتلكاتها في أوروبا الوسطى، وأكد تراجعها النهائي أمام أوروبا.
٦ _ الدولة العثمانية وحروبها مع الروسيا والنمسا في القرن الثامن عشر
شهد القرن الثامن عشر بداية ضعف الدولة العثمانية وظهور ما عرف بالمسألة الشرقية، إذ أخذت دول أوروبا تبحث في مصير أملاكها ومن يكون وارثها بعد أن بدا واضحًا انحطاطها، فكان السبب في هذا الضعف أمرين أساسيين: صعود روسيا القيصرية وتحالفها مع النمسا لطرد الأتراك من أوروبا، ثم اضطراب الإدارة العثمانية وثورات الشعوب الخاضعة لها. وبرز قيصر روسيا بطرس الأكبر في مطلع هذا القرن، فأدخل إصلاحات واسعة في بلاده جعلتها تواكب الحضارة الأوروبية، وأولى اهتمامًا خاصًا بالوصول إلى البحار، فانتزع أراضي السويد في معاهدة نيستاد، كما انتزع من العثمانيين مدينة آزاق بمعاهدة كرلوتز، غير أن العثمانيين استعادوها بعد حرب بروث سنة 1711م، حين وقع القيصر نفسه على وشك الأسر لولا خيانة القائد العثماني بلطجي باشا، وحاولت الدولة بعد ذلك أن تستعيد نفوذها في المجر والمورة، فنجحت في استرداد المورة، لكنها انهزمت أمام النمساويين، فاضطرت إلى معاهدة بساروتز 1718م التي أبقت بلغـراد وما حولها في يد النمسا. وفي فارس انتهز العثمانيون اضطراب أوضاعها فاستولوا على بعض أقاليمها، ثم عقدوا مع الروس معاهدة 1724م لتقسيم النفوذ، لكن بروز نادر شاه أفسد عليهم مكاسبهم وأجبرهم على الجلاء. أما الروس والنمسا فجددا تحالفهما وأخذا يستعدان لمهاجمة الدولة، حتى وقعت حرب 1735 _ 1739م، وحقق الروس بعض الانتصارات، لكن العثمانيين صمدوا ببسالة، فعقدت معاهدة بلغراد التي أعادت للدولة بلغراد والصرب والبوسنة ومنعت روسيا من دخول البحر الأسود، فكان نصرًا عثمانيًا كبيرًا ساعدت فيه فرنسا خوفًا من توسع روسيا والنمسا. غير أن فترة السلم لم تدم، إذ جاءت كاترين الثانية إلى عرش روسيا سنة 1762م، وسعت إلى تنفيذ مشروعها الشرقي، فعملت على التدخل في شؤون بولندا وإثارة شعوب البلقان واليونان ضد الدولة، حتى نشبت حرب 1768م. كانت الكفة فيها لروسيا، إذ استولت على ملدافيا والأفلاق والقرم، وهزمت الأسطول العثماني في جشمة، فأجبرت الدولة على عقد معاهدة كوجك قينارجه 1774م، التي لم تمنح روسيا أراضي واسعة فحسب، بل منحتها حق حماية المسيحيين العثمانيين والتدخل في شؤون الدولة، وهو امتياز خطير كان أساس تدخلاتها المستمرة في القرون التالية.
ثم ضمت روسيا القرم سنة 1783م رغم المعاهدات السابقة، واعترفت الدولة بذلك في معاهدة القسطنطينية 1784م. وأثار هذا ضغينة العثمانيين، فاندلعت حرب جديدة سنة 1787م، شاركت فيها النمسا بداية لكنها انسحبت سريعًا بمعاهدة سستوفا 1791م، بينما واصل الروس القتال بقيادة سوفاروف وحققوا انتصارات كبيرة، منها سقوط إسماعيل. ولم تنته الحرب إلا بمعاهدة ياش 1792م التي أقرت بسيادة روسيا على القرم والأراضي حتى نهر الدنيستر، واعترفت بجميع شروط كوجك قينارجه. وهكذا انتهى القرن الثامن عشر وقد رسخت روسيا نفوذها على البحر الأسود، وأثبتت نفسها قوة عظمى في أوروبا، بينما واصلت الدولة العثمانية فقدان أراضيها ومكانتها شيئًا فشيئًا. وكان هذا القرن إيذانًا بمرحلة جديدة من الضعف العثماني، حيث غدت الدولة في نظر أوروبا “الرجل المريض”، وصارت المسألة الشرقية محور السياسة الدولية في القرون التالية.
الفصل الثالث: حكم العثمانيين في مصر (923 _ 1213هـ/ 1517 _ 1798م)
باستيلاء السلطان سليم على مصر في سنة 923هـ/ 1517م أصبحت مصر جزءًا من أملاك الدولة العثمانية، ودخلت في طور طويل دام نحو ثلاثة قرون لم يكن لها فيه شأن سياسي يُذكر، حيث عاشت البلاد معظم ذلك العصر في حالة فتنة مستمرة بين المماليك أنفسهم، وبينهم وبين الولاة العثمانيين، وبين الجيش العثماني. ورغم كثرة الحوادث، لم يكن لها أثر دائم على تاريخ مصر، لذا نركز على وصف حالة البلاد بشكل عام.
1_ نظام الحكومة
بعد فتح مصر، وضع السلطان سليم نظامًا لإدارة البلاد يضمن بقاءها خاضعة للدولة، من خلال ثلاث سلطات متنافسة:
أ _ الوالي: كان مسؤولًا عن تنفيذ أوامر السلطان ومراقبة أعمال الحكومة.
ب _ جيش الحامية: شكله السلطان سليم من ست فرق بقيادة ضباط مقيمين بالقلعة، وأسند إلى مجلس ديوان الحق في رفض مشاريع الوالي إذا لم ير فيها مصلحة.
ت _ المماليك: عين كل بيك منهم على سنجق من المديريات الأربع والعشرين، تعرف هذه المديريات بالسناجق.
وأضاف السلطان سليمان القانوني مجلسين: «الديوان الأكبر» للشئون الخطيرة و«الديوان الأصغر» للشئون اليومية، وزاد فرقة سابعة للجيش تضم المماليك العتقاء، فبلغت قوة الجيش نحو 12,000 رجل. كان الهدف من هذه السياسة ضمان خضوع مصر للدولة دون مراعاة مصالحها.
2_ الضرائب
فرض العثمانيون على مصر خراجًا سنويًا يسمى «الميري» يجمع من ضرائب الأراضي ويُرسل للسلطان، وكان لكل ملتزم الحق في جمع خراج منطقته مقابل إعفاء أرضه من الضرائب وزراعة الفلاحين لها مجانًا، وإلى جانب الضرائب الرسمية، كان المماليك يفرضون على الأهالي ضرائب إضافية، ما أدى إلى تفاقم الفقر بين الفلاحين حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري. وأدخل العثمانيون عدة ألقاب لمصر مثل «باشا» للولاة، و«أغا» لقائد الجيش، و«كتخدا» لوكيل الباشا، و«بيك» و«أفندي» بمعانٍ محددة.
3_ المباني
لم تعد مصر، بعد الفتح العثماني، تتمتع بالثروة الضخمة التي كانت عليها، فتراجع إنشاء المباني الفاخرة والزخرفة مقارنة بالعصور السابقة، مع بقاء بعض الأوقاف الدينية دون مساس. وظهرت المباني التركية البارزة في هذا العصر، خصوصًا في الجوامع التي اعتمدت على القباب بدل الأسقف المستوية، ومن أبرزها: جامع سليمان باشا بالقاهرة (935هـ/ 1528م)، وجامع سنان باشا ببولاق (979هـ/ 1571م)، وجامع الملكة صفية بالداودية (1019هـ/ 1610م).
وبرز المماليك، خاصة عبد الرحمن كتخدا، في إنشاء وتجديد الجوامع والسبل والقناطر، كما اهتموا بالأزهر وتشجيع طلبة العلم، وعلى الرغم من تراجع الإمكانات المالية، حافظ العثمانيون على المباني العربية وأجروا ترقيعات وتحسينات، وإن لم تصل إلى مستوى روعة المماليك. وقد أدَّى النمط الأوروبي لاحقًا إلى هدم بعض المباني لإقامة شوارع وميادين جديدة، كما في شارع محمد علي.
4_ المماليك وأهل البلاد
لم يمتزج المماليك بالسكان الأصليين، وكان معظمهم يتركز على الحروب والفروسية، ونادرًا ما كونوا أسرًا، وفي أواخر العصر العثماني، كثرت مظاهر الترف والابتزاز المالي للمماليك، فيما ظل المصريون الأصليون تحت وطأة الضرائب والأعباء المتعددة، مع انتشار الفقر وانعدام الأمن وتراجع الصناعات والزراعة.
رغم ذلك، بقي بعض النشاط الصناعي كصناعة السكر والحرير والزجاج في بعض المناطق. أما الثروة المتجمعة لدى كبار المماليك والتجار، فقد كانت تصرف غالبًا على الصدقات ومساعدة الفقراء، كما كانوا يهتمون بالعلم والكتب، فتوافد العلماء وطلبة العلم على بيوتهم واستفادوا من مكتباتها، وإن كان اهتمامهم محدودًا بالعلوم النظرية دون الانفتاح على النهضة العلمية الأوروبية.
5 _ تجارة مصر وشواطئ البحر الأبيض، وتأثرها بالاستكشافات البرتقالية في أفريقيا
كانت ثروة سلاطين المماليك البحرية والبرجية عظيمة، ناتجة عن موارد متعددة، أهمها الضرائب على التجارة الهندية العابرة إلى أوروبا، التي كانت تمرُّ عبر البحر المتوسط إلى إسكندرية والبندقية، وقد أدَّى مرور التجارة عبر أراضي المماليك إلى فرض مكوس مرتفعة على البضائع، بما يوازي سدس قيمتها عند الدخول وسدس آخر عند الخروج، فضلًا عما يُدفع من هدايا ورشاوى. مثلًا، إذا بلغت قيمة البضاعة الهندية 10000 جنيه عند شرائها، فقد تدفع مكوسًا تصل إلى 8000 جنيه خلال انتقالها، ما يعكس ثراء المماليك وتمكينهم من بناء قصور ومبانٍ شاهقة.
احتكار تجارة الهند عبر مصر والشام أدى إلى ثروة هائلة لتجار البندقية، ما دفع الدول الأوروبية للبحث عن طرق بحرية جديدة إلى الهند. والبرتقال، سكان غرب شبه جزيرة الأندلس، كانوا أول من اهتم بذلك، فأسس الأمير هنري “الملاح” مدرسة بحرية ومراصد في سجر لتعليم الملاحة وتطوير السفن، مستخدمًا البوصلة وآلة الأسطرلاب لتعقب الشواطئ الأفريقية الغربية. وتوالى إرسال بعثات بحرية حتى وصلوا بجنوب أفريقيا إلى رأس الزوابع وخليج الجوا، ثم أعادوا التركيز على طرق الهند عبر شرق أفريقيا. بعد ذلك، أبحر خرستوف كولومبوس غربًا، ظنًا منه أنه يصل للهند، فالتقى بجزر الهند الغربية، وأدَّى اكتشافه إلى توقف الاستكشاف البرتقالي مؤقتًا، ثم استؤنفت الرحلات بعد ذلك بقيادة فاسكو دي جاما الذي وصل إلى الهند بعد عبور رأس الزوابع وتلقى المساعدة من دليل هندي، وأبرم معاهدة تجارية مع ملك قليقوت، ما فتحت الطريق لتغيير جذري في التجارة العالمية، حيث انتقلت التجارة من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي حول أفريقيا، مؤثرًا على ثروة مصر والبندقية والمماليك. وحاول السلطان الغوري بمساعدة البنادقة مواجهة البرتقال، فأنشأ أسطولًا للبحر الأحمر والهندي، لكنه هزم في معارك بحرية حاسمة، ولم تتمكن مصر بعد الانضمام للدولة العثمانية من استعادة موقعها في التجارة الهندية، وأسهمت غفلة العثمانيين عن دعم البنادقة في تراجع نفوذهم التجاري.
6 _أشهر الولاة وأهم الحوادث
أول الولاة العثمانيين كان خير بك، تولى بعد فتح مصر والشام، وقرب منه اليهود والنصارى، لكنه لم ينل محبة عامة المسلمين، وعُرف بمساعدته للفقراء وإطلاق السجناء قبل وفاته. خلفه مصطفى باشا، زوج أخت السلطان سليمان القانوني، وهو أول من لقب بـ”باشا” ولم يعرف العربية، ثم ظهر أحمد باشا الذي حاول الاستقلال بسلطة مصر، فقُبض عليه وأُرسل رأسه للقسطنطينية، وتميز القرن الأول والثاني بعد الفتح بسلسلة ولاة لم يشهد التاريخ فيها أحداثًا كبيرة، منهم من أنشأ مساجد ومدارس، ومنهم من ركز على جمع المال، ومن أبرز هؤلاء الولاة سليمان باشا (931هـ / 1525م)، الذي رتب الضرائب، وعمل على الإصلاحات، وأنشأ أسطولًا للبحر الأحمر لكبح البرتقال، لكنه لم ينجح في مواجهة أساطيلهم، وجاء بعده خُسْرو باشا أكمل الإصلاحات وزاد الضرائب، ثم جاء سنان باشا (975هـ / 1567م) الذي فتح اليمن وشيد المباني العامة، وعاد محبوبا من الناس. تلا سنان باشا مسيح باشا (982-988هـ / 1574-1580م) الذي اشتهر بالعفة والعدل، وشيد المدارس والأوقاف. ومع مرور الزمن، بدأ نفوذ الولاة يضعف أمام قوة الجنود، ومن أمثلة ذلك أويس باشا (995-999هـ / 1587-1591م) الذي اضطر للرضوخ لمطالب الجنود. ونجح قرة مصطفى باشا (1032هـ / 1622م)، في ضبط الأسواق ومراقبة الشكاوى، لكنه عزل لاحقًا وعاد بعد تدخل السلطان، وشهدت هذه الفترة أوبئة متعددة وطواعين ومجاعات، أبرزها طاعون 1012هـ (1603م) و1028هـ (1619م) و1030هـ (1621م) و1052هـ (1642م)، ما أدَّى لخسائر بشرية ومادية هائلة. ومع هذه الظروف، سيطر الجنود على السلطة، وأصبحوا هم الناهين للولاة، واحتكروا حماية التجار والمزارعين والملاحين، وهو ما أدَّى إلى انحدار النفوذ العثماني تدريجيًا، وسيطرة البيكوات المماليك على معظم البلاد.
6 _ 1 _ عودة النفوذ إلى المماليك البيكوات
أدَّى تنقل الولاة العثمانيين المتكرر إلى ضعف نفوذهم في مصر، ما أتاح للمماليك الراسخة قدمهم استرجاع جزء كبير من قوتهم السابقة، وساعد طول أمد النزاع بين الولاة والجند على نمو هذه القوة، إذ انشغلت الطائفتان بمشاحناتهما عن الأمور العامة. ولعب اختيار المماليك زعيمًا من بينهم، المسمى حينها «شيخ البلد»، دورًا رئيسًا في توطيد سلطتهم، إذ اعتمدوا على نظام تدريب المماليك الأحداث ليصبحوا لاحقًا أنصارًا مخلصين للبيكوات، واستطاعوا من خلال هذه القوة، التأثير على الولاة وعزل من أرادوا، بل طمعوا في التخلص من السيادة العثمانية، خصوصًا مع انشغال الدولة بحروبها مع النمسا وروسيا، وقد حاول بعض الولاة تفريق المماليك عبر الدسائس بين أحزابهم، وكانت أعظم هذه الأحزاب «القاسمية» و«الفقارية»، فتفاقمت العداوة بينهما، حتى اندلعت حرب دامت ثمانين يومًا في سنة 1119هـ/ 1707م. انتهت الفتنة بمقتل شيخ البلد قاسم بك إيواظ وتولي ابنه إسماعيل بك توحيد المماليك، لكن الوالي دس المؤامرات ليقتل إسماعيل بك، وجرى تعيين جركس بك مكانه. واستمر التنافس على السلطة بين المماليك، حتى برز عثمان بك، الذي امتاز بالقوة والشجاعة، فاستقر حكمه وذاع صيته بين الناس، إلا أنه اضطر للفرار بعد صراع مع حزبين من المماليك «الكردغلية» و«الجلفية» اللذين تناوبا على السلطة، ولم تهدأ البلاد، وظل التنازع سيد الموقف حتى تولَّى علي بك الكبير زمام الأمور، فاستطاع بتدريب المماليك وكسب البيكوات تعزيز سلطته، وأعلن استقلال مصر عن الدولة العثمانية سنة 1183هـ/ 1769م، مستغلًا انشغال الدولة بحربها مع روسيا. وسعى علي بك لتوسيع نفوذه خارج مصر، فاستولى على جدة وأجزاء من الجزيرة العربية، كما حاول فتح الشام، لكنه اصطدم بخيانة من حليفه أبو الذهب، الذي تمكن من استعادة السيطرة على البلاد بالاستعانة بالباب العالي، فيما انتهى علي بك بالقبض عليه ومماته بالقاهرة، بعد ذلك تولى زمام الأمور «إبراهيم بك» و«مراد بك» بالتناوب، واستمر نفوذهم في البلاد إلى غزو الفرنسيين سنة 1213هـ/ 1798م، مع فترات عودة للنفوذ العثماني بين 1786 و1790م، إذ أرسلت الدولة حملة لطرد الفتن واستعادة السيطرة، لكنها لم توقف نهج المماليك في الحكم والابتزاز، ما أسهم لاحقًا في لفت نظر الدول الأوروبية إلى مصر، وكان ذلك من العوامل التي مهّدت للغزو الفرنسي.
الباب الثاني: تاريخ مصر من الحملة الفرنسية إلى انتهاء عهد محمد علي
الفصل الأول: الحملة الفرنسية على مصر (1212 _ 1216هـ/ 1798 _ 1801م)
تُعدُّ الحملة الفرنسية على مصر بداية مرحلة جديدة في تاريخها الحديث، فبعد نحو ثلاثة قرون من الحكم العثماني الذي شارك المماليك في إدارته، عانت البلاد خلالها من الظلم وسوء الإدارة وتراجع التجارة والعزلة عن أوروبا، جاء الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت ليكسروا هذه العزلة، فبرز نابليون بوصفه قائدًا عسكريًّا عظيمًا في أواخر القرن الثامن عشر، وتمكن من بسط نفوذ فرنسا في أوروبا، ثم اتجهت أنظاره إلى مصر بوصفها مفتاح الشرق وممرًا أساسيًا إلى الهند التي كانت هدفًا استراتيجيًا لضرب النفوذ البريطاني. ولم يكن قرار غزو مصر وليد اللحظة، فقد سبق أن طرح المفكرون الفرنسيون هذه الفكرة من قبل، لكن نابليون هو من نفذها بعد دراسة عميقة واستشارة العلماء، فأراد أن يجعل من مصر قاعدة لفرنسا في الشرق، ومصدرًا غنيًا بالخيرات، وقد اصطحب معه نخبة من العلماء والفنيين ومطبعة عربية، حرصًا على الجمع بين القوة العسكرية والمعرفة العلمية، وفي مايو 1798م تحرك الأسطول الفرنسي من طولون متجهًا إلى مصر، وبعد أن استولى على مالطة واصل طريقه إلى الإسكندرية، وحاول الإنجليز بقيادة نلسن اعتراضه، لكنهم لم يدركوا وجهته إلا بعد فوات الأوان.
وصل الفرنسيون إلى شواطئ الإسكندرية في يوليو 1798م، وتمكنوا سريعًا من اقتحام المدينة رغم مقاومة حاكمها محمد كريم والأهالي، الذين أبدوا شجاعة، لكنهم لم يملكوا العدة العسكرية لمواجهة الجيوش الحديثة، وأراد نابليون منذ البداية أن يكسب ثقة المصريين، فوجَّه إليهم منشورًا حاول فيه استمالتهم بالحديث عن احترام الإسلام والقرآن، وادَّعى أنَّه جاء لتخليصهم من ظلم المماليك، غير أن أفعاله من مصادرة السلاح وفرض الشارات الفرنسية ليحملوها على صدورهم، قلَّلت من مصداقية وعوده. وبعد استقرار نابليون في الإسكندرية بدأ زحفه إلى القاهرة عبر دمنهور والرحمانية، حيث واجه قوات مراد بك المملوكي، ثم التقى الجيشان في شبراخيت حيث هُزِم المماليك، ليتقهقروا إلى القاهرة، ولم تكد تمرُّ أيام حتى وقعت معركة الأهرام الشهيرة عند إمبابة في يوليو 1798م، وقد اعتمد نابليون على تكتيكاته العسكرية الحديثة المتمثلة في تشكيل المربعات المدعمة بالمدافع، فكانت الغلبة له في معركة استغرقت أقل من ساعة، بينما انسحب مراد بك إلى الصعيد وفر إبراهيم بك إلى الشام، وانفتح الطريق أمام الفرنسيين لدخول القاهرة. دخل نابليون العاصمة بعد أن هجرها كثير من أهلها مع المماليك، وأعلن أنه جاء صديقًا للشعب والسلطان العثماني، وأنشأ ديوانًا يضم العلماء والمشايخ والأعيان لاستشارتهم في شؤون الحكم، وشرع في تنفيذ إصلاحات إدارية وصحية وأمنية على النمط الأوروبي، مثل تنظيم النظافة والإضاءة وتسجيل المواليد والوفيات، غير أن هذه الإجراءات عُدّت تدخلًا في خصوصيات الناس وقيودًا على حريتهم، فأثارت سخطهم. كما أن مصادرة أملاك المماليك والتضييق على نسائهم، وهدم بعض المساجد والتحصينات، زاد من استياء الأهالي وعلمائهم. وبينما كان نابليون يعمل على تثبيت سلطته في القاهرة، تلقى نبأ الكارثة البحرية التي لحقت بأسطوله في خليج “بوقير”، حيث ألحق نلسن بالفرنسيين هزيمة ساحقة قضت على معظم سفنهم وقطعت صلتهم بفرنسا، ورغم صلابة نابليون النفسية، كان لهذا الحدث أثر بالغ على معنويات الجيش والمصريين على السواء، ومع استمرار الضرائب الباهظة والتجاوزات الفرنسية، اندلعت ثورة القاهرة الكبرى في أكتوبر 1798م التي أظهر الأهالي فيها شجاعة نادرة، فقتلوا عددًا من الجنود الفرنسيين، وأقاموا المتاريس في الأزقة، لكن المدافع الحديثة رجحت كفة الفرنسيين، فقمعت الثورة بعنف، وراح ضحيتها آلاف من الأبرياء. وبعد أن أخمد نابليون ثورة القاهرة الأولى بدهائه العسكري حين نصب المدافع على التلال المشرفة وأمطر حي الأزهر بالقذائف، دخل الفرنسيون المدينة وارتكبوا ما أثار حفيظة المصريين، إذ دنّسوا الجامع الأزهر، جعلوه إسطبلًا لخيولهم، وحطموا قناديله، ومع استياء الناس وتوسّلات المشايخ، قَبِلَ نابليون مضطرًا بإخلاء الجامع بعد تهديد وتحذير، ثم قلّل من دور المشايخ في الديوان، مكتفيًا بجعلهم وسطاء في نشر منشوراته الداعية إلى السكينة والخضوع. واتَّجه نابليون بعد استقرار الأوضاع الداخلية إلى تحصين مصر تحسبًا لهجوم عثماني، وكان العثمانيون قد عقدوا حلفًا مع إنجلترا وروسيا لاستعادة البلاد، وخططوا لغزو مزدوج من الشام ورودس، إلا أنَّ سوء التنسيق وعدم وصول الجيشين بوقت واحد إلى الوجهة المحددة مكّن نابليون من مواجهة كل جيش على حدة، فسار إلى الشام، فاستولى على العريش وغزة، ثم يافا التي ارتكب فيها مجزرة رهيبة بقتل الأسرى جميعًا، في وصمة لا تغتفر لتاريخه، وعندما حاصر عكا اصطدم بحسن دفاع أحمد باشا الجزَّار وبمساندة الأسطول الإنجليزي بقيادة سدني سمث، فعجز عن اقتحامها واضطر إلى التراجع بعد حصار دام خمسين يومًا، وعاد إلى مصر ليقابل نزول قوات عثمانية في بوقير، فانتصر عليها، لكن فشل مشروعه في الشرق وضياع أسطوله وانقطاعه عن فرنسا، فضلًا عن تجدد الحرب في أوروبا وخسارة الفرنسيين لإيطاليا، فدفعه ذلك إلى اتخاذ قرار العودة سرًّا إلى بلاده في أغسطس 1799م، تاركًا قيادة الجيش لكليبر، الذي وجد نفسه مع جيش منهك وخزينة فارغة وسخط عام، فحاول الخروج من المأزق بعقد صلح العريش مع العثمانيين والإنجليز، الذي نصَّ على جلاء الفرنسيين بسلام، لكن إنجلترا رفضت الاتفاق وفرضت شروطًا قاسية، فانقطعت المفاوضات، ثم اصطدم كليبر بالجيش العثماني، فألحق به هزيمة ساحقة في عين شمس، وأعاد نفوذ الفرنسيين إلى القاهرة بعد قمع ثورة جديدة أشعلها الأهالي وبعض المشايخ، وفرض على أهلها غرامة باهظة، غير أن اغتياله على يد سليمان الحلبي في يونيو 1800م أنهى مسيرته، فآلت القيادة إلى الجنرال مينو، الذي اعتنق الإسلام وتزوج مصرية، لكنه كان أضعف كفاءة من سابقيه. وواصل الإنجليز والأتراك الضغط حتى أنزلوا قواتهم في بوقير مطلع 1801م، واشتد القتال عند كانوب حيث قُتِل القائد الإنجليزي أبركرومبي، لكن النصر كان حليفهم. فحوصرت القوات الفرنسية في القاهرة والإسكندرية، واضطرت إلى التسليم تباعًا والجلاء عن مصر في سبتمبر 1801م، بعد ثلاث سنوات تركت فيها البلاد مثقلة بالجراح لكنها أيضًا مفتوحة على آفاق جديدة، إذ كان إلى جانب الاحتلال العسكري للحملة وجه آخر تمثل في البعثة العلمية التي ضمت نخبة من علماء فرنسا، الذين انكبوا على دراسة مصر دراسة شاملة، فمسحوا أرضها ورسموا خرائطها، وحصوا أمراضها وطرق علاجها، درسوا نظام الري وأحوال الزراعة والصناعة والتجارة، وتعمقوا في دراسة آثارها القديمة، وكان اكتشاف حجر رشيد أعظم ما أنجزوه، إذ مهد لفك رموز الكتابة المصرية القديمة، وقد توّجت أعمالهم في المؤلف الضخم “وصف مصر” الذي أضاء أمام أوروبا والعالم صورة شاملة عن البلاد. وهكذا انتهت الحملة الفرنسية التي لم تحقق أهداف نابليون في الشرق ولا أطماع فرنسا في الهند، لكنها أحدثت تحولًا عميقًا في مصر، إذ أيقظت الوعي القومي، ووضعت المصريين لأول مرة في مواجهة مباشرة مع أوروبا الحديثة، وأطلقت شرارة التغيرات التي مهدت لدخول مصر عصرًا جديدًا في مطلع القرن التاسع عشر، وإن كانت هذه الحملة قد وضعت مصر في قلب الصراع الدولي بين فرنسا وبريطانيا، إلا أنَّها فتحت عيون المصريين على عالم جديد من القوة والعلم والتنظيم، وإن كان ثمنها باهظًا من الدماء والدمار، وبرغم أن الفرنسيين لم يلبثوا في مصر سوى ثلاث سنوات، فإن أثر حملتهم ظل عميقًا، إذ شكَّلت بداية لاحتكاك مباشر مع أوروبا الحديثة، وكان لها ما بعدها في رسم ملامح مصر السياسية والاجتماعية في العصر الحديث.
الفصل الثاني: محمد علي باشا
1_ نشأته ونهوضه
وُلِدَ محمد علي باشا سنة (1183هـ/1769م) في بلدة «قَوَلَة» بالبلقان من أسرة ألبانية بسيطة، وتوفي والده في صغره، فتولَّى رعايته أقارب وأصدقاء أبيه حتى شبّ، وتعلم الفروسية واستعمال السيف، زُوِّج من قريبةٍ له ميسورةٍ ساعدته في تجارته بالدخان، حيث ارتبط بتاجر فرنسي يُدعى «ليون»، فاكتسب منه خبرات وعادات أوروبية أثرت في شخصيته، وخدم حاكم قَوَلَة فأظهر براعة في جباية الأموال، ثم اتَّجه إلى التجارة، لكنه لم يحقق أرباحًا كبيرة، فقضى ثلاثين سنة من حياته في مسقط رأسه دون شهرة تُذكر، وقد كانت الدولة العثمانية في زمن شبابه ضعيفةً، مفككة العرى، يسيطر على سلطانها الإنكشارية والوزراء، وتكثر فيها الفتن والقلاقل، ومع هذا ظل المسلمون يجلون السلطان بوصفه خليفة، وفي هذا المناخ تفتحت شخصية محمد علي، الذي لم يتجاوز الثلاثين حين اندلعت الحملة الفرنسية على مصر، فدخل طورًا جديدًا من حياته، إذ شارك في سنة (1213هـ/1799م) مع فرقة ألبانية متطوعة أرسلها حاكم قَوَلَة إلى مصر لمحاربة الفرنسيين، ورافقها بصفته وكيلًا عليها، وشهد هزيمة الأسطول العثماني أمام الفرنسيين في “بوقير” وكاد يغرق لولا إنقاذه، فعاد إلى موطنه، ثم رجع ثانية إلى مصر مع الحملة العثمانية – الإنجليزية التي طردت الفرنسيين سنة (1801م)، وأبلى بلاءً حسنًا في حصار الرحمانية فارتقى إلى رتبة قائد، ومنذ ذلك الحين استقر في مصر، وبدأ مسيرته نحو الولاية.
1 _ 1 نهوض محمد علي
بعد رحيل الفرنسيين عاد المماليك لمحاولة استعادة السلطة، بينما أراد الباب العالي بسط نفوذه المباشر، فأتاح الصراع بين الفريقين الفرصة لصعود محمد علي، ففي البداية حاول الوالي العثماني خسرو باشا القضاء على المماليك، لكن جيشه انهزم، وحاول الانتقام من محمد علي متهمًا إياه بالتقصير، ومنذ ذلك الوقت بدأت العداوة بينهما، ثم ثارت الجنود لعدم دفع رواتبهم، فهرب خسرو إلى دمياط، وتوَّلى طاهر باشا قيادة الحكم في القاهرة، لكنه قُتل سريعًا، فبرز محمد علي قائدًا للألبانيين ومحبوبًا من العلماء والعامة، وتحالف مع عثمان بك البرديسي ضد المماليك، وتمكنا من طرد خسرو، ثم تولى علي باشا الجزائري ولاية مصر، لكنه قُتل بتحريض من البرديسي. وفي الوقت ذاته عاد محمد بك الألفي من إنجلترا يسعى لإعادة قوة المماليك بدعم بريطاني، لكن محمد علي والبرديسي اتحدا ضده، ففشلت مساعيه وفرّ إلى الشام.
واتسمت سياسة محمد علي بالدهاء؛ فقد جعل البرديسي واجهة في مواجهة السلطان والمماليك، بينما حافظ هو على علاقته بالعلماء والعامة، وعندما أثقلت الضرائب التي فرضها البرديسي كاهل الناس، انقلب محمد علي عليه، وحاصره حتى فرّ مع إبراهيم بك الكبير، وبذلك انفرد محمد علي بالسلطة في القاهرة سنة (1218هـ/1804م)، ومع ذلك كان مركزه لا يزال غير مستقر؛ فالمماليك قد يتحدون ضده، وجيشه محدود العدد، كما أن الباب العالي قد يُعدُّه خارجيًا، فحاول استرضاء الدولة بإطلاق سراح خسرو، ثم قبل بقدوم والي جديد هو أحمد خورشيد باشا، إلا أنَّ خورشيد أظهر ضعفًا، وفشلت سياساته في ضبط الجنود، واتخذ محمد علي موقف الحامي للأهالي، فكسب ثقتهم.
وعندما عاث الجنود «الدلاة» فسادًا في البلاد، لجأ الأهالي والعلماء إلى محمد علي ليحميهم، فحاصر خورشيد في القلعة، واستطاع بدعم العلماء وقيادة عمر مكرم والشيخ الشرقاوي أن يُنصَّب واليًا على مصر في (صفر 1220هـ/مايو 1805م)، واعترف الباب العالي بتوليه المنصب رسميًا بعد إدراكه أنَّ الأهالي قد اختاروه بإجماع، وهكذا بدأ حكمه لمصر.
1 _ 2 توطيد سلطة محمد علي في مصر
بعد تولي محمد علي الحكم سنة 1805م كانت سلطته هشَّةً، إذ لم يرضَ الباب العالي باختياره واليًا واعترف به مرغمًا بسبب إجماع الأهالي عليه، فكان يتربص به، كما أن المماليك الذين أصابتهم نكبات متلاحقة اتَّحدوا ضده، وازدادت الأخطار بقدوم حملة إنجليزية سنة 1807م هدفت إلى إعادة المماليك للحكم، لكن الحظ ساعد محمد علي؛ إذ نجح في استرضاء السلطان، والتغلب على المماليك، وهزيمة الإنجليز بمعونة الأهالي وحامية رشيد، فكانت أولى خطواته مكيدة لزعماء المماليك في القاهرة (1805م) حيث قُتِل معظمهم، ولتأمين المال، فرض على أقباط القاهرة دفع ما اختلسوه من الأموال، فاستطاع دفع رواتب الجنود وإرضاء أمير البحر التركي، ومع عودة الأسطول العثماني إلى إسطنبول بعد اندلاع الحرب مع روسيا، ثُبّت محمد علي واليًا رسميًا على مصر سنة 1806م، وضعف المماليك بوفاة زعمائهم البرديسي والألفي (1806-1807م)، وتفرق أنصارهم، وعندما غزت إنجلترا مصر سنة 1807م، احتلت الإسكندرية لكنها انهزمت عند رشيد والحماد، فانسحبت تمامًا، وقد رفع هذا النصر مكانة محمد علي لدى السلطان الذي منحه الخلعة وسيف الشرف وأعاد إليه ابنه إبراهيم، فازداد مركزه ثباتًا.
1 _ 3 القضاء على المماليك
كُلِّف محمد علي من الباب العالي بإخضاع الوهابيين، لكنه رأى ضرورة القضاء أولًا على خطر المماليك الذين كانوا يتربصون به، وبعد محاولات صلح فاشلة، ووقائع متفرقة، قرر التخلص منهم نهائيًا، وفي مذبحة القلعة (مارس 1811م) دعا زعماء المماليك لاحتفال رسمي، ثم أغلق عليهم باب العزب، ففتك جنوده بهم حتى قُتل نحو خمسمائة، وأُتبعت العملية بقتل المماليك في الأقاليم حتى زاد عدد ضحاياهم على الألف، وهكذا انتهى وجود هذه الطائفة التي حكمت مصر قرونًا وأرهقت أهلها.
2_ الحروب الوهابية في بلاد العرب
الوهابية حركة إصلاحية ظهرت بنجد مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب (1696-1787م)، دعت إلى التوحيد ونبذ البدع وزيارة القبور والتوسل بالأولياء، وشددت على محاربة الفسق والمسكرات والترف، وتحالف ابن عبدالوهاب مع محمد بن سعود فامتد نفوذهم في نجد، ثم واصل ابنه عبدالعزيز وابنه سعود الثاني نشر الدعوة، حتى سيطروا على معظم جزيرة العرب، واحتلوا مكة والمدينة، وهاجموا كربلاء سنة 1801م، وبلغت دولتهم أوجها في عهد سعود الثاني الذي شدد في الضرائب ومنع كثيرًا من المظاهر الاجتماعية، مما دفع الباب العالي إلى تكليف محمد علي بالقضاء عليهم.
2 _1 حملة محمد علي على الوهابيين
أرسل محمد علي ابنه طوسون على رأس جيش قوامه 8000 من الألبانيين عبر البحر الأحمر، فنزل ينبع ثم المدينة، لكنه تكبد هزيمة كبيرة عند «الجديدة». ومع وصول الإمدادات تمكن من دخول المدينة ومكة، لكن الوهابيين ردوا بهزيمة أخرى عند «طُرَبة»، فانتقل محمد علي بنفسه إلى الحجاز سنة 1813م، وأدَّى الحج، ثم قبض على الشريف غالب وأرسله إلى إسطنبول، وبعد وفاة سعود الثاني سنة 1814م خلفه ابنه عبدالله الذي افتقر إلى حنكة أبيه، فحاول الالتزام بوصية والده بالتحصن في المواقع الصعبة، لكنه خالفها فانهزم أمام الجيش المصري بقيادة محمد علي، واضطر محمد علي إلى العودة لمصر بسبب اضطرابات داخلية، وتولى ابنه إبراهيم باشا القيادة، فوصل إلى الحجاز سنة 1816م، وأثبت مهارة عسكرية فائقة، فهزم القبائل تدريجيًا وحاصر الدرعية عاصمة الوهابيين سنة 1818م، وبعد مقاومة طويلة استسلم عبدالله بن سعود، فأرسله محمد علي إلى الباب العالي حيث أُعدم، وخُرّبت الدرعية تمامًا، وبذلك انتهت دولة الوهابيين الأولى، واستعاد العثمانيون بفضل محمد علي السيطرة على الحجاز والحرمين، مما عزز مكانة الباشا في مصر ووطد حكمه.
3 _ فتح السودان
اتَّجه محمد علي _ بعد انتصاره على الوهابيين _ إلى فتح السودان لأسباب سياسية ومادية، فمن الناحية السياسية أراد التخلص من بقايا المماليك الذين لجؤوا إلى دنقلة، واستبدال جنوده الألبانيين – الذين تمردوا عليه – بجنود من السودانيين المعروفين بالشجاعة. ومن الناحية المادية، كان يطمح إلى إنعاش التجارة عبر القوافل بين مصر والسودان، والاستفادة من الضرائب، والتنقيب عن الذهب، فضلًا عن ضمان السيطرة على منابع النيل لتأمين الري في مصر. وبدأ بفتح واحة سيوة سنة 1820م، ثم أرسل جيشًا بقيادة ابنه إسماعيل باشا، مكوّنًا من المشاة والفرسان والمدفعية، فانطلق من أسوان متجهًا إلى دنقلة حيث تفرّق المماليك، واستسلم بعضهم، وتوالت انتصاراته، فدخل بربر، ثم شندي، ثم سنار التي سلّمها سلطانها بعد نزاع داخلي، واعترف بسيادة محمد علي. وأرسل إسماعيل دفعات من العبيد إلى أسوان لتدريبهم على النظم العسكرية الحديثة، لكن الجيش عانى من الأمراض وقلة العدد، فطلب المدد من أبيه، فجاءه أخوه إبراهيم باشا، واتفق القائدان على تقسيم العمل: إسماعيل يتَّجه نحو النيل الأزرق، وإبراهيم نحو النيل الأبيض. فتقدم إسماعيل حتى «تومات»، بينما عجز إبراهيم بسبب المرض فعاد إلى مصر، وفي 1822م، أرسل محمد علي جيشًا ثالثًا بقيادة محمد بك الدفتردار إلى كردفان فاستولى على الأبيض، وانتقم لاحقًا من الملك نمر الذي دبّر مكيدة أحرقت إسماعيل باشا ومن معه في شندي، وبعدها أحرق الجيش المدينة، وشيَّد الخرطوم سنة 1823م. لم تحقق الحملة جميع أهدافها؛ فلم يُعثر على ذهب مجدٍ، وتعثرت التجارة بسبب الضرائب الباهظة، كما فشل مشروع التجنيد من السودانيين لعدم ملاءمة مناخ مصر لهم، وزاد الاتجار بالرقيق بعد الفتح حتى تدخلت بريطانيا وفرنسا، واضطر محمد علي إلى إعلان منعه سنة 1838م، لكن الظاهرة استمرت حتى الاحتلال البريطاني.
4 _ أعمال محمد علي باشا في الديار المصرية
مقدمة
ورث محمد علي مصر في حالة فوضى بعد ظلم المماليك والعثمانيين، وعلم أن الإصلاح مهمة صعبة تتطلب صبرًا طويلًا، ومع أن هدفه الأول كان تأسيس ملك قوي يجمع المال والجنود، إلا أنَّه سرعان ما أيقن أن نهضة ملكه لا تكون إلا بإصلاح مصر، فأدخل النظم الحديثة، وأسس المدارس والمعامل، وشجع العلوم، وأرسل البعثات إلى أوروبا، محاربًا الجهل والخرافة، ورغم أخطائه أحيانًا إلا أنَّ إصلاحاته غيّرت وجه مصر ووضعته في مصاف كبار المصلحين.
4 _ 1 الحكومة في عهد محمد علي
بدأ حكمه دون تغيير كبير في النظام القديم، لكنه سنة 1826م أدخل تعديلات واسعة مستوحاة من قوانين نابليون، فأنشأ «الديوان الخديوي» للفصل في القضايا، ومجلس المشاورة الملكي للنظر في شؤون الدولة، ومجلسًا وزاريًا، وأسس أيضًا دواوين متخصصة مثل «ديوان التجارة» و«مجلس المشاورة العسكرية»، وقسَّم القطر إداريًا إلى سبع مديريات و64 مركزًا، ثم إلى نواحٍ وقرى يديرها العمد والمشايخ، ومع هذه المؤسسات ظل محمد علي منفردًا بالسلطة، يفاوض السفراء، ويدير المالية والمشروعات بنفسه.
4 _ 2 التقدم المادي
الزراعة:
عدَّها أساس ثروة البلاد، فاستولى على الأراضي الزراعية تدريجيًا: أملاك المماليك، ثم الأوقاف، ثم ملكيات الأفراد، حتى أصبحت معظم الأراضي تحت يده، بينما صار الفلاحون مجرد مستأجرين مرتبطين بالأرض مقابل الضرائب، وأمر بمسح الأراضي وتنظيم الضرائب، وأصبح العمد مسؤولين أمام المديرين عن جبايتها، مما جعل الفلاحين تحت رحمتهم. واحتكر المحاصيل التي كان يحدد أنواعها بنفسه، ثم تُجمع وتُقيَّم وتباع عبر الحكومة، وبهذا سيطر على الزراعة والتجارة معًا، وأدخل محاصيل جديدة أحدثت ثورة في الاقتصاد، أهمها القطن طويل التيلة الذي أدخله الفرنسي «جوميل» سنة 1820م، فكان بداية عصر جديد لمصر، كما شجع زراعة القنب والخشخاش والغابات، وحسّن الجنائن، ورغم هذه الإصلاحات إلا أنَّ الفلاحين ظلوا يعانون من أثمان بخسة لمحاصيلهم، وموازين مغشوشة، وإجبارهم على مقايضة إنتاجهم بمنتجات معامل الحكومة، ومع ذلك وفّرت هذه السياسة الموارد التي مكّنته من بناء جيش وأسطول وخوض حروب عدة.
الصناعة
أدرك محمد علي أهمية الصناعة بوصفها قاعدة للثروة والقوة العسكرية، فسعى إلى إدخال الصناعات الأوروبية وتشجيع الصناعات الوطنية، رغم الصعوبات المتمثلة في نقص المواد الخام كالفحم والحديد والخبرة المحلية، فأنشأ معامل متعددة في أنحاء البلاد، من أهمها معامل الغزل والنسيج للقطن والحرير والكتان والصوف، وكان أبرزها معمل بولاق الذي توَّلى إدارته الفرنسي جوميل، كما أنشأ معامل للجوخ أدارها فرنسيون ثم مصريون درسوا في فرنسا، ومعامل للصباغة والطرابيش بفوة، ومصانع للسكر والزيوت، واهتم أيضًا بتوفير المواد الخام لهذه الصناعات؛ فشجع زراعة القطن والكتان والقنب، وحاول تحسين سلالات الأغنام وتربية دودة القز لإنتاج الحرير، ورغم نجاحات مبدئية إلا أن معظم المصانع تلاشت في حياته أو عقب وفاته بسبب التكاليف الكبيرة، وانعدام الاستمرارية، واعتمادها على دعم مالي مباشر منه، وقد أغلق معظم ما بقي متها نهائيًا في عهد عباس الأول.
4 _3 الأشغال العامة
قام محمد علي بمشروعات كبرى غيرت وجه مصر، أهمها:
أ _ ترعة المحمودية: ربطت النيل بالإسكندرية وحولت مجرى التجارة إليها، فعمرت الأراضي وزادت ثروة المدينة، وكلفت نحو 300 ألف جنية.
ب _ ميناء الإسكندرية: أصلحه موجيل بك، وأقيمت فيه دار صناعة بحرية وأحواض لبناء السفن، مما جعله مركزًا تجاريًا عالميًا، وازداد إقبال التجار على شراء المحاصيل المصرية.
ت _ القناطر الخيرية: مشروع ضخم لتنظيم الري في الوجه البحري، خطرت فكرته مع انتشار زراعة القطن، وقد مرَّ المشروع بعدة خطط بين لينان باشا وموجيل بك، وتأخر إنجازه بسبب الأوبئة والبطء والملل، واستؤنف العمل فيه بعد وفاة محمد علي، واكتمل سنة 1861م، لكن لم يحقق كامل أهدافه إلا بعد إصلاحات لاحقة.
كما فكر في مشروعات أخرى مثل سكة حديدية بين القاهرة والسويس، وحفر قناة السويس، لكنه لم يتحمس لها خوفًا من جعل مصر طريقًا دوليًا.
4 _ 4 نهضة التعليم
عانت مصر قبل محمد علي من الجهل، فأولى التعليم عناية كبيرة رغم مقاومة الأهالي، فأسس مدارس ابتدائية وتجهيزية وخاصة، أبرزها مدرسة الطب بأبي زعبل سنة 1827م بجهود كلوت بك، ومدرسة الطب البيطري، والهندسة، والموسيقى، والألسن برئاسة رفاعة الطهطاوي، ومدارس للفنون والزراعة. وأرسل بعثات عديدة إلى أوروبا خاصة فرنسا، منذ عام 1826م، بلغ عدد أفرادها أكثر من 120 طالبًا، منهم شخصيات بارزة مثل علي مبارك باشا وشريف باشا، وقد أسهم هؤلاء في نقل العلوم الحديثة، والترجمة عبر مطبعة بولاق التي أنشأها محمد علي. ورغم أن التعليم لم يُبنَ على أسس متينة لحداثته وسرعة تطبيقه، إلَّا أنَّه أحدث نقلة كبرى في فكر المصريين، ومهّد لنشوء جيل متعلم ساعد على التحديث، كما شجع العلماء الأوروبيين لدراسة الآثار المصرية مثل شامبليون وليبسيوس، مما ساعد على كشف أسرار الحضارة القديمة.
4 _ 5 الجيش
رأى محمد علي أن قوته لا تكتمل إلا بجيش نظامي حديث، في البداية اعتمد على الألبانيين، لكن تمردهم جعله يستبدلهم تدريجيًا، فبدأ بتنظيم الجيش على الطريقة الأوروبية سنة 1815م، وواجه معارضة عنيفة، لكنه واصل خطته بحذر، واستعان بضباط فرنسيين مثل سليمان باشا الفرنساوي الذي نظم الجيش بأسوان، واعتمد في البداية على أسرى السودان ثم على الفلاحين رغم مقاومتهم الشديدة للتجنيد، ومع المثابرة نجح في بناء جيش قوي، وأنشأ مدارس للمشاة والفرسان والمدفعية، ومصانع للأسلحة والذخائر في قلعة الجبل، وتدرج عدد الجيش حتى بلغ في أواخر عهده ما يقارب 276 ألف جندي بمختلف الفروع. وكان هذا الجيش منظمًا ومسلحًا على النمط الأوروبي، وأصبح عماد قوة محمد علي ووسيلته لتثبيت سلطانه ومجابهة خصومه.
4 _ 6 البحرية
أنشأ محمد علي أول أسطول بحري في أثناء حربه مع الوهابيين، وكان الهدف نقل الجنود من السواحل المصرية إلى الجزيرة العربية، ثم أصبح وسيلة لحماية التجارة من القرصنة، لاسيما في البحر الأبيض المتوسط ضد لصوص اليونان، إذ قبل حرب اليونان اشترى سفنًا من البندقية ومرسيليا وصنع أخرى هناك، لكن معظمها تحطم في واقعة نوارين، وبعد هذه النكبة، أدرك أهمية البحرية، فأسس عام 1829م دار صناعة بحرية في الإسكندرية تضم مصانع لفتل الحبال وصناعة الحديد والصواري والقلوع، إلى جانب مدرسة بحرية لتدريب الشباب المصريين على العلوم البحرية، وأشرف على ذلك المهندس “دي سريزي” ومدير المدرسة “بيسون” الذي أصبح أمير البحر، فارتقت العمارة البحرية وبلغت في 1832م ثلاثين قطعة حربية تحمل 1300 مدفع، ويعمل عليها 12000 جندي. كما أرسل تلاميذ للتدريب العملي على السفن الإنجليزية، ولحماية السواحل، أنشأ حصونًا واستحكامات مزودة بالمدافع والعساكر في المواقع المهمة بمصر، مما ضاعف قوة البلاد ومكانتها.
4 _ 7 ميزانية الحكومة
اتسع نطاق مشروعات محمد علي في الزراعة والصناعة والتعليم والجيش والبحرية، ما استلزم موارد مالية ضخمة إلَّا أنَّ مصر لم تعرف الميزانية السنوية المنظمة إلا بعد عهده، وتعتمد تقديرات تلك المرحلة على شهادات الأوروبيين، وفي البداية كان الدخل صغيرًا، إذ قُدّر عام 1821م بـ 12000 جنية تقريبًا والمصروف أقلّ من ذلك، لكن بحلول عام 1833م ارتفع الإيراد إلى 2,5 مليون جنية والمصروف إلى مليوني جنية. جاءت الإيرادات من ضريبة الأراضي (1,125,000 جنية)، والتجارة (450 ألفًا)، والمكوس على الحبوب (180 ألفًا)، والجمارك (112 ألفًا)، وضريبة الرؤوس (350 ألفًا)، وبعد سنوات قليلة، في 1838م، بلغ الدخل 4,5 مليون جنية والمصروف 3,5 مليون، ما يدلُّ على تضاعف موارد الدولة مع تضخم مشروعاتها.
5 _ حرب اليونان
بعد هزيمة نابليون، أُنشئ الحلف المقدس بين روسيا وبروسيا والنمسا لحماية العروش الملكية في أوروبا، لكن مبادئ الثورة الفرنسية سرعان ما انتشرت وأشعلت ثورات في إيطاليا وإسبانيا واليونان، وكانت الثورة اليونانية ذات طابع ديني قومي ضد الدولة العثمانية، ورغم تعاطف شعوب إنجلترا وفرنسا معها، إلَّا أنَّ الحكومات لم تدعهما رسميًا خشية تقوية روسيا، وكانت الدولة العثمانية حينها ضعيفة وممزقة، لاسيما بعد ثورة الإنكشارية والقضاء عليهم عام 1826م، ولما استعصى إخماد الثورة، طلب السلطان محمود الثاني من محمد علي التدخل، فعُيّن واليًا على كريت ثم المورة، وأرسل ابنه إبراهيم باشا على رأس جيش قوامه 17 ألفًا عام 1824م، فتمكن إبراهيم من السيطرة على معظم بلاد المورة، وحقق انتصارات بارزة أبرزها الاستيلاء على “تريبولتزا” و”مسولونجي” بعد حصار شديد خسر فيه المصريون 6 آلاف جندي، لكن شدته في معاملة اليونان، وبيع آلاف الأسرى في مصر، أثارت استياء أوروبا، فاجتمعت إنجلترا وفرنسا وروسيا في مؤتمر لندن عام 1826م وقرروا التدخل، أرسلت الدول الثلاث أساطيلها بقيادة الإنجليزي كدرنجتون إلى خليج نوارين، حيث وقع الاشتباك صدفة في أكتوبر 1827م، وانتهى بتدمير الأسطول المصري _ التركي، ورغم ذلك، ظل إبراهيم مسيطرًا على المورة، لكن ضغوط أوروبا استمرت، فأرسلت فرنسا 15 ألف جندي لإجباره على الانسحاب، بينما هدد كدرنجتون الإسكندرية، فرضخ محمد علي وأمر بانسحاب جيشه عام 1828م بعد ضمان عودة الأسرى المصريين وإطلاق سراح الأسرى اليونان، وأعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية في 1829م وهزمتها، مما أجبر السلطان على توقيع معاهدة أدرنة التي اعترفت باستقلال اليونان الكامل.
6 _ حرب الشام
طالب محمد علي، بعد انتهاء حرب اليونان، الباب العالي بولاية عكاء مكافأة لمساعدته، لكن السلطان رفض، وعندما اندلعت حرب روسيا عام 1829م لم يُلبِّ محمد علي طلب السلطان بإرسال جيش، ورأى أنَّ الفرصة مواتية لتوسيع نفوذه في ظل ضعف الدولة العثمانية، وانشغال القوى الأوروبية باضطراباتها الداخلية، وزاد التوتر مع الباب العالي بسبب عداء خسرو باشا له، ورفض والي عكاء عبدالله الجزَّار إعادة الفلاحين المهاجرين من ظلم محمد علي، فتضررت مصالح محمد علي التجارية، ومع تزايد الخلافات، أعلن محمد علي الحرب خوفًا من عزله، وجهز لذلك حملة برية وبحرية بقيادة إبراهيم باشا، فسيطر على غزة ويافا وحاصر عكاء ستة أشهر حتى سقطت عام 1832م. بعدها تقدم إلى دمشق وحمص وحلب، محققًا انتصارات متتالية على الجيوش العثمانية، أبرزها في حمص وبيلان، وبحلول منتصف 1832م كانت بلاد الشام ومعظم الأناضول تحت سلطته، ثم حقق انتصارًا حاسمًا على الجيش العثماني في معركة قونية، فأصبح مهددًا للعاصمة العثمانية، وخشيت الدول الأوروبية من توسع محمد علي وتدخلت روسيا لصالح السلطان، فأُبرم صلح كوتاهية (1833م) الذي منح محمد علي حكم بلاد الشام وولاية أذنة، مقابل وقف القتال، غير أن السلطان لجأ بعد ذلك إلى التحالف مع روسيا بموجب معاهدة “هنكار إسكله سي”، وهو ما أقلق بقية الدول الأوروبية.
6 _ 1 حكومة محمد علي في بلاد الشام وغزوته الثانية لها
لم يحل اتفاق كوتاهية النزاع؛ إذ ظل محمد علي يُعدُّ أن حكمه للشام مؤقت، وسرعان ما ثار الأهالي بسبب عسف حكمه: الضرائب الباهظة، والتجنيد الإجباري، واحتكار الحاصلات، ونزع السلاح. فاندلعت ثورات في دمشق وحلب ونابلس ولبنان بين 1834م و1836م، وقُمعت بيد إبراهيم باشا ومحالفه الأمير بشير الشهابي بعد معارك طويلة، فأدَّت هذه السياسة إلى عداء واسع ضد محمد علي، وأثقلت مصر بأعباء مالية وعسكرية جسيمة، وفي ظل هذه الاضطرابات كان السلطان محمود الثاني يستعد للانتقام واستعادة الشام، ورغم تردد الدول الأوروبية إلَّا أنَّ الباب العالي قرر الحرب عام 1839م ودفع بجيش ضخم بقيادة حافظ باشا، مدعومًا بضباط ألمان، فالتقى الجيشان في معركة نصيبين (يونيو 1839م) حيث أوقع إبراهيم باشا هزيمة ساحقة بالعثمانيين، ما ترك الدولة بلا جيش تقريبًا، وتزامن ذلك مع وفاة السلطان محمود، فازدادت الأزمة خطورة، وفي خضم الفوضى سلّم الأسطول العثماني نفسه لمحمد علي، مما أثار ذعرًا أوروبيًا، إذ بدا وكأن الدولة العثمانية باتت تحت رحمته، لكن تدخل الدول الأوروبية الكبرى ولاسيما إنجلترا وفرنسا وروسيا حال دون تحقيق محمد علي لاستقلال كامل، وبدأت الضغوط الدولية لإعادة التوازن بينه وبين الباب العالي.
6 _ 2 تدخل دول أوروبا
سعت الدول الكبرى لمنع روسيا من استغلال معاهدة «هنكار إسكله سي»، فاقترح الباب العالي منح محمد علي حكم مصر وراثة، والشام لإبراهيم حتى يخلف والده، فرحبت روسيا بذلك لتتخلص من التزاماتها السابقة، لكن الدول الكبرى رفضت أن يتم الاتفاق دون إشرافها. وتوافق الفرنسيون والإنجليز أول الأمر على حماية الدولة العثمانية من النفوذ الروسي، ثم اختلفوا؛ فوزير خارجية إنجلترا بالمرستون رأى ضرورة فصل محمد علي عن الدولة بصحراء سيناء، بينما رأت فرنسا أن مصالحها تتحقق بدعمه، وعرضت أن تُمنَح أسرته جميع ولاياته وراثةً، فرفض الإنجليز، وبعد مفاوضات، طرح بالمرستون حلًّا يقضي بوراثة مصر لمحمد علي وأولاده مع ولايات في الشام، لكن فرنسا رفضت، إذ كان رئيس وزرائها تييرس يراهن على قوة محمد علي ويخابره سرًّا.
اتجهت روسيا للتفاهم مع إنجلترا، فأبدت استعدادها للتخلي عن امتيازاتها السابقة مقابل إغلاق المضايق في وجه الجميع عدا سفنها عند الحاجة، وهكذا تفاوضت أربع دول (روسيا، بروسيا، النمسا، إنجلترا) مع محمد علي عبر المبعوث الإنجليزي هدجس، لكن الأخير رفض الخضوع معتمدًا على فرنسا، وعندما فشلت المفاوضات، وقعت الدول الأربع «معاهدة لندن» في يوليو 1840م دون فرنسا، ونصَّت على عودة محمد علي لما فتحه من أراضٍ عدا عكا، وعلى تقليص نفوذه، ومنح مصر وراثة له إن خضع سريعًا، وأثارت المعاهدة غضب فرنسا، ودفعت إلى استعدادات عسكرية، لكن سقوط وزارة تييرس أوقف دعمها لمحمد علي، فوجد نفسه وحيدًا في مواجهة التحالف.
6 _ 3 الحملة الأخيرة
مع إعلان الباب العالي خلع محمد علي، اندلعت المواجهات في الشام، وكان جيش إبراهيم باشا لا يزال قويًا، لكن سكان الشام ثاروا عليه بدفع من إنجلترا، فكان ذلك سببًا رئيسًا في انهياره، وبدأت المعارك بقصف الأساطيل المتحالفة لبيروت في سبتمبر 1840م، ثم توالت الهزائم المصرية في صيدا و«قلعة ميدان»، وأخيرًا سقطت عكا سريعًا، مما اضطر محمد علي إلى إصدار أمر لابنه بالانسحاب من الشام، وأظهر الجيش براعة في التقهقر المنظم من دمشق إلى غزة، لكنه تكبد خسائر جسيمة، إذ هلك ثلثا جنوده في الطريق. وأمام هذا الواقع، توجه الأسطول المتحالف إلى الإسكندرية وهدد بقصفها، فقبل محمد علي الخضوع للسلطان مقابل ضمان بقاء حكم مصر وراثة له ولأبنائه، وبعد مفاوضات، صدر فرمان فبراير 1841م الذي أقرَّ وراثة مصر لنسله الذكور ضمن شروط صارمة، منها: تقليص الجيش إلى 18 ألف جندي، ودفع خراج سنوي، والالتزام بالقوانين العثمانية، والحرمان من أي استقلالية سياسية. وفي تقاليد لاحقة عُدلت بعض البنود، فجُعلت الوراثة للأكبر سنًا من أولاده، وخُففت شروط الخراج والرتب العسكرية، وبذلك انتهت أحلام محمد علي التوسعية، وحصر نفوذه في مصر فقط.
7 _ شيخوخة محمد علي وحكم إبراهيم
أصيب محمد علي _ بعد حصره في مصر وتجريده من فتوحاته _ بضعف الشيخوخة واضمحلال قواه، وعانت البلاد من أزمات اقتصادية وكوارث طبيعية كطاعون الماشية والجراد، فانهارت مواردها واشتدت معاناة أهلها، وحاول محمد علي تحسين أوضاعه بتحصين الإسكندرية والشروع في بناء القناطر الخيرية سنة 1847م إلَّا أنَّ ظروفه الصحية والسياسية لم تساعده، وفي هذه الفترة ضعف ابنه إبراهيم باشا أيضًا، فسافر للاستشفاء في أوروبا، ثم عاد ليتولى الحكم رسميًا عام 1848م، لكنه توفي بعد أشهر قليلة متأثرًا بمرضه، وتولَّى حفيده عباس باشا الأول الحكم، بينما عاش محمد علي آخر أيامه منهكًا فاقدًا لقواه العقلية، حتى توفي في الإسكندرية في أغسطس 1849م، ودُفن في مسجده بالقلعة، وهكذا أسدل الستار على حياة مؤسس مصر الحديثة، الذي جمع بين عظمة الطموح وقسوة النهايات.
الفصل الثالث: الطريق البري بين الهند وأوروبا
كانت الضرائب على التجارة بين أوروبا والهند عبر مصر أهم موارد المماليك حتى اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح، الذي حل محل طريق مصر لسهولة النقل وقلَّة نفقاته وخلوه من أخطار البحر المتوسط وقطاع الطرق، وظلت التجارة عبر الرأس حتى أواخر القرن الثامن عشر حين سعت إنجلترا لإحياء طريق مصر لقربه من الهند، وأول من حاول ذلك كان جورج بلدوين، سفير إنجلترا بمصر زمن الثورة الفرنسية، حيث حصل على إذن بالملاحة في البحر الأحمر، لكن الباب العالي ألغاه سريعًا، وبعد ذلك عرض التاجر الإنجليزي برجز المشروع على محمد علي في أثناء حربه مع الوهابيين، فأرسل بعض السفن إلى بمباي، لكن المحاولة لم تنجح، ومع احتكار محمد علي للتجارة، تقوَّى نفوذ الإنجليز، وكان لهم النصيب الأوفر منها. وبرز توماس وجهورن، ضابط الأسطول الإنجليزي، الذي أيقن بعد إصلاحات محمد علي وأمن الطرق وأهمية السفن البخارية، بإحياء الطريق، فقدم اقتراحه لشركة الهند الشرقية عام 1823م لكنها رفضته، ومع ذلك ظل السفير بركر يدعمه حتى اقتنعت الحكومة البريطانية بالمشروع عام 1830م. وساند محمد علي وجهورن بحماس، حتى إن الأخير رفع مذكرة للبرلمان الإنجليزي يوصي بمصر، معترفًا بفضل الوالي، وبعد جهاد عشرين عامًا تحقق النجاح، ففي أكتوبر 1845م وصلت باخرة من بمباي إلى السويس في 19 يومًا، ونقل البريد إلى لندن خلال شهر، وحاولت فرنسا منافسة إنجلترا، فاتخذت مرسيليا مركزًا عامًا للبريد عام 1840م. وسهّل الطريق تأسيس شركة ملاحية في ترعة المحمودية والنيل قبل وفاة محمد علي، فبلغ عدد المسافرين سنويًا نحو 15 ألفًا (1842 _ 1849م). وتوفي وجهورن عام 1850م معترفًا بفضل محمد علي، ونُصب له تمثال بالسويس، وامتاز عن ديلسبس بأنه لم يستنزف أموال مصر ولم يعمل ضدها، وأهدت إنجلترا وسامًا لمحمد علي عام 1840م تقديرًا لدوره في فتح الطريق البري للهند.
الباب الثالث: تاريخ مصر من الحملة الفرنسية إلى انتهاء عهد محمد علي
الفصل الأول: عباس باشا الأول (1265 _ 1270هـ/ 1849 _ 1854م)
تولَّى عباس باشا الأول الحكم بعد وفاة محمد علي سنة 1848م، وهو ابن طوسون بن محمد علي، وكان في نحو السادسة والثلاثين، واتَّجه منذ البداية إلى نقض معظم إنجازات جده، فألغى الاحتكار، وقلص الجيش إلى تسعة آلاف جندي، وأغلق المدارس والمعامل، واستغنى عن الموظفين الأوروبيين، مفضلًا العودة إلى العادات التركية، فعاش في عزلة بعيدًا عن الناس، مقتنعًا بعبث مقاومة أوروبا بعد إخفاق حروب الشام وسقوط آمال محمد علي، فآثر السكينة والتقشف. ومع ما وُجّه إليه من نقد، فقد تميّز حكمه بخلو مصر من الديون الأجنبية وتخفيفها من وطأة الأجانب، وكان أهم إنجاز في عهده إنشاء أول خط حديدي بين القاهرة والإسكندرية (1852 _ 1856م) برعاية إنجليزية، قُتل عباس فجأة في قصره ببنها سنة 1854م في ظروف غامضة، وتعددت الروايات عن مقتله، ثم تولَّى الحكم عمه سعيد باشا.
سعيد باشا (1270 _ 1279هـ/ 1854 _ 1863م)
نشأ سعيد محبوبًا عند أبيه محمد علي، وتلقى تعليمه في فرنسا، وتسلم الحكم والبلاد في وضع مالي جيد بلا ديون، ودخل سنوي يكفي حاجاتها، وبدأ حكمه بنشاط، لكنه ما لبث أن استبد بالسلطة، فألغى المجلس الخصوصي، وأقصى الوطنيين، وأكثر من مخالطة الأجانب حتى ضعفت هيبته، ثم انغمس في حياة الترف واللذات، ففسدت الإدارة، واهتم أساسًا بالجيش، غير أنه كان يبدل في نظامه وفق أهوائه، وجعل القناطر الخيرية معسكرًا رئيسًا، ورغم ضعفه، سعى لتحسين الزراعة والري؛ فأصدر قانون الأراضي سنة 1858م الذي مكّن الفلاح لأول مرة من ملكية الأرض، ووضع نظام الضرائب الحديث بدل المكوس السابقة، كما مد السكك الحديدية وحفر الترع وغرس الأشجار، غير أنَّه لم يهتم بالعلم والمدارس لاعتقاده أنَّها تُصعِّب حكم الشعب.
أخطر ما وقع في عهده أمران: فتح باب الاستدانة الأجنبية سنة 1862م، إذ اقترضت حكومته من لندن أكثر من ثلاثة ملايين جنية، حتى بلغت ديون مصر عند وفاته عشرة ملايين تقريبًا؛ ثم منحه ديلسبس امتياز حفر قناة السويس، الذي جرّ على مصر ويلات اقتصادية واجتماعية جسيمة، إذ تم تنفيذه بجهود وأموال المصريين لا فرنسا كما وُعد، توفي سعيد باشا سنة 1863م تاركًا البلاد مثقلة بالديون وبأعباء مشروع القناة.
الفصل الثاني: قناة السويس
تعود فكرة ربط البحرين إلى عصور قديمة؛ إذ وُجدت ترعة في عهد سيتي الأول (1380ق.م) تربط بين النيل والبحر الأحمر عبر وادي الطميلات، ثم أهملت. وفي عهد نخاو (609 ق.م) أعيد حفرها، لكن توقف العمل بعد هلاك آلاف الفلاحين، وحاول الفرس بقيادة دارا إحياءها دون إتمام، ثم أتمها بطليموس الثاني (277ق.م) قبل أن تهمل مرة أخرى، وعند الفتح الإسلامي، أعاد عمرو بن العاص فتحها وسُميت خليج أمير المؤمنين، وظلت مستخدمة حتى أمر أبو جعفر المنصور بردمها عام 145هـ. وطرح نابليون، في العصر الحديث، فكرة قناة مباشرة بين البحرين، لكن خطأ المهندس لابير الذي اعتقد بارتفاع البحر الأحمر حال دون التنفيذ. وظلت الفكرة قائمة حتى عهد محمد علي، حيث أثبتت بعثة 1847م تساوي منسوب البحرين، لكن محمد علي تردد في التنفيذ، ومع تولي سعيد باشا، منح فرديناند ديلسبس امتياز حفر القناة عام 1854م، وتلاه عقد 1856م الذي منح الشركة امتيازات واسعة لمدة 99 عامًا، منها: أراضٍ مجانية، وإعفاءات ضريبية، واستغلال المناجم، ورسوم مرور منخفضة، وقد اشترط أن يكون أربعة أخماس العمال من الفلاحين المصريين. وواجه المشروع معارضة شديدة من إنجلترا التي رأت فيه تهديدًا لمصالحها في الهند، ورغم اعتراضها في القسطنطينية ولندن، تمكن ديلسبس من استصدار موافقة الباب العالي عام 1858م، وبدأ العمل في بورسعيد 1859م، واستعان ديلسبس بالفلاحين بالسخرة، حيث سيق عشرات الآلاف للعمل تحت ظروف قاسية أودت بحياة الكثيرين، مما أثار انتقادات أوروبية وخاصة إنجليزية، وعندما توَّلى الخديوي إسماعيل (1863م)، رفض الامتيازات المجحفة، وقلّص أعداد الفلاحين المسخرين واستعاد بعض الأراضي، لكن التحكيم الدولي الذي أجراه نابليون الثالث ألزم إسماعيل بدفع غرامات باهظة بلغت أكثر من ثلاثة ملايين جنية، ما عزز موقف الشركة، بعد ذلك، استبدلت الشركة العمال بالسخرة بعمال مدربين، وتحسن وضعها المالي، وأكمل المشروع بدعم فرنسي. وافتُتحت القناة رسميًا عام 1869م في احتفال ضخم. ومع ذلك، تحملت مصر أعباء مالية إضافية؛ إذ دفعت مبالغ كبيرة مقابل أراضي الطميلات وبعض المباني، وبلغت تكلفة الحفر نحو 17.5 مليون جنية، بينما أنفقت الحكومة المصرية ما يقارب 160 مليون فرنك. واقتصرت فائدة القناة، في بدايتها، على السفن الشراعية بسبب استهلاك البواخر للفحم، لكن بعد تطوير المحركات البخارية اتسع استخدامها. ورغم ذلك، عانت الشركة من ضعف الأرباح وانخفاض قيمة أسهمها حتى مؤتمر 1873م الذي أقرَّ زيادة الرسوم، فبدأت بالنجاح التدريجي غير أن مصر لم تستفد؛ إذ تحملت التكاليف والخسائر البشرية، وفقدت جزءًا من دخل سكك الحديد بعد تحول التجارة للقناة، كما تنازلت عام 1880م عن حصتها من الأرباح مقابل دين زهيد، وبذلك كانت مصر والفلاحون هم الخاسر الأكبر، بينما جنت فرنسا وبريطانيا الثمار السياسية والاقتصادية.
وقد جعلت تعدد مصالح الدول الأوروبية في القناة سببًا لتحييدها، مع بقاء احتمالية إعادة النظر في شؤونها مستقبلًا.
الفصل الثالث: إسماعيل باشا (1279 _ 1296هـ/ 1863 _ 1879م)
يُعدُّ إسماعيل باشا ابن إبراهيم باشا المتمم الحقيقي لأعمال محمد علي، وسار على نهجه في الإصلاح والنهوض بمصر، تولى عرش مصر في 27 رجب 1279هـ/ 18 يناير 1863م، وكان عمره 32 سنة، وقد امتاز بالذكاء وقوة الملاحظة، ودرس اللغة الفرنسية في باريس، وزار أوروبا حيث اطلع على أسباب الحضارة الأوروبية، رغم أنه لم يتلق تربية تؤهله لتولي الملك منذ صغره. وواجه إسماعيل مشكلات مالية بسبب سرعة تنفيذ الإصلاحات والإنفاق الكبير، مما أدَّى إلى استدانة مصر من أوروبا وتدخلها لاحقًا في شؤون البلاد، لكنه حقق إنجازات مهمة انعكست على تقدم مصر.
1 _ وراثة العرش
سعى إسماعيل لتقليص النزاع على العرش بين أفراد الأسرة، فطالب الباب العالي بجعل الوراثة لأكبر أولاد الخديوي بلا شرط، وهو ما تحقق في 12 المحرم 1283هـ/ 27 مايو 1866م مقابل زيادة الجزية المصرية مم 220000 إلى 600000 جنية.
كما حصل على لقب “خديوي” في ربيع الأول 1282هـ/ يوليو 1867م، ومنحه الباب العالي استقلالًا داخليًا تامًا بمقتضى عهد ربيع الآخر 1290هـ/ 1873م، بما ضمن له حرية إدارة شؤون البلاد الداخلية والتصرف في القروض والجيش ضمن حدود معينة.
2_ الاستقلال الداخلي والإدارة
نظم إسماعيل إدارة مصر الداخلية، بعد حصوله على الاستقلال الداخلي، وأدخل إصلاحات واسعة في نظام الإدارة، والمكوس، والبريد، وتقسيم البلاد إلى 14 مديرية، وحسن طرق الاتصال والقضاء.
3 _ الإصلاحات القضائية ومساواة جميع الناس أمام القانون
أولى إسماعيل اهتمامًا كبيرًا بإصلاح القضاء وجعل المحاكم مستقلة عن الإدارة، وأسس المحاكم المختلطة لتساوي الجميع أمام القانون، بما يشمل الأجانب والمصريين.
وتعاون مع نوبار باشا، واستمرت المفاوضات مع الدول الأوروبية سبع سنوات، حتى تأسست المحاكم المختلطة في ذي الحجة 1291هـ/ يناير 1875م، وفتحت أبوابها في المحرم 1293هـ/ فبراير 1876م. شملت المحاكم القاهرة، الإسكندرية والمنصورة، مع محكمة استئناف عليا بالإسكندرية.
4 _ التربية والتعليم
حرص إسماعيل على التعليم لجميع طبقات الشعب، وأسهم في نشر العلم والتعليم العالي، وأنشأ مدارس متنوعة مثل مدرسة الهندسة، والطب، والحقوق، والفنون، والألسن، ودار العلوم، مع مراعاة الحرية في اختيار اللغة مع إجبار على تعلم العربية والتركية، وأصدر قانون التعليم في 10 رجب 1282هـ/ 1867م، وارتفع عدد التلاميذ إلى 120977وعدد المدارس إلى 4817، كما شجع تعليم البنات بإنشاء أول مدرسة خاصة لتعليمهن الواجبات المنزلية، وأسهم في تطوير دار الكتب، وجمع الكتب والمصاحف المزخرفة، ورفع مستوى الثقافة والمعرفة، مما ساعد على النهضة الحديثة في مصر.
_ دار الآثار المصرية
حرص إسماعيل على حماية الآثار المصرية القديمة، وبذل جهدًا مع مريت باشا في تنظيم دار العاديات، ونقلها من بولاق إلى الجيزة عام 1308هـ/ 1891م، ثم إلى مكانها الحالي قرب قصر النيل عام 1320هـ/ 1902م.
أسهمت هذه الجهود في المحافظة على التراث الثقافي المصري وظهوره بمستوى يضاهي أعظم دور الآثار الأوروبية.
5_ منع تجارة الرقيق
سعى إسماعيل باشا إلى القضاء على تجارة الرقيق داخل مصر، فلم يكتف بمنعها على الورق، بل عزم على اقتلاع هذه المهنة تمامًا، وصادف صعوبات جمة بسبب اعتقاد بعض شرائح الشعب بعدم مخالفة الدين الإسلامي لهذه التجارة، ولفت كبار المستكشفين الإنجليز، مثل ليفنجستون وبيكر وأستانلي، الأنظار إلى الفظائع المرتكبة في وسط أفريقيا، وأكدوا معاناة السكان من الذل والعذاب.
تم توظيف السير صموئيل بيكر لاستكشاف منابع النيل الأبيض وإنشاء نقاط عسكرية لمنع تجارة الرقيق، فنجح جزئيًا، وأعلن رسميًا ضم المقاطعات الاستوائية للحكومة المصرية سنة 1871م. كما عمل بعده غردون وكمت دلا سلا على محاربة الجلابين، لكن القضاء على تجارة الرقيق بالكامل كان مستحيلًا في ذلك الوقت، فأبرم إسماعيل باشا معاهدة مع بريطانيا سنة 1877م وأخرى في 1878م لمنع بيع الرقيق، ونال إشادة دول أوروبا بهذا الإنجاز.
6_ منح السلطة للنظار وإنشاء مجلس شورى النواب
أعاد إسماعيل باشا المجلس المخصوص الذي أسسه محمد علي باشا، ووسع اختصاصاته حتى صار شبيهًا بمجلس الوزراء، لكنه احتفظ بالسلطة المطلقة، وشكل أول مجلس نظار برئاسة نوبار باشا سنة 1878م بمشاركة بعض الأجانب، ومنحهم مسؤولية اتخاذ القرارات، وأنشأ أيضًا مجلس شورى النواب في 19 نوفمبر 1866م، وافتتحه بمشاركة العلماء والأعيان، فكان المجلس يناقش الحكومة ويقدم الرأي في التغيرات المالية والمشروعات العامة، ونتيجة قلة خبرة الأعضاء في البداية، إلا أنَّه قد تم تدريبهم على أعمال المجلس بواسطة شريف باشا.
7 _ التقدم المادي والأعمال العامة
الزراعة
اهتم إسماعيل باشا بالزراعة بوصفها ثروة البلاد، فحفر أكثر من 200 ترعة، وأقام آلاف الأميال من الطرق الزراعية، وأنشأ نحو 500 قنطرة، وأصلح 15000 فدان مما زاد الأراضي المزروعة بنسبة 30%. خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وارتفعت أسعار القطن فزاد إسماعيل باشا من زراعته، ثم اتّجه لزراعة قصب السكر وأنشأ معامل ومصانع وخطًا حديديًا من القاهرة إلى أسيوط، وأنفق ملايين الجنيهات على مشاريع الري والزراعة.
التجارة
أنشأ منارات في البحر المتوسط والأحمر لتوجيه السفن، وأصلح موانئ السويس والإسكندرية بالتعاون مع شركات فرنسية وإنجليزية، وبنى أسطولًا تجاريًا لنقل البضائع والبريد، ما عزز مكانة مصر التجارية.
الأعمال العامة
طور شبكة السكك الحديدية من 330 ميلًا قبل حكمه إلى 1330 ميلًا، وأنشأ خطوط حديدية في أفريقيا، وبنى 5200 ميل من الأسلاك البرقية، وأسس مكاتب بريد تجاوزت 210 مكاتب، وأنار المدن بالغاز ومدّها بالمياه، وأنشأ شوارع واسعة بالقاهرة والإسكندرية والسويس، فزادت الصادرات والواردات بشكل مطرد.
8 _ حروب إسماعيل باشا والفتوح التي تمت في عصره
اهتم إسماعيل باشا بجيشه، فجهزه بأفضل الأسلحة، وضم ضباطًا أوروبيين وأمريكيين، وبلغ الجيش النظامي 60 ألف مقاتل.
توسيع النفوذ في أفريقيا
عهد إلى صمويل بيكر وغردون باشا باستكشاف ضفاف النيل الأبيض والسيطرة على السودان، وأنشأ نقاطًا عسكرية لمنع تجارة الرقيق، وفتح دارفور عام 1873م، وهرر عام 1875م، وأرسل حملات إلى نهر جوبا وبلاد قسمايو، كما خاض حروبًا ضد الحبشة ونجح جزئيًا بعد صلح عام 1876م.
رجوع غردون إلى الحكومة المصرية
توّلى غردون، في 1877م، حكم جميع الأقطار السودانية، وقسم المديريات الاستوائية إلى قسمين لإدارة أفضل، وقضى على عصيان الزبير باشا وابنه سليمان، واستمر في مكافحة تجارة الرقيق حتى استقالة حكمه في عهد توفيق باشا.
9 _ إتمام قناة السويس
كان لإسماعيل باشا الدور الأكبر في إنجاز قناة السويس، فأشرف على الافتتاح في 1869م بالإسماعيلية، ودعا ملوك أوروبا وأمراءها، وأنفق ملايين الجنيهات على تجهيز الحفلة، بما فيها القصر المزخرف وملحقاته، والطرق المؤدية للأهرامات، وتهيئة السكك الحديدية والعربات والمرافق للزوار، وهذا المشروع أضاف مرحلة جديدة للملاحة العالمية، وساعد على تقصير الرحلات بين الشرق والغرب، وارتبط اسمه دومًا باسم إسماعيل باشا.
الفصل الرابع: المسألة المالية وانتهاء حكم إسماعيل باشا
لقد شهدت مصر في عهد إسماعيل باشا مشروعات ضخمة وأعمال عامة واسعة، فضلًا عن قصوره وحفلاته الباذخة، مما استلزم نفقات هائلة تجاوزت قدرة خزائن الدولة على التحمل، ولتغطية هذه النفقات، لجأ إسماعيل باشا إلى طرق متعددة، منها:
الدين السائر: تأجيل دفع بعض الأعمال بدون نقد.
الديون الثابتة: اقتراض من الدول الأوروبية بضمان موارد ثابتة مثل دخل المديريات.
الديون المحلية: جمع الأموال من الأهالي بزيادة الضرائب أو قوانين خاصة مثل قانون المقابلة، الذي سمح للفلاحين بتسديد ضريبة ست سنوات مقدمًا مقابل إعفاء دائم من نصف الضرائب السنوية، ودين الرزنامة الذي كان يتيح للمواطنين إقراض الحكومة مقابل عوائد سنوية 9%. وقد استدان إسماعيل باشا، في عام 1873م، مبلغ 320 مليون جنية لتسديد الديون السائرة، لكن ما حصلته الحكومة فعليًا كان 200620 جنية بعد الخصومات، وكان جزء كبير من المبلغ سندات خزينة، ومع استمرار الأزمة المالية، لجأت الحكومة لبيع أسهم القناة وإنشاء سندات على خزائن الدولة، لكن هذه الإجراءات لم تحل الأزمة، وفي أكتوبر 1875م بدأ التدخل الأوروبي الفعلي، حين طلب إسماعيل باشا من الحكومة الإنجليزية إرسال موظف خبير بالشؤون المالية، فجاء المستر كيف لتقديم تقرير حول تسوية الديون المصرية، لكنه لم يُنفذ، وفي أبريل 1876م توقف الخديوي عن صرف سندات الخزانة، مما عُدَّ بداية المشكلة المالية الحقيقية وتدخل أوروبا في الشؤون المصرية، فتم إنشاء صندوق الدين بإشراف مندوبي الدول الأوروبية، وتم توحيد الديون المصرية بمبلغ 910000 جنية بفائدة 9%، مع التزام بسدادها خلال 65 سنة. إلا أن الدائنين الإنجليز طالبوا بتعديل النظام بسبب فروق الديون، فتم في نوفمبر 1876م تعديل الدين الموحد، وحُدد سعره 6%، مع سداد 1% من الأصل سنويًا. بعد ذلك، بدأ إسماعيل باشا بالإصلاحات بإشراف موظفين أوروبيين، مثل: المراقب الإنجليزي للسير رفرز ولسن، والمراقب الفرنسي المسيو بلنيير. لكن الخديوي لم يمنحهم الحرية الكاملة، وظلت المصاعب المالية مستمرة، بما فيها مشاكل دفع الرواتب للجند، مما أدَّى إلى اضطرابات ومشاكل سياسية، وطلبت لجنة التحقيق التي تشكّلت أبريل 1878م برئاسة المسيو ديلسبس وبإشراف الأوروبيين إصلاحين رئيسيين، هما:
1 _ التنازل عن أملاك الأسرة الخديوية للحكومة مقابل راتب سنوي.
2 _ عدم إدارة شئون البلاد منفردًا، مع إشراك وزراء مؤاخذين.
وفي أغسطس 1878م، شُكلت وزارة برئاسة نوبار باشا ضمت الأوروبيين، وأصبحت الأملاك الدومينية ضمانة لدين جديد يسمى دين روتشيلد، وبدأت اللجنة الإصلاحية بفحص الشؤون المالية، لكنها واجهت عراقيل من الخديوي، الذي سعى لاستعادة نفوذه ورفض إعلان إفلاس الحكومة، وأعد مشروع تسوية مالي خاص به بمساعدة أتباعه، وأدَّت هذه الأوضاع إلى غضب الدول الأوروبية، التي رأت أنَّه لا يمكن تسوية الشؤون المالية وتثبيت حقوق رعاياها ما دام إسماعيل باشا في السلطة، فاتُخذ قرار بعزله، وأُبلغ إسماعيل باشا بالقرار في يونيو 1879م، فتنازل عن الحكم وسلم السلطة لابنه توفيق باشا، وغادر مصر إلى إيطاليا في نهاية يونيو 1879م.
الفصل الخامس: أوائل حكم توفيق باشا (1296 _ 1298هـ/ 1879 _ 1881م)
تولَّى توفيق باشا الحكم في (19 شعبان 1296هـ/ 8 أغسطس 1879م) والبلاد غارقة في الأزمات، إذ كانت الخزينة فارغة، والجيش مختل النظام، والسخط شعبي من الفقراء والأغنياء، ونقمة الأوروبيين بسبب تأخر الديون وكساد التجارة، ورغم أنَّ توفيق لم يكن قوي العزم إلَّا أنَّه كان محبًا للبلاد، ساعيًا لإصلاحها، واقتضى الأمر قبل الشروع في الإصلاح أن تُحسم أربع مسائل أساسية، وهي: تحديد نفوذ الخديوي، وتقرير العلاقة مع الدولة العثمانية، ونوع إشراف الأوروبيين على مصر، وتسوية المسألة المالية مع الدائنين. وفي المسألة الأولى عهد الخديوي إلى شريف باشا بتشكيل وزارة، فاقترح نظامًا نيابيًا خالصًا إلَّا أنَّ توفيق رفض لعدم ملاءمة البلاد للانتقال المفاجئ من الاستبداد إلى النيابة، فاستقال شريف في (29 شعبان 1296هـ/ 18 أغسطس 1879م)، وبعدها قرر توفيق ترؤس مجلس الوزراء بنفسه، ثم أسند الوزارة إلى رياض باشا (4 شوال / 22 سبتمبر)، ومنح الوزراء نفوذًا حقيقيًا، فاستقرت الأمور نسبيًا.
أما مسألة علاقة مصر بالدولة العثمانية، فقد سعى الباب العالي بعد عزل إسماعيل لإلغاء امتيازات تقليد سنة (1290هـ/ 1873م)، وقد منح ذلك التقليد أربع ميزات:1_ حصر الوراثة في أكبر أبناء الخديوي.2_ حق مصر في عقد معاهدات تجارية. 3_ حق الخديوي في الاقتراض الخارجي. 4_ حرية زيادة الجيش. وعارضت فرنسا إلغاء الامتيازات كلها حفاظًا على نفوذها، أما إنجلترا فاقتصرت معارضتها على مسألة الوراثة ضمانًا للاستقرار، وبعد جدال، صدر تقليد جديد يقيد الجيش بحد 18000 جندي في السلم، ويمنع عقد قروض إلا بالاتفاق مع الدائنين.
وأما المسألة الثالثة وهي تعيين نوع إشراف الأوروبيين على شؤون الحكومة، فقد تقرر إعادة المراقبة الثنائية، على أن يقتصر دور المراقبين على الفحص والتدقيق دون التدخل المباشر، فعُيّن السير إفلين بيرنج عن إنجلترا ودي بلنيير عن فرنسا (ذو الحجة 1296هـ/ نوفمبر 1879م)، ولم يُعزل أي منهما إلا بموافقة دولته، ونالا ثقة الحكومة المصرية، فحضرا مجالس الوزراء، وأعدا مشروعات أسهمت في إصلاح المالية وتسوية الديون، ومهّدا لإصلاحات لاحقة.
وأما تسوية المسألة المالية مع الدائنين، فقد أنشئت لجنة «التصفية» للفصل النهائي بين مصر ودائنيها برئاسة السير رفرز ولسن، وفي أثناء أعمالها قدم المراقبان مشروعًا لتخفيض فوائد الدين وإلغاء المتأخرات، مع إصلاحات ضريبية شملت: إلغاء قانون المقابلة نهائيًا، وتقليص الفارق بين الأراضي العشرية والخراجية بزيادة ضريبة على الأولى، وإلغاء معظم الضرائب الصغيرة المرهقة، وتنظيم مواعيد دفع الضريبة الزراعية بما يناسب الفلاحين. وفي النهاية صدر «قانون التصفية» في (8 شعبان 1297هـ/ 17 يوليو 1880م) متضمنًا أهم النقاط:
1. تخفيض فائدة الدين الموحد من 7٪ إلى 4٪ وضمانة من دخل الجمارك والمكوس ومديريات محددة.
2. إدخال الديون القصيرة الأجل ضمن الدين الموحد بعد خصم 20٪.
3. إصدار قرض ممتاز جديد 8743800 جنية لتسوية الديون السائرة.
4. إشراف دولي على «الدائرة السنية».
5. صرف 150 ألف جنية سنويًا لمالكي أراضي «المقابلة».
6. تقسيم دخل الحكومة بين إدارة البلاد وسداد الديون.
وبعد الفصل في مسألة الدين تفرغت الحكومة والمراقبة لإصلاحات عديدة، أهمها في التعليم حيث شُكلت لجنة علمية برئاسة علي إبراهيم باشا في (7 جمادى 1297هـ/ 27 مايو 1880م)، فأعادت تنظيم المناهج ووسّعت التعليم، وضاعفت ميزانية المعارف، وأولت عناية بالري، وشق الترع، وبناء القناطر والجسور، فدخلت البلاد طور إصلاح واعد، غير أن الأحداث السياسية سرعان ما قطعت الطريق باندلاع الثورة العرابية.
الفصل السادس: الحوادث العرابية 1298 – 1299هـ / 1881 _ 1882م
عندما كانت الإصلاحات تسير في طريق تقدم البلاد، انتشر الاستياء في الجيش بسبب أن الترقيات كانت غالبًا للأتراك والشراكسة، بينما قلما نال الضباط المصريون الرتب العليا، وزاد السخط حين أصدر عثمان رفقي باشا قانون القرعة الذي منع الترقي من تحت السلاح، فرأى الضباط أن مدة الخدمة أربع سنوات في الجيش غير كافية للترقي.
بداية الثورة العرابية
تذمر بعض الضباط المصريين بقيادة علي فهمي، وأحمد عرابي، وعبد العال حلمي، وقدموا معروضًا إلى رياض باشا يطالبون بعزل رفقي باشا وإجراء تحقيق في الترقيات الأخيرة، المعروض أثار غضب الخديوي الذي أمر بمحاكمة الضباط، فهاجم ضباط الآلايين مجلس النظار وأنقذوا رؤسائهم بالقوة، ثم سار عرابي وعلي فهمي إلى قصر عابدين لطلب عزل ناظر الحربية، فاستجاب الخديوي وأبعد رفقي باشا، وبعد ذلك شكلت لجنة للنظر في مظالم الجيش، ورفعت رواتب الضباط والجند، وأصبحوا على قدم المساواة مع الأتراك والشراكسة، فهدأت الأحوال مؤقتًا.
تمدد نفوذ عرابي
ازداد تأثير عرابي بين الجيش والعمد والعلماء، وبدأ يصدر منشورات يطمئن فيها قناصل الدول الأجنبية، ويعلن نفسه صاحب الحق في حفظ النظام، وفي سبتمبر 1881م، سار الجيش بقيادة عرابي إلى ميدان عابدين، مطالبًا بعزل جميع النظار، وتشكيل مجلس نيابي، وزيادة الجيش إلى 18 ألف جندي، وافق الخديوي على عزل النظار وترك أمر الطلبين الآخرين لقرار الباب العالي، وتشكلت وزارة جديدة برئاسة شريف باشا، وأبعد رؤساء الحزب العسكري عن العاصمة، لكن نفوذ عرابي استمر بالتزايد، وتم تنصيبه وكيلًا لنظارة الحربية، ما عزز موقف الحزب العسكري على الحكومة.
تدخل الدول الأوروبية
رأت فرنسا وبريطانيا ضرورة التدخل لحماية مصالحها، وأرسلت مذكرة إلى الخديوي في يناير 1882م، وهو ما أزعج المصريين وعضد موقف عرابي وحزبه، فاستقال شريف باشا، وشكلت الوزارة الجديدة في فبراير 1882م برئاسة محمود سامي باشا البارودي، وجعلت عرابي وزير الحربية، فزاد نفوذ الحزب العسكري، وزادت رواتب الجيش وتم توسيع صفوفه بلا اكتراث بالميزانية.
واقعة الأحد في الإسكندرية
نشب شجار بين رجل مالطي ومصري في الإسكندرية في 11 يونيو 1882م، فتصاعد النزاع بين الأهالي والأوروبيين، وبدأ الرعاع بالنهب وإطلاق النار، ما أدَّى إلى تدخل الجيش لتفريق المتجمهرين، وأسفرت الأحداث عن تهديد أمني وأثرت على موقف الدول الأوروبية تجاه الحركة العرابية، وقررت التدخل لاحقًا في مؤتمر الأستانة.
التحركات العسكرية والاحتلال الإنجليزي
استعد عرابي لمواجهة الإنجليز مع تصاعد الثورة، وحاول صدهم من كفر الدوار وحماية قناة السويس، ومع وصول الأسطول الإنجليزي، هاجموا قلاع الإسكندرية في 11 يوليو 1882م، واستمر القصف لساعات، ثم احتلوا المدينة بعد نهبها، وحاول عرابي الوقوف في وجه الإنجليز عند التل الكبير، لكنه انهزم في معركة 13 سبتمبر 1882م بسبب التفوق التنظيمي للجيش الإنجليزي، وفرَّ إلى القاهرة دون دعم من الأهالي، ودخل الإنجليز القاهرة في 5 أكتوبر 1882م، واستلموا القلعة وباقي الثكنات العسكرية، وبدأ الاحتلال البريطاني للقطر المصري، وسلم عرابي نفسه، وتم القبض على معظم قادة الثورة.
الفصل السابع: عهد الاحتلال البريطاني
1 _ قدوم اللورد دفرين إلى مصر
دخلت مصر منذ عام (1299هـ/ 1882م) مرحلة جديدة من التدبير تحت إشراف بريطانيا، بعد إخماد ثورة عرابي، فأرسلت بريطانيا اللورد «دفرين» إلى مصر لتقديم المشورة للحكومة الخديوية في تهدئة البلاد وتثبيت عرش الخديوي، ونصح دفرين بالعفو عن الضباط الذين تقل رتبتهم عن «البكبشي» مع تجريدهم من الرتب والمعاشات، وأُقيمت محاكمات عسكرية لزعيم الثورة عرابي وآخرين، حكم عليهم بالنفي المؤبد إلى جزيرة «سرنديب» بالهند. واقترح دفرين إلغاء المراقبة المالية الثنائية بين مصر وفرنسا، فأيدت الحكومة الإنجليزية رأيه، وأُلغي المراقب الفرنسي في يناير 1883م، وعُين مستشار مالي إنجليزي للحكومة المصرية، كما اهتم دفرين بإنشاء جيش مصري جديد على رأسه قائد إنجليزي «السير إفلن وود» وتنظيم الشرطة بتعيين «الجنرال بيكر» تحت وزارة الداخلية، واقترح أيضًا إنشاء هيئات نيابية لتدريب البلاد على الحكومة النيابية، لكنها لم تُنفذ بالكامل بسبب عدم تأهل البلاد لذلك، وكانت بريطانيا تهدف للجلاء بعد ترسيخ الإصلاحات، لكن مشكلات السودان والعراقيل الداخلية أجبرتها على البقاء لفترة أطول. ووصل بعد دفرين السير «إقلين بيرنج» في سبتمبر 1883م ليواصل تنفيذ خطة الإصلاح، فشملت الجيش والشرطة والتعليم والمحاكم والري ومسح الأراضي وتخفيض الضرائب.
2 _ حروب السودان
استولى محمد علي على السودان سنة 1235هـ / 1820م، لكن سلطته لم تتوطد، وظل الباشوات الترك وجباة الضرائب يسيطرون على الأمور بطريقة استغلالية، حاول الجنرال الإنجليزي غردون إقامة النظام في المقاطعات الاستوائية سنة 1291هـ/ 1874م، إلَّا أنَّه غادر سنة 1293هـ / 1876م، وعاد ظلم الجباة القديم مع نشوب ثورات متفرقة، وظهر محمد أحمد في السودان عام 1359هـ/ 1843م، وادَّعى كونه «المهدي المنتظر» سنة 1298هـ/ 1881م، فانتشرت دعوته، وعند محاولة الحكومة المصرية القبض عليه، قتل أتباعه رءوف باشا، وبدأت الثورة تتوسع، وسيطر المهدي على مدينة «الأبيض» سنة 1300هـ/ 1883م، فأرسلت الحكومة المصرية الضباط الإنجليزي ضمن الجيش المصري لإنقاذ السودان، لكن الحملة بقيادة هكس باشا فشلت بسبب سوء التدريب ونقص الأموال ووسائل النقل، وتم القضاء على معظم الجيش.
إخلاء السودان
نصحت بريطانيا الحكومة المصرية بإخلاء السودان إلى وادي حلفا مؤقتًا، فرفض شريف باشا ثم وافق نوبار باشا على سلخه عن مصر، وأُرسل غردون باشا ليقود عملية الجلاء، إلَّا أنَّه أهمل التنفيذ وطلب دعمًا عسكريًا لمواجهة المهدي، غير أن الدعم لم يُرسل، فتوسع نفوذ المهدي حتى وصل إلى الخرطوم، وقطع خط الرجعة عن غردون.
حملة إنقاذ غردون
أرسلت بريطانيا حملة بقيادة اللورد ولسلي، ولكن في أثناء وصولها سيطر الدراويش على الخرطوم وقتلوا غردون في 9 ربيع الآخر 1302هـ/ 26 يناير 1885م، بسبب خيانة فرج باشا قائد الحصون، وحاولت الحملة الإنجليزية استعادة المدينة، لكنها تراجعت لالتزامات أخرى، فتم إخلاء دنقلة ووادي حلفا بوصفها حدود نهائية لمصر.
بعد وفاة المهدي في 9 رمضان 1302هـ/ 21 يونيو 1885م، تولَّى عبد الله التعايشي الخلافة، لكنه هزم أمام الجيش المصري في موقعة «جنس» 23 ربيع الأول 1303هـ/ 30 ديسمبر 1885م، فأمنت مصر من غزو السودان. واستمر نفوذ المهدي في السودان، مع تنازل بعض المناطق لممالك مجاورة: كمصوع لإيطاليا، وبوغوس للحبشة، وامتلاك بريطانيا لبربرة وزيلع وأوغندا، وفرنسا لبحر الغزال والنيل الأبيض، واستمرت مصر في تقوية جيشها وصد هجمات الدراويش، حتى هدأت الأحوال في السودان الشرقي بعد حملة بحرية سنة 1891م بقيادة «السير فرنسيس غرنفل» ضد «ولد النجومي» و«عثمان دقنة».
استرجاع السودان
لم يأت عام (1313هـ/ 1895م) حتى تحسنت المالية المصرية وارتقى جيشها، فظنّت الحكومة أنَّه من السهل شن حملة على السودان لاسترجاعه، غير أن الحكومة كانت تفضّل إدخار المال لإنشاء خزان أسوان، إلا أنَّ أحداثًا خارجية أجبرتها على العمل: تحالف الأحباش مع الدراويش وهزمت الطليان، مما دفع إيطاليا لطلب مساعدة إنجلترا لإرسال حملة إلى السودان، فاستجابت إنجلترا لتجنب تقدم فرنسا نحو أعالي النيل وللأخذ بثأر غردون، فأعدت جيشًا مصريًا وإنجليزيًا بقيادة السير هربرت كتشنر، فتحرك الجيش من وادي حلفا نحو دنقلة، وقضى على 3500 من الدراويش عند فرقة، رغم انتشار المرض، واستولى على دنقلة في (15 ربيع الآخر 1314هـ/ 23 سبتمبر 1896م)، وواصل الجيش زحفه نحو الخرطوم، واستولى على أبي حمد و«برير»، وتأجل الزحف عدة أشهر لإكمال الخط الحديدي. وفي (7 شعبان 1315هـ/ 1 يناير 1898م) التقى الأمير محمود بنحو 12000 مقاتل عند النخيلة، وانتصر الجيش بسرعة، وأسر الأمير محمود وقتل 2000 من رجاله، وبلغ الجيش نحو 22000 مقاتل شمالي الخرطوم، والتقى بالدراويش في موقعة أم درمان في (15 ربيع الآخر 1316هـ/ 2 سبتمبر 1898م) فانهزم الدراويش هزيمة ساحقة، واستولى الجيش على الخرطوم، ورفع العلمين المصري والإنجليزي، وفرّ الخليفة التعايشي، ثم قتل في (رجب 1317هـ/ نوفمبر 1899م)، فانقضت دولة الدراويش، وعقب ذلك هدأت أحوال السودان تحت حكم مشترك مصري – إنجليزي، وألغيت سلطة الباب العالي عليه وفق اتفاقية السودان (6 رمضان 1316هـ/ 19 يناير 1899م).
تقدم مصر منذ عام 1882م
نشأ التقدم العام في مصر منذ (1299هـ/ 1882م) نتيجة إصلاحات إدارية في مصالح الحكومة وأعمال عامة لتحسين الري وزيادة الثروة، فركزت الحكومة على تحسين حال الفلاحين، بخفض ضريبة الأرض وإلغاء بعض الضرائب مثل الملح، وإنهاء السخرة، ورفع كفاءة الإدارة المالية، بما يساعد على الوفاء بالديون المستحقة وفق قانون التصفية، وساعدت إنجلترا مصر في الحصول على قرض عام 1885م قدره 9000000 جنية لضبط الميزانية وتحسين الأشغال العامة، ومنها سد العجز في الميزانية وتعويض خسائر الثورة العرابية، وتحسين الري.
الأشغال العامة
اهتمت الحكومة بإصلاح القناطر والترع، ولاسيما القناطر الخيرية، التي كانت متضررة بعد إهمال طويل، وتم إصلاح أساسها وبناء أحجار حماية حولها، فأصلحت قناطر البحيرة والمنوفية والتوفيقي وأعيدت تغذيتها بالمياه، وتم إنشاء مصارف وقنوات جديدة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة، وتم العمل على تحويل الري بالحياض إلى ري دوري في أسيوط والمنية وبني سويف والجيزة، مع توسعة ترعة الإبراهيمية وإنشاء قناطر بأسيوط لحجز المياه، مما ساعد على زيادة محصول القطن وغيره من المحاصيل، وتم البدء في إنشاء خزان أسوان في (1898م) وانتهى العمل فيه سنة (1902م)، بطول 2156م وارتفاعه 28م، بسعة خزن كبيرة، ساعد على تنظيم الري ومواجهة انخفاض النيل، وأدَّى إلى زيادة الأراضي المزروعة واستقرار الزراعة في مصر الوسطى، وجرى تعديل كثير من الترع وإنشاء مصارف جنوبية، والتخطيط لإنشاء خزان آخر على النيل الأبيض، لتأمين المياه وقت الفيضان وحفظها للري المستمر. وكانت هناك إصلاحات حكومية أخرى، من أهمها: إعادة تنظيم المحاكم الأهلية وفق قانون أهلي شبيه بالقانون الفرنسي، مع إشراف مستشار قضائي وتخريج قضاة أكفاء، ما أسهم في تسهيل التقاضي وضبط العدالة. وضبطت الإيرادات المالية والمصروفات، وحدّت الضرائب، وزادت مواعيد التحصيل بما يتناسب مع قدرة الفلاحين. وتوسعت الطرق الزراعية إلى نحو 2500 كلم، وانتشرت السكك الحديدية الضيقة في الوجهين البحري والقبلي، وأنشئت خطوط ترام في القاهرة والإسكندرية. وأقيمت مبانٍ فخمة مثل قصر المحكمة المختلطة الكبرى بالإسكندرية ودار العاديات بالقاهرة. وانتشرت المستشفيات والمدارس، وأعيد إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا لاكتساب المعارف الحديثة، ويمكن القول بإيجاز أنَّ مصر شهدت نهضة شاملة منذ عام 1882م في جميع جوانب الإدارة العامة، والمالية، والأشغال العامة، والعدالة، والصحة، والتعليم، مما مهد الطريق لتقدم مستمر في البلاد.




