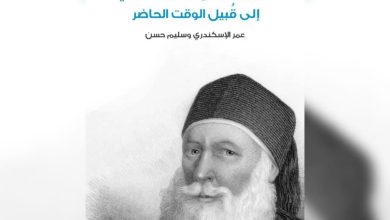تاريخ الأردن المعاصر، عهد الإمارة 1921 _ 1946م، تأليف الدكتور علي محافظة، نشر بمساعدة من الجامعة الأردنية، عمان، ط1، 1973م
المقدمة
يُعد كتاب “تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارة 1921–1946م” للدكتور علي محافظة واحدًا من أوائل الدراسات الأكاديمية التي تناولت البدايات التأسيسية للدولة الأردنية. فقد جاء هذا العمل في وقت مبكر من السبعينيات ليضع بين يدي الباحثين والمهتمين سجلًا موثقًا لمسيرة الإمارة منذ قدوم الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان، مرورًا بمرحلة الانتداب البريطاني، وصولًا إلى إعلان الاستقلال وقيام المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946م.
يمثل هذا الكتاب محاولة رائدة لإعادة قراءة تلك الحقبة المعقدة، التي امتزجت فيها التحديات الداخلية المتمثلة في أوضاع العشائر والإدارة الناشئة، مع الضغوط الإقليمية والدولية التي فرضتها اتفاقيات ما بعد الحرب العالمية الأولى. ومن خلال أربعة أبواب رئيسية، يفتح المؤلف نافذة على التحولات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شكّلت ملامح الدولة الأردنية الحديثة.
كتاب جاء في 223 صفحة، يشتمل على أربعة أبواب، تسبقها مقدمة ومدخل وبعض المحطات التاريخية قبل عهد الإمارة، ويليها بعض الملاحق والفهارس، ويمكن عرض ذلك بصورة موجزة على النحو الآتي:
_ في المقدمة برر الإشكال الذي تواجهه كتابة التاريخ المعاصر، وعلل كتابته تاريخ الأردن بالتحديد، وبيَّن نوعية المصادر التي اعتمد عليها في كتابة هذا التاريخ،

_ ووضح في المدخل أن المنطقة التي عُرِفَت باسم(إمارة الأردن) كانت جزءًا لا يتجزأ من بلاد الشام، وقد خضعت للعثمانيين في مطلع العصور الحديثة، وتم الاهتمام بها وبناء البرك والقلاع فيها لتأمين حياة الحجاج المارين فيها، ويذكر القبائل والمواقع التي تعيش فيها، وما تتعرض له من هجمات بعض القبائل البدوية في فصلي الربيع والصيف، ويسترسل في بيان مقدار الضرائب وأنواعها التي كانت تجبى في هذه المنطقة لصالح العثمانيين، ولصالح بعض أهل البلاد كضريبة الفلاحين لمشايخ البدو، وأوضاع البلاد وأحوالها المرافقة لأحوال الخلافة العثمانية وما مرت به من تحولات خاصة وعامة شهدها العالم أجمع كالحرب العالمية الأولى.
_ وفي وقفته تحت عنوان(شرقي الأردن في العهد الفيصلي) يبين كيف اعتقد العرب بناءً على تصريحات وبيانات الحلفاء أنهم سيحظون بالاستقلال بعد انتهاء الحرب، ثم كيف تعاملوا معهم، بتوجيههم إلى إدارة مناطق معينة تحت إشرافهم، واتفاق سايكس البريطاني وبيكو الفرنسي على تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية، وتوصلهما (البريطانيون والفرنسيون) إلى اتفاق بينهما ضرب بعرض الحائط بالوعود التي قطعتها بريطانيا للشريف حسين، ومخاطبة الأمير فيصل لرئيس أمريكا، وإرساله لجنة إلى بلاد الشام لمعرفة تطلعات أهلها في ظل رفض فرنسا وبريطانيا للاشتراك فيها، وإعلان الأمير فيصل عن تشكيل حكومة برئاسة علي الركابي، واتفاق فرنسا وبريطانيا، على تقاسم المنطقة وانسحاب الجيش البريطاني من سورية ليحل محله الفرنسي، ويدخل بعد حرب ومقاومة إلى دمشق في 2 آب 1920م، ومغادرة الملك فيصل العاصمة إلى فلسطين، وانهيار المملكة السورية،
_ ووقفة أخرى تحت عنوان(الحكومات المحلية من أيلول 1920م إلى 11 نيسان 1921م) ويبين فيها وضع شرقي الأردن بعد انهيار المملكة السورية، وكيف تعامل البريطانيون مع أهلها، وسعوا إلى تشكيل الحكومات المتعددة في مناطقها التي كانت عاجزة عن مواجهة المشكلات العامة أو تحسين الوضع المتدهور في البلاد.
وبعد تلك العتبات يبدأ في الأبواب، على النحو الآتي:
الباب الأول: تأسيس الإمارة الأردنية (1921 – 1928م)
أولًا: قدوم الأمير عبد الله إلى الأردن
بعد أن احتلت فرنسا سورية في آب 1920 وأخرجت الملك فيصل، غضب الشريف حسين وابنه الأمير عبد الله، وقررا استعادة سورية. فقاد الأمير عبد الله نحو (2000) مقاتل من الحجاز إلى معان في 21 تشرين الثاني 1920م، وبدأ اتصالاته بزعماء المنطقة داعيًا للثورة ضد فرنسا. وطالبت فرنسا بريطانيا بوقف نشاط الأمير بوصف تحركاته خرقًا لاتفاق سايكس بيكو، وواجهت بريطانيا حينها ثورة في العراق، فقررت إعادة تنظيم نفوذها في المشرق. وعقد مؤتمر بريطاني في القاهرة في 12 – 24 آذار 1921م وطرحت ثلاثة خيارات بشأن الأمير عبدالله: إخراجه بالقوة، أو الاتفاق معه، أو الاعتماد على القوى المحلية، ورُجِّح الخيار الثاني. وتم الاتفاق بين تشرشل والأمير عبد الله على: إقامة حكومة وطنية في شرقي الأردن برئاسته، واستقلال إداري ومالي مع دعم بريطاني، وبقاء مندوب بريطاني في عمان، وإقامة قواعد جوية بريطانية، وأن تكون هذه الاتفاقية مؤقتة لمدة ستة أشهر.
ثانيًا: إنشاء الإدارة المركزية الأولى
أنشأ الأمير الإدارة المركزية في 11 نيسان 1921، برئاسة رشيد طليع، وكان معظم أعضائها من حزب الاستقلال (أربعة سوريون واثنان من الحجاز، وواحد فلسطيني، وأردني واحد). واستقال طليع في آب 1921 بعد أزمة مع فرنسا وبريطانيا، فتولى مطهر رسلان رئاسة حكومة جديدة، وجاء الكولونيل لورنس إلى عمان في 12 تشرين الأول 1921م، فقام بعدة إجراءات، منها: عزل الموظفين الإنجليز وتولي منصب المعتمد بنفسه، وتوصية باستمرار حكم الأمير عبد الله مع تقليص المخصصات المالية، وإبعاد عناصر حزب الاستقلال من شرقي الأردن، واستثناء شرقي الأردن من وعد بلفور. ووقّع الأمير اتفاقية الحجاز – بريطانيا في 8 كانون الأول 1921م بالنيابة عن والده الملك حسين، لكن لم تُصدّق لاحقًا.
ثالثًا: الانتداب البريطاني
أقرّ مؤتمر الصلح في باريس مبدأ وصاية عصبة الأمم على الشعوب المتخلفة، وتضمن ميثاق العصبة الذي وقع في فرساي في 28 حزيران 1919م نظام الانتداب على البلدان المأهولة بالشعوب التي خرجت من سيادة الدولة التي كانت تحكمها، وعدوا ذلك بمثابة أمانة مقدسة في عنق الحضارة لمساعدة تلك الشعوب على الاستقلال، وأقر المجلس الأعلى للحلفاء في سان ريمو في 25 نيسان 1920م وضع العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني دون أن يرد ذكر شرقي الأردن، وكانت معاهدة سيفر الموقعة في 28/ 6/ 1919م قد نصَّت في المادة 96 على تكليف الدول الكبرى بوضع صيغة لصك الانتداب البريطاني على فلسطين وتقديمها إلى مجلس عصبة الأمم للموافقة عليها، وفي 24 تموز 1922م أقر مجلس عصبة الأمم المنعقد في لندن صيغة الانتداب البريطاني على فلسطين، وصادق عليها في اليوم نفسه، ونصَّت المادة 25 من الصك على استثناء شرقي الأردن من أحكام وعد بلفور، وقدم وزير خارجية بريطانيا مذكرة تفسيرية لهذه المادة من صك الانتداب، إلى مجلس العصبة المنعقد في جنيف في 16 أيلول 1922م، فصادق عليها المجلس في اليوم نفسه، واعتقد الساسة البريطانيون أنه باستثناء شرقي الأردن من أحكام وعد بلفور في صك الانتداب على فلسطين سيرضون العرب عامة والأمير عبدالله خاصة، فخاب ذلك الظن؛ لأن العرب رأوا في الانتداب نقضًا لوعود الحلفاء لهم، ومظهرًا جديدًا من مظاهر التجزئة والاستعمار والسيطرة الغربية؛ ولذلك رفضوه وأعلنوا مقاومتهم له.
رابعًا: زيارة الأمير عبد الله للندن والمفاوضات
بدعوة بريطانية، زار الأمير لندن في تشرين الأول 1922م مع علي رضا الركابي، وطالب بالاستقلال التام لشرقي الأردن، وعقد معاهدة مع بريطانيا، وتحديد الحدود، والحصول على ميناء للبلاد على البحر الأبيض المتوسط، إلا أن هذه المفاوضات توقفت بسبب استقالة الحكومة البريطانية، وظل الركابي في لندن، وتسلم مذكرة بتأجيل الاعتراف بالاستقلال إلى بعد انتهاء مؤتمر لوزان، فعاد إلى عمان في 16 كانون الثاني 1923م وقدم استقالته، وتشكلت حكومة جديدة برئاسة مظهر رسلان في مطلع شباط 1923م، وحاولت بدورها استئناف المفاوضات مع بريطانيا إلا أنها لم توفق،
وتأجل الاعتراف حتى انتهاء مؤتمر لوزان، وفي 25 أيار 1923م أوعزت الحكومة البريطانية للمندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل بزيارة عمان وإلقاء بيان يتضمن الاعتراف بحكومة مستقلة في شرقي الأردن تحت حكم الأمير عبدالله، بشرط دستوريتها والتزامها بالمعاهدات الدولية؛ لتمكن حكومته جلالته البريطانية من إيفاء التزاماتها الدولية المتعلقة بتلك البلاد.
خامسًا: الإدارة والوضع المالي
أ- الإدارة: مارس الأمير _ تحت إشراف المندوب السامي في القدس، وممثله في عمان، المعتمد البريطاني _ سلطاته التنفيذية عبر مجلس المشاورين، ثم المستشارين، ثم الوكلاء، ثم النظار، ومنذ 1926م أصبح يطلق اسم المجلس التنفيذي على مجلس النظار، ولم يزد أعضاء كل مجلس من المجالس السابقة عن خمسة، وكانوا من أعضاء حزب الاستقلال، المعادي لفرنسا في سوريا، وهددت بريطاني الأمير وحكومته إن لم يستبدلوا، فخضعوا لهذه التهديدات وأخرجت عناصر حزب الاستقلال من الإدارة الأردنية، وغادر عدد كبير منهم البلاد، وحلَّ محلهم الموظفون البريطانيون والفلسطينيون، فضمت حكومة حسن خالد أبي الهدى التي تشكلت في 26/ 5/ 1926م أربعة من الإدارة الفلسطينية (ثلاثة عرب، وواحد بريطاني، وواحد أردني)، وفي تعديل هذه الحكومة في 11/ 9/ 1926م أصبح الأعضاء الإنجليز فيها اثنين، بصفتهما مستشارين للشؤون المالية والعدلية، وكان مدير البريد، ومدير الصحة، ومدير الأشغال العامة من الفلسطينيين المعارين، وبلغ عدد الموظفين البريطانيين المعارين للعمل في حكومة شرقي الأردن في 1927م ثمانية، واستمرت إعارة الموظفين من الإدارة الفلسطينية إلى الإدارة الأردنية حتى عام 1939م، حينما أغلق باب الإعارة من الموظفين العرب وأكتفي بالإعارة من الموظفين الإنجليز. وكان جوليوس أبرامسون أول معتمد بريطاني في عمان يقوم بالإشراف الفعلي على الإدارة بصفته ممثلًا للمندوب السامي، ويتولى رئاسة لجنة الأراضي في القدس بالوقت نفسه، واستبدل بجون فيلبي الذي ظل حتى الأول من نيسان 1924م، ليحل محله الكولونيل هنري كوكس، حاكم نابلس سابقًا، ومارس رقابة محكمة على جميع أجهزة الإدارة فلا يعين وزير أو مدير إلا بموافقته. ومنذ عام 1924م ألغيت نيابة العشائر، ورافق ذلك إخراج عناصر حزب الاستقلال من الإدارة الأردنية، وفي 2/ 9/ 1925م صدر قانون للعشائر، أصبح بموجبه للعشائر محاكم خاصة تنظر في قضاياها وشؤونها، وفي 11 نيسان 1926م أحدثت وظيفة مأمور العشائر وألحق برئاسة النظار، وأوكلت إليه مهمة نائب العشائر الملغاة. وظلت شرق الأردن تدار بموجب قانون إدارة الولايات العثمانية، حتى 11 تشرين الأول 1927م عندما صدر قانون أردني جديد، اتخذت البلاد بموجبه اسمها الرسمي (إمارة شرقي الأردن)، وقسمت إلى أربعة ألوية، هي: (عجلون، والبلقاء، والكرك، ومعان)، وبموجب هذا التنظيم الجديد احتفظ حكام التقسيمات الجديدة بألقابهم العثمانية، فحاكم اللواء(متصرف)، وحاكم القضاء(قائمقام)، وحاكم الناحية(مدير)، ونص القانون الجديد على تشكيل مجلس إداري في كل لواء برئاسة المتصرف وعضوية كل من القاضي الشرعي والمحاسب وعضوين منتخبين من الأهالي، يكون أحدهما مسيحيًا إذا وجدت جماعة مسيحية تؤلف طائفة، واشترط في عضوية المجالس الإدارية معرفة القراءة والكتابة، وتكون المدة سنتين. وبخصوص موظفي الدولة في الأردن كانوا يخضعون للقوانين والأنظمة العثمانية حتى صدر أول قانون (مؤقت) للموظفين في 4/ 8/ 1926م، وانيطت بموجبه أمورهم بالمجلس التنفيذي، وحددت درجاتهم وأصنافهم ورواتبهم وكيفية تعيينهم وعقوباتهم بموجب نظام صدر في 5/ 12/ 1926م.
ب _ الوضع المالي: الإمارة فقيرة، ومنذ أن تشكلت الإدارة فيها كانت المعونة الخارجية ضرورة لا بد منها، وفي محادثات الأمير عبدالله مع تشرشل في آذار 1921م تم الاتفاق على تقديم معونة مالية بريطانية سنوية قدرها (180) ألف جنية إسترليني، استعملت وسيلة للضغط والابتزاز ضد الحكومة الأردنية، وبسببها أصبح للمعتمد البريطاني والمستشار المالي البريطاني في نظارة المالية حق الإشراف الدقيق على جميع الشؤون المالية، ومنذ السنة المالية 1925/ 1926م أصبحت مشاريع الموازنة العامة تقدم إلى المعتمد البريطاني، فيحولها إلى المندوب السامي البريطاني في القدس، ومنه إلى وزير المستعمرات في لندن للمصادقة عليها، وفي 18/ 1/ 1928م تأسس فرع لديوان مراجعة (محاسبة) وزارة المستعمرات البريطانية في عمان للنظر في الحسابات المالية والتدقيق في كافة الحسابات الرسمية. وكانت العملات العثمانية والسورية والمصرية هي المتداولة، وفي شباط 1922م صدر قانون النقد رقم 47 الذي حلَّ بموجبه القرش المصري محل القرش السوري في الواردات والنفقات وجميع المعاملات الرسمية، وفي 17/ 3/ 1928م صدر قانون ألغي بموجبه التعامل بالنقد المصري وحلَّ محله النقد الفلسطيني. ودشن أول فرع للبنك العثماني (وهو مصرف بريطاني) في عمان في 30 أيلول 1925م، ووقعت اتفاقية بين الحكومة الأردنية وهذا البنك في 31 تشرين الأول من ذلك العام تقضي بأن يكون المصرف الوحيد الذي تتعامل معه الحكومة.
سادسًا: الجيش
كانت قوات الشرطة والدرك غير كافية قبل1921م،وأنشأ البريطانيون قوة السيارة بقيادة الكابتن بيك لحماية الطرق وإخضاع العصيان،وشرعوا في أيار 1921م ببناء قاعدة لسلاح الجو الملكي في ماركا قرب عمان، وشاركت القوات الأردنية بدعم الطيران البريطاني في صد غارات الوهابيين بين عامي 1922م و1924م،وفي تشرين الأول 1923م سميت القوات بـ”الجيش العربي”، لكنه ظل تحت رقابة بيك وبريطانيا، وفي 1 نيسان 1926م شكلوا “قوة الحدود” تحت قيادة المندوب السامي البريطاني في فلسطين، مما قلّص دور الجيش العربي إلى الأمن الداخلي فقط، وفي 20 شباط 1927م صدر أول قانون ينظم الجيش العربي، وبموجبه أصبح يتألف من: شرطة الأرياف، وشرطة المدن، موظفي السجون.
سابعًا: الوضع الداخلي
لم يرحب شيوخ العشائر والزعماء التقليديون بإنشاء حكومة مركزية في عمان سنة 1921م، إذ خشوا فقدان امتيازاتهم التقليدية، وعندما بدأت الحكومة بممارسة سلطتها واجهت مقاومة عنيفة، كان أبرزها حادث الكورة في أواخر نيسان 1921م بقيادة كليب الشريدة، حيث رفض التنظيمات الجديدة وهاجم الأهالي جباة الضرائب وقوات الدرك، مما أدى إلى معركة انتهت بهزيمة الدرك. وحاول الأمير عبدالله احتواء الموقف فعفا عن المتمردين، لكن ذلك أضعف هيبة الحكومة، ولاحقًا، وبمساعدة البريطانيين، باشتراك سلاح الجو الملكي، نجحت “القوة السيارة” بقيادة الكابتن بيك باشا في إخضاع الكورة، ما عزز نفوذ بيك في الدولة، وقد شجع هذا التمرد غيره من العشائر في الكرك والطفيلة على العصيان، قبل أن يتم احتواؤها. حيث قاد سلطان العدوان احتجاجًا في 1923م على تهميشه وتقريب خصومه (بني صخر) من الأمير، فضلًا عن استياء الشباب الأردنيين المثقفين من هيمنة حزب الاستقلال (السوريين واللبنانيين والفلسطينيين) على الحكم، فدخل العدوان عمان بمظاهرة مسلحة مطالبًا بإشراك الأردنيين في الحكم وإنشاء مجلس نيابي، واستجابت الحكومة جزئيًا فأُقيلت حكومة مظهر رسلان، وشُكِّلت حكومة جديدة ضمت وزيرًا أردنيًا واحدًا، وطرحت برنامجًا إصلاحيًا، لكن حين استمر العدوان في تمرده، واجهته الحكومة بالقوة في معركة الشميساني، بدعم بريطاني، وانتهت بهزيمته ونفي أنصاره. وحدث كذلك تمرد وادي موسى في 1926م، إذ ثار الأهالي على الحكومة لرفضهم الضرائب وأوامر غرس الأشجار، وهاجموا مخافر الدرك، وبعد محاولات التسوية، لجأت الحكومة إلى القوة وفرضت غرامة مالية، فاستسلموا. ويمكن تلخيص أهم أسباب الاضطرابات الداخلية في عهد الإمارة بـمقاومة العشائر للسلطة المركزية الجديدة، وفقدان الزعماء امتيازاتهم في العهد العثماني. والفقر والأوبئة والمجاعات، وضعف الخدمات الحكومية، واستمرار أساليب الإدارة العثمانية بيد الحكام الجدد، وطموح الشباب الأردنيين للمشاركة السياسية بشعار “الأردن للأردنيين” بدلًا من هيمنة غير الأردنيين.
ثامنا: العلاقات الخارجية
أ- العلاقات مع فلسطين: تم ترسيم الحدود بين شرقي الأردن وفلسطين بموجب قانون صدر في 1 أيلول 1922م، وصادق عليه مجلس عصبة الأمم في 23 كانون الثاني 1923م. وظل المندوب السامي في القدس مسؤولًا عن الأردن حتى 1926م فأصبح المندوب السامي في فلسطين يعين مندوبُا ساميًا على شرقي الأردن، واستمرت علاقة إدارية وثيقة بين المنطقتين، بل شكّلتا منطقة جمركية واحدة، واعتمد الأردن على ميناء حيفا في استيراداته.
ب- العلاقات مع سورية: شكّل الأردن قاعدة للثوار السوريين ضد فرنسا منذ 1921م، حيث لجأ إليه قادة حزب الاستقلال وساعدوا الثوار، وأدَّى ذلك إلى توتر العلاقات مع فرنسا، وضغوط بريطانية على الأمير عبدالله لتقييد نشاطهم، لاسيما بعد محاولة اغتيال غورو المندوب الفرنسي في دمشق في 23 حزيران 1921م، إذ نُسب الحادث إلى عناصر من حزب الاستقلال، فطالبت فرنسا بتسليمهم، ورفض الأردن بحجة عدم وجود اتفاقية تبادل المجرمين بينها وبين الحكومة السورية، وتلا ذلك الحادث لجوء إبراهيم هنانو إلى شرقي الأردن في تموز 1921م، إلا أنها اعتقلته بريطانيا في القدس وسلمته لفرنسا، ما أثار احتجاجات في عمان، وفي آب 1924م حصل تمرد حوران ضد السلطات الفرنسية، واستغلت بريطانيا ذلك الحادث لإبعاد حزب الاستقلال عن الأردن. وعندما نشبت الثورة السورية الكبرى 1925–1927م لجأ سلطان الأطرش وأنصاره إلى الأردن، لكن بريطانيا حدّت من دعم الأمير، وأُعلنت الأحكام العرفية في مناطق الحدود حتى رحيل الثوار.
ج- العلاقات مع نجد: اتسمت بالعداء بسبب غارات “الإخوان” على القبائل الأردنية، أبرز الأحداث: غارة وهابيي ابن سعود على بني صخر في منتص آب 1922م، مساعي الأردن للسيطرة على وادي السرحان، ما أدى إلى انعقاد مؤتمر الكويت في 17 كانون الأول 1923م للتفاوض بوساطة بريطانية دون نتيجة، وكررت المفاوضات في 25 آذار 1924م دون التوصل إلى تسوية مرضية،واستؤنفت المفاوضات في 9 _ 12 نيسان 1924م دون جدوى، واستمرت الغزوات المتبادلة بين القبائل الأردنية والنجدية،وشعرت بريطانيا عند تدهور الوضع في الحجاز في أواخر عام 1924م أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع بن سعود حول حدود نجد مع العراق وشرقي الأردن، لذلك أسرعت بإيفاد السير جلبرت كلايتون في أيلول 1925 إلى جدة بمهمة خاصة، للتفاوض مع ابن سعود بشأن الحدود، ونجح كلايتون في مهمته، ووقع مع سلطان نجد معاهدة في بحره 1/ 11/ 1925م، وأخرى في حده 2/ 11/ 1925م بشأن الحدود النجدية العراقية والحدود النجدية الأردنية
د- العلاقات مع الحجاز: لم يعد الحسين بن علي ملك الحجاز شرقي الأردن إلا جزءًا من مملكته وأميرها تابعًا له، وظل الأمير عبدالله محافظًا على ولائه لوالده متمسكًا باحترام آرائه حتى سقطت مملكة الحجاز، ونفي جلالته إلى جزيرة قبرص. وشغلت قضية فلسطين بال الحسين فقام بزيارة إلى شرقي الأردن في مطلع 1924م بقصد الاتصال مع عرب فلسطين وبحث المسألة الفلسطينية مع المندوب السامي البريطاني، فاستقبله أهالي شرقي الأدن بالترحاب والأفراح، وطال بقاء الحسين في عمان فازدادت السلطات البريطانية قلقًا وامتعاضًا، وحانت لها الفرصة عندما أعلنت الجمعية الوطنية التركية إلغاء الخلافة الإسلامية في 3 آذار 1924م، وبويع الحسين بالخلافة الإسلامية في 14/ 3/ 1924م من قبل علماء الحجاز وزعماء شرقي الأردن وأعيان فلسطين، عندها أوعزت السلطات البريطانية إلى إليك كير كبرايد بإشعار الحسين بضرورة مغادرة عمان إلى الحجاز، فغادر البلاد في 20 آذار برفقة ولداه علي وعبدالله. ولما اشتدت الحرب بين ابن سعود والملك حسين نودي في شرقي الأردن بتأليف فرقة من المتطوعين للدفاع عن الأراضي المقدسة، وسافرت الكتيبة الأولى في 5 تشرين الأول 1924م إلا أنها لم تغير شيئًا في ميزان القوى، وتطورت الأمور لصالح ابن سعود. وأخذت مسألة الحدود بين شرقي الأردن والحجاز تشغل أذهان الإنجليز والحكومة الأردنية، وبعد سقوط مملكة الحجاز ونفي الحسين إلى قبرص، ضمت بريطانيا منطقة معان _ العقبة إلى شرقي الأردن سنة 1925م.
الباب الثاني: عهد المؤسسات الدستورية 1928 _ 1946م
أولًا: القانون الأساسي والمؤسسات الجديدة
كان قادة حزب الاستقلال العربي الذين أسهموا في تأسيس الإدارة الأولى في شرق الأردن يطمحون إلى إنشاء حكومة نيابية دستورية، وألحوا على الأمير عبدالله لتحقيق هذه الرغبة، فوافق على تأليف لجنة منتخبة من ممثلي الشعب، ووضعت مشروع قانون لانتخاب المجلس النيابي، تبنته الحكومة، وصدرت إرادة الأمير بالمصادقة عليه، وعلى أثر ذلك تألفت لجنة من علماء القانون لوضع قانون أساسي(دستور) للبلاد عام 1923م، غير أن السلطات البريطانية قاومت هذه التدابير والخطوات لأنها تقف حجر عثرة في سبيل هيمنتها على الإدارة الفتية. وفي 1926م اختارت الحكومة، بإيحاء من دار الاعتماد البريطاني، لجنة لإعادة النظر في قانون الانتخاب السابق الذكر، فما كان منها إلا أن أقرت القانون القديم مع بعض التعديلات الطفيفة، فلم ترض سلطات الانتداب عن القانون الجديد، فعطلته، وتقدمت عوضًا عنه، بمشروع المعاهدة الأردنية _ البريطانية الذي أبرم في 20 شباط 1928م. ونصَّت على وضع قانون أساسي للإمارة يعين مؤسسات الحكم ويحدد صلاحياتها، واشترطت موافقة حكومة الانتداب على أي تعديل يطرأ على هذا القانون في المستقبل، وقدمت حكومة الانتداب لائحة القانون الجديد إلى الحكومة الأردنية، ونشر القانون في 16 نيسان 1928، وكان مماثلًا للقانون الأساسي المعمول به في العراق، وأرسى القواعد الأولية لمؤسسات الحكم، وهي: رئيس الدولة، والمجلس التنفيذي، والمجلس التشريعي، والمؤسسات القضائية(المحاكم بأنواعها)، والشعب وحقوقه. وقد أجريت تعديلات على هذا القانون بين 1928 _ 1946م أبرزها التعديل الذي صدر في 9 حزيران 1929م، بناءً على رغبة الأمير في حماية أعضاء المجلس التشريعي بعدم إلقاء القبض على أي عضو منهم أثناء انعقاد دورة المجلس، ومنحهم حرية الحديث داخل المجلس وفقًا للنظام الداخلي، وتعديل آخر في 29 كانون الثاني 1938م شمل المواد الخاصة بحقوق التملك، والتشغيل الإجباري، وصلاحيات المحاكم الشرعية والطائفية، وتعديل ثالث في 9 آب 1939م منح الأمير رأس الدولة والقائد الأعلى لقواتها المسلحة، وحق التصديق على القوانين وإصدارها ومراقبة تنفيذها،
ثانيًا: الحياة النيابية في عهد الإدارة
قدم المجلس التنفيذي مشروع قانون انتخاب المجلس التشريعي في 17 حزيران 1928م، فأقر مع تعديل طفيف، وصدر في 1 آب 1928م، وبموجبه أصبح المجلس التشريعي مؤلفًا من 16 منتخبًا، وقسمت الإمارة إلى أربع دوائر انتخابية، هي: البلقاء، وعجلون، والكرك، ومعان، وجرت الانتخابات للمجلس التشريعي الأول في شهري كانون الثاني وشباط 1929م، وحلَّ الأمير هذا المجلس في 9 شباط 1931م لخلافهم مع الحكومة حول موازنة ملحقة خاصة قوة الصحراء. وجرت انتخابات المجلس التشريعي الثاني في 1 حزيران 1931م، وجرت انتخابات المجلس الثالث في 16 تشرين الأول 1934م، وانتخب المجلس الرابع في 16 تشرين الأول 1937م، ومُدّدت له سنتان بعد إكمال مدته الدستورية. وفي 20 تشرين الأول 1942م انتخب المجلس الخامس، ومددت له سنتان حتى إعلان الدستور الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية عام 1947م. وفي عهده حصلت البلاد على استقلالها التام ونودي بالأمير عبدالله ملكًا، وألغيت المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1928م، والاتفاقيات الملحقة بها، ووقعت معاهدة جديدة مع بريطانيا في 22 آذار 1946م. وقد كان أعضاء المجلس التنفيذي (مجلس الوزراء) يشكلون ربع أعضاء المجلس التشريعي، وتأثيرهم كبير على بقية الأعضاء، وكان الأمير يشارك المجلس في السلطة التشريعية، وعند الضرورة يصدر قوانين مؤقتة دون الرجوع إلى المجلس، وكان هذا المجلس يمثل الزعامات القبلية وشيوخ العشائر.
ثالثًا: النضال السياسي وتشكيل الأحزاب
بدأ الوعي السياسي بين الأردنيين بطيئًا ومتأخرًا، وأول حزب سياسي تأسس في البلاد هو حزب الشعب في آذار 1927م، وكان حزبًا إصلاحيًا هدفه السعي بالطرق المشروعة لتأييد استقلال البلاد، ونشر المعارف بين الأهلين، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وصيانة الحريات الفردية، ونشر مبادئ المساواة والإخاء بين المواطنين. وكان إبرام المعاهدة الأردنية البريطانية في 20 شباط 1928، يمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ الحياة السياسية في شرق الأردن، إذ لم يكتف المواطنون بالتعبير عن سخطهم عليها بالمظاهرات التي عمَّت المدن أو ببرقيات الاحتجاج التي أمطروا بها الجهات المسؤولة في عمان، بل تنادى زعماؤهم ومثقفوهم إلى عقد أول مؤتمر وطني للنظر في بنود المعاهدة والاتفاق على خطة للعمل السياسي المقبل. فانعقد المؤتمر الأول في 25 تموز 1928م، وتشكل حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني برئاسة حسين الطراونة، وحمل هذا الحزب لواء المعارضة في البلاد حتى عام 1934م، وأصدر صحيفة ناطقة بلسانه، هي (الميثاق) الأسبوعية في 6 آب 1933م، إلا أن الحكومة أوقفتها بعد صدور بضعة أعداد منها فقط. وفي 25 أيار 1930م انعقد المؤتمر الوطني الثالث في مدينة أربد، واتخذ عدة مقررات، أهمها: المطالبة بتشكيل حكومة دستورية مسؤولة أمام مجلس نيابي، وعدم الاعتراف بمشروعية المجلس التشريعي الذي عينته الحكومة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، والاستغناء عن الموظفين المعارين للحكومة، وجباية الضرائب من الشركات الأجنبية صاحبة الامتياز في البلاد، وتشجيع رؤوس الأموال العربية للقيام بمشروعات عمرانية واقتصادية، وعدّ الخط الحديدي الحجازي وقفًا إسلاميًا وتسليم إدارته إلى لجنة إسلامية، وتوسيع التعليم الابتدائي بصورة تسد حاجات البلاد وتأسيس مدارس للبدو، وتوحيد الجهود مع البلاد العربية لدرء الأخطار الاستعمارية والصهيونية، وتحقيق المبادئ القومية، والسعي لإقامة اتحاد عربي يحتفظ كل قطر فيه بخصائصه الداخلية وشكل حكومته الخاص. واتجه قادة المعارضة إلى نشر المقالات المعادية للحكومة في الصحف الصادرة في البلاد العربية المجاورة، فما كان من رئيس الحكومة إلا أنه وجه تحذير إلى تلك الصحف في 17 شباط 1931م، بعدم نشر أي معلومات تجلب الضرر بالمصلحة العامة، وهدد بمعاقبة كل أردني ينشر مقالة معادية في تلك الصحف. وانعقد المؤتمر الوطني الرابع في عمان في 15 آذار 1932م، وقرر عدم الاعتراف بالمعاهدة الأردنية البريطانية، والاستغناء عن الموظفين المعارين، ومقاومة كل محاولة لدخول الصهاينة إلى شرق الأردن، وإلغاء القوانين الاستثنائية، والتعاون مع البلاد العربية. وبعد هذا المؤتمر غابت العناصر القيادية في المعارضة عن مسرح الأحداث، عن طريق النفي والإبعاد والسجن، فاجتمع المؤتمر الوطني الخامس في عمان في 5 حزيران 1933م، وقرر إعلان الولاء والإخلاص لأمير البلاد. وانتقلت المعارضة من صفوف الشعب إلى قاعة المجلس التشريعي، وأثيرت الموضوعات نفسها في قاعة المجلس، فأثار نجيب الشريدة، نائب أربد، موضوع الاستغناء عن الموظفين غير الأردنيين في جلسة المجلس المنعقدة 10 كانون الأول 1930م، وفي جلسة منعقدة بتاريخ 28 كانون الثاني 1931م استنكر نظمي عبدالهادي إنشاء “قوة البادية”. وندد عادل العظمة بامتياز البحر الميت الممنوح لشركة البوتاس الفلسطينية عام 1930م في جلسة المجلس التشريعي المنعقدة في 17 أيلول 1932م. واعترض النائب حسين الطراونة وكذلك عادل العظمة على الاتفاق المعقود مع شركة نفط العراق. وعبرت المعرضة عن احتجاجها على التسلط البريطاني على الإدارة الأردنية بلسان النائب عادل العظمة في هجومه على مشروع الميزانية العامة لعام 1931 _ 1932م. إذ يرى أن القسم الأعظم منها ينفق على موظفين بريطانيين، ومصالح بريطانية محضة في دار الاعتماد، وقوة الحدود، والجيش العربي اسمًا البريطاني حقيقةً، وطرق عسكرية وحصون وإدارة مراقبة أجنبية، ومؤسسات تبشيرية، واستخبارات صحراوية، لا تجني منها البلاد أية فائدة أو ثمرة. وشددت الحكومة قبضتها على زعماء المعارضة، فسنت “قانون الاجتماعات العامة” في 4 أيلول 1933م نصَّ على أن لا يعقد في شرق الأردن اجتماع عام إلا بترخيص من المجلس التنفيذي، وبلغ الاضطهاد السياسي ذروته بإصدار “قانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة 1935م” في 21 كانون الثاني 1935م، للدفاع عن الأمن العام للبلاد، وسلامة القوات البريطانية الموجودة في شرق الأردن، ويمنح هذا القانون الأمير حق وضع الأنظمة المتعلقة برقابة المراسلات، والقبض على الأشخاص أو منع دخولهم البلاد أو إبعادهم، ومراقبة الموانئ وحركة السفن، والمطارات، والنقل البري، والتجارة وتحديد الأسعار. وأخذت النوادي ذات الأهداف السياسية تظهر إلى حيز الوجود، إلا أن السلطة أغلقتها، وأصدرت الحكومة “قانون الجمعيات لسنة 1936م” في 28 تشرين الثاني 1936م الذي يقضي بالحصول على ترخيص من المجلس التنفيذي لكل جمعية أو ناد، وأن تكون مبادئ كل جمعية أو ناد غير مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة الأردنية. ورغم هذه التدابير، حدثت انفجارات في عمان، وقطعت أسلاك الهاتف مرات عديدة، ونسفت أنابيب شركة نفط العراق عدة مرات، وتعرضت أملاك ثلاثة تجار يتعاملون مع اليهود في فلسطين إلى أضرار بالغة، وانضم عدد من أبناء القرى إلى عصابات الثوار في فلسطين… وجرت محاولات للإضراب العام في عمان في تموز 1937م إلا أن تدخل السلطة الفوري أفشلها، وفي تشرين الأول 1937م تشكلت قيادة للأردنيين الأحرار في دمشق، تولت مهمة تهريب الأسلحة إلى الإمارة، ولجأت الحكومة إلى منع حمل الأسلحة في مختلف المناطق في 27 آذار 1937م، وكلفت قائد الجيش العربي، بيك باشا بتنفيذ ذلك. وأصدرت “قانون الإشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها”. ولجأت الحكومة إلى تشكيل “حزب الشعب” برئاسة ناجي العزام، ليحل محل حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني، غير أن خلاف رئيسه مع حكومة إبراهيم هاشم أدَّى إلى إبعاده من الرئاسة. وكان قد تشكل “الحزب الحر المعتدل” في 24 حزيران 1930م من شيوخ العشائر في الكرك المنافسين لحسين الطراونة، وكان زعيم هذا الحزب الشيخ رفيفان المجالي، وتألف “حزب التضامن الأردني” في 24 آذار 1933م، فضم شبابًا من الأردنيين المثقفين. ولما أعلنت الحرب العالمية الثانية، أقدمت الحكومة الأردنية على اتخاذ تدابير أمنية مشددة، فأعلنت العمل بقانون الدفاع عن شرق الأردن اعتبارًا من 29 آب 1939م، وأصدرت سبعة أنظمة دفاع لعام 1939م، ظلت البلاد تحكم بموجبها طوال فترة الحرب، واشتدت الرقابة الحكومية على الحريات العامة، وحدد نظام الدفاع الصادر في 4 مايس 1941م المحطات الإذاعية التي سمح للأردنيين بالاستماع إليها، وهي: محطة لندن، ومحطة القدس، ومحطة القاهرة.
رابعًا: الإدارة والوضع المالي
أ_ الإدارة: بلغ عدد الوزارات التي تألفت في عهد الإمارة ثماني عشرة وزارة، تولى رئاستها ثمانية أشخاص، ثلاثة من أصل فلسطيني، وثلاثة من أصل سوري، وواحد من أصل حجازي، وآخر من أصل لبناني، وبلغ عدد الذين تولوا مناصب وزارية في هذه الفترة 48 وزيرًا بما فيهم رؤساء الوزارات، منهم: 17 وزيرًا من أصل أردني، و13 من أصل فلسطيني، و8 من أصل سوري، و4 من أصل حجازي، و2 من أصل عراقي، وواحد لبناني، و2 من أصل بريطاني.وبقي المجلس التنفيذي قائمًا حتى عدل القانون الأساسي في 25 آب 1939م وحل محله مجلس الوزراء، وأصبح أعضاء المجلس التنفيذي يسمون وزراء، واستمر الإشراف البريطاني على الإدارة بواسطة المعتمد البريطاني في عمان والمستشارين البريطانيين والموظفين الفلسطينيين المعارين من حكومة فلسطين.وحدث تغييرات إدارية في هذه الفترة، كانتقال شؤون الجنسية وإدارة الولايات والجريدة الرسمية والشؤون الصحية، والصلاحيات الواردة في قوانين العقوبات المشتركة ومنع الجرائم والنفي والإبعاد وصيانة المزروعات والحراسة، من رئاسة الوزراء إلى وزارة الداخلية اعتبارًا من 15 آب 1939م، وألحقت دائرة الجوازات بوزارة الداخلية في الأول من تشرين الأول 1941م بعد أن كانت تابعة لقيادة الجيش العربي، وفي الثاني من أيلول 1939م انتقل مركز لواء البلقاء من عمان إلى السلط، وانفصل قضاء عمان عن لواء البلقاء وأصبح يدعى “محافظة العاصمة” يتولاها محافظ بدرجة متصرف، ويقوم بالوقت نفسه بإدارة بلدية العاصمة.واستمرت إعارة الموظفين من حكومة فلسطين إلى الإدارة الأردنية، وازداد عدد الموظفين البريطانيين المعارين إلى الإدارة الأردنية، فكان مدراء الجمارك والزراعة والحراج ومفتش السير ورئيس مفتشي الآثار ومساعده ومفتش البكترلوجيا منهم، بالإضافة إلى مستشاري العدلية والمالية، وأصبح رئيس مفتش المالية ومدير مصلحة المياه منذ عام 1935م منهم. وازداد عدد المعارين منهم عام 1937م، وفي عام 1939م تقرر إعادة الموظفين العرب المعارين من حكومة فلسطين، والاكتفاء بالموظفين البريطانيين.
ب _ الوضع المالي: كانت المعونة المالية البريطانية تشكل أكثر من ثلث مجموع واردات الحكومة،وقد كانت تلك المعونة في ازدياد باضطراد حتى بلغت عام 1943 _ 1944م 79,1% من مجموع الواردات السنوية، أما بالنسبة للواردات الأخرى فكانت الرسوم الجمركية هي التي تحتل المقام الأول، أما النفقات السنوية العامة فقد كانت في العام المالي 1928 _ 1929م (301220) جنيهًا فلسطينيًا، وتضاعفت إلى عشرة أمثالها في نهاية عهد الإمارة فبلغت في العام المالي 1945 _ 1946م (3249630) جنيهًا.وكانت الموازنة الأردنية في عجز دائم، وكانت بريطانيا هي التي تغطي هذا العجز، ومنذ الأول من نيسان 1929م تقرر إلغاء التعامل بالعملة الفضية التركية، بينما بقيت العملة الفلسطينية العملة الرسمية في الإمارة حتى قيام المملكة الأردنية الهاشمية
خامسًا: الجيش
بلغ تعداد الجيش عام 1928م (859) فردًا بينهم 553 من مواليد شرق الأردن، وَ156 من مواليد فلسطين، والبقية من أصل سوري، وفي عام 1929م عين ضابطان بريطانيان في جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للقيادة العامة للجيش، أحدهما مسؤول عن الاتصال بالقبائل البدوية، وفي عام 1930م تولى الميجر جون كلوب الذي اكتسب خبرة جيدة في شؤون البادية أثناء خدمته في العراق، شؤون البادية الأردنية، وأصبح بحكم منصبه الجديد مساعدًا لقائد الجيش الفريق بيك باشا، ويتمتع بصلاحيات متصرف في البادية، ويرأس محكمة العشائر فيها، وأنشأ كلوب “قوة الصحراء” التي أدَّت دور مهم في تطور الجيش الأردني، للاهتمام بتدريبها على العمليات الحربية في الصحراء باستعمال وسائل النقل الحديثة. وأعيد تنظيم الجيش في عام 1936م، وأصبح مدير الإدارة والتدريب ومساعد قائد قوة البادية ومدير الحركة ومفتش مصلحة السير وترخيص السيارات من الضباط الإنجليز، فضلًا عن قائد الجيش ونائبه، وفي عام 1937م تشكلت قوة احتياطية من 115 جنديًا ألحقت بالجيش بصورة مؤقتة، وزيدت هذه القوة حتى بلغت عام 1938م 160 جنديًا، وتألفت قوة إضافية من 334 جنديًا لمواجهة الاضطرابات الداخلية، وأصبح تعداد الجيش في ذلك العام 1621 فردًا(44 ضابطًا وَ1577 جنديًا)، وارتفع احتياطي الجيش عام 1939م إلى 600 جندي. ومع نمو الجيش ازدادت نفقاته، فكانت تشكل 28% من مجموع النفقات السنوية العامة للدولة عام 1924م، ثم أصبحت عام 1936 _ 1937م تشكل 36%، وتضاعفت عام 1945 _ 1946م حتى بلغت 74%. وفي 21 آذار 1939م عين الزعيم كلوب قائدًا للجيش العربي خلفًا للفريق بيك باشا الذي تقرر اعتزاله لخدمته اعتبارًا من 14 حزيران 1939م، وتولى الزعيم لاش Lash قيادة قوة البادية، ورفّع إلى رتبة فريق.
ولما نشبت الحرب العالمية الثانية، كان الجيش الأردني الجيش العربي الوحيد الذي أسهم في المجهود الحربي للحلفاء وخاض المعارك التي دارت رحاها في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل إسهامه في حماية المعسكرات والمخازن البريطانية وطرق المواصلات في فلسطين، والاشتراك في القضاء على الانقلاب في العراق، والحملة على سورية، وحماية خطوط المواصلات البريطانية في الشرق الأوسط. وعرفانًا بإسهام هذا الجيش في الحرب العالمية الثانية، شاركت ثلة منه في مسيرة “يوم النصر” في لندن في 8 حزيران 1946م.
سادسًا: العلاقات الخارجية
أ _ العلاقات مع بريطانيا: لم ترض المعاهدة الأردنية _ البريطانية الفئات الواعية من الأردنيين، ولذلك رفضتها كما رفضت الانتداب من قبلها، ولم تترك فرصة إلا وانتهزتها لطلب تعديل أحكام المعاهدة بشكل يحقق للبلاد استقلالها وحريتها، ولم يتردد الأمير في نقل وجهة نظر المعارضة والفئات الواعية إلى المعتمد البريطاني، فرأت بريطانيا أنه من الحكمة الاستجابة لبعض المطالب الأردنية فاستدعى المندوب السامي البريطاني ويكهوب رئيس المجلس التنفيذي الأردني إبراهيم هاشم إلى القدس، ووقع وإياه اتفاقًا في الثاني من حزيران 1934م اشتمل على تعديل بعض مواد المعاهدة.واستمرت المطالبة بالتعديلات أيضًا إلا أنه لم يتم الاستجابة لها، حتى إذا ما قامت الحرب العالمية الثانية، لم تتوان الحكومة الأردنية عن وضع كافة إمكانيات البلاد تحت تصرف الحليفة بريطانيا، وقدم الجيش الأردني خدمات جليلة للحليفة الكبرى، فكانت المكافأة البريطانية تعديل بعض أحكام المعاهدة بموجب اتفاق أبرم في عمان في 19 تموز 1941م. واستمرت المطالبة بالاستقلال التام. وبعد انتهاء الحرب في أوروبا، بعثت الحكومة الأردنية بمذكرة مؤرخة في 27 حزيران 1945م إلى الحكومة البريطانية، تضمنت رغبتها في الدخول في مفاوضات معها لإعلان استقلال شرق الأردن بأسرع وقت ممكن، فاستجابت بريطانيا للطلب الأردني ووجهت للأمير عبدالله ورئيس وزرائه دعوة لزيارة بريطانيا والتباحث في مستقبل شرق الأردن.وتوجه الأمير عبدالله ورئيس وزرائه إبراهيم هاشم إلى لندن في 20 شباط 1946م، وأجريت مفاوضات بين الوفد الأردني ووزير الخارجية البريطاني المستر بيفن ووكيل الوزارة كريش جونز اختتمت في 22 آذار بتوقيع معاهدة التحالف الأردنية _ البريطانية. نصَّت على إلغاء الانتداب البريطاني على شرق الأردن، وإلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية المبرمة في 20 شباط 1928م، والاتفاقين الإضافيين الموقعين في 2 حزيران 1934م، وَ9 تموز 1941م، اعترفت بريطانيا بشرق الأردن دولة كاملة الاستقلال، وبالأمير عبدالله ملكًا عليها، وأقامت معها تمثيلًا دبلوماسيًا وفقًا للأصول المرعية.
ب _ العلاقات مع فلسطين: كانت فلسطين أول الأقطار العربية التي أثارت اهتمام الأمير في هذه الفترة، وكانت أحداث فلسطين تستدعي مواقف سياسية معينة، فلما احتدم الصراع بين العرب واليهود على حائط البراق عام 1929م بعث الأمير برسالة إلى المندوب السامي البريطاني في 2 تموز 1930م، تضمنت وجهة نظره في النزاع، وطلب منه رفعها إلى الحكومة البريطانية وإلى لجنة التحقيق الدولية التي أوفدتها عصبة الأمم.واحتج الأمير عبدالله على تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين برسالته التي وجهها إلى المندوب السامي البريطاني بتاريخ 18 تشرين الأول 1933م.وتبلورت المقاومة الفلسطينية للمخططات الصهيونية والبريطانية، بقيام الهيئة العربية العليا، التي أعلنت الإضراب والعصيان المدني في فلسطين في 8 أيار 1936م، وفي 22 أيار بعث الأمير عبدالله بمذكرة إلى المندوب السامي طالب فيها بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، كخطوة أولى لإنهاء الإضراب، وفي 5 أيلول 1936م زار المندوب السامي عمان، وتباحث مع الأمير في مسألة الإضراب الفلسطيني، وأبلغه أن الحكومة البريطانية قررت قمع الثورة بالقوة، وحذر الأمير عبدالله من تنفيذ هذه الخطة لأنها ستوغر صدور العرب في جميع أقطارهم ضد الإنجليز، وطلب منه أن يبلغ الحكومة البريطانية بأن تعفو عن حملة السلاح في فلسطين، وتكف التعقيبات عن الحوادث الناجمة عن الإضراب، ومنه الهجرة اليهودية إلى فلسطين أثناء وجود البعثة الملكية البريطانية. وأوفدت بريطانيا لجنة للتحقيق إلى فلسطين، وقدمت اللجنة الملكية تقريرها في 7 تموز 1937م، واشتمل على توصيات بإلغاء نظام الانتداب لمناقضته في أهدافه مع وعد بلفور، واقترحت تقسيم فلسطين إلى ثلاث وحدات سياسية: الأولى تضم السهل الساحلي والجليل وتقام فيها دولة يهودية، والثانية تشمل القدس مع ممر إلى البحر المتوسط، تبقى تحت الانتداب البريطاني، والثالثة مؤلفة من بقية البلاد تضم إلى إمارة شرق الأردن، ورفضت الهيئة العربية العليا والحكومات العربية تلك التوصيات، باستثناء حكومة شرق الأردن، ورفضها اليهود أيضًا في مؤتمرهم الذي انعقد في آب 1937م، وواصلت الحكومة البريطانية تنفيذ خطتها رغم معارضة العرب واليهود لها، وأرسلت لجنة فنية للتقسيم إلى فلسطين في أواخر نيسان 1938م، إلا أن الهيئة العربية العليا قاطعتها وأعلنت الإضراب العام عند وصولها، وكان الأمير عبدالله أكثر إيجابية، إذ قدَّم إلى اللجنة مشروعًا لتسوية القضية الفلسطينية في 23 أيار 1938م، يرى بأنه الحل المثالي؛ لأنه يضمن وحدة فلسطين مع شرق الأردن، والمحافظة على المصالح البريطانية في المنطقة، ومنح اليهود استقلالًا ذاتيًا، وإبقاء العرب أغلبية ساحقة في الدولة الجديدة، غير أن لجنة التقسيم رفضت ذلك المشروع متذرعةً بأنه ليس من اختصاصها النظر فيه. ونشرت الحكومة البريطانية توصيات لجنة التقسيم في 9 تشرين الثاني 1938م وأعلنت في الوقت نفسه عن تخليها عن تلك التوصيات، واقترحت عقد اجتماع في لندن يضم ممثلين عن عرب فلسطين والدول العربية المجاورة، والوكالة اليهودية للنظر في مستقبل فلسطين. وأوفد الحكومة الأردنية توفيق أبا الهدى(رئيس الوزراء) ليمثلها في مؤتمر لندن الذي بدأ أعماله في 7 شباط 1939م، وشارك المندوبين العرب في رفض المشروع البريطاني الذي تقدم به وزير المستعمرات المستر ماكدونالد إلا أن الحكومة البريطانية نشرت ذلك المشروع في كتاب أبيض في 17 أيار 1939، ووافق عليه مجلس العموم واللوردات في 22 منه، وقدم في 15 حزيران إلى لجنة الانتداب الدائمة، فرفضته لمخالفة روح الانتداب كما ترى، ولذلك رفعته إلى مجلس العصبة لاتخاذ القرار النهائي غير أن اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون ذلك. وتمسكت الهيئة العربية العليا ومعظم الحكومات العربية بموقفها المعادي للكتاب الأبيض، أما الأمير عبدالله فكان يعتقد أن في ذلك المشروع مكاسب مهمة للعرب، ولم يدخر وسعًا في حثّ الحكومة البريطانية على تنفيذ ما جاء فيه، وذلك ضمن المشروعات التي طرحها على الحكومة البريطانية والرأي العام العربي بين عام 1940م وعام 1947م، بشأن وحدة سورية الكبرى، وكان هدفه من ذلك إذابة اليهود في دولة عربية كبرى تضم فلسطين وشرق الأردن وسورية ولبنان.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سعى الصهاينة بكل ما لديهم من نفوذ إلى الإسراع بإقامة الدولة اليهودية في فلسطين، ومارسوا ضغوطًا قوية على الحكومتين الأمريكية والبريطانية كانت نتيجتها تأليف لجنة أنجلو _ أمريكية، لبحث مسألة يهود أوروبا والمشكلة الفلسطينية. وقدمت تقريرها في 20 نيسان 1946م، واشتمل على توصيات عدة، منها: وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني حتى يزول الخلاف بين العرب واليهود، ومنع قيام دولة يهودية أو عربية في فلسطين، وإقامة حكم ذاتي بضمانات وتعهدات دولية، وحماية الديانات السماوية(اليهودية والمسيحية والإسلام) في الأراضي المقدسة. واستنكر الأمير عبدالله هذه التوصيات التي تخالف ما جاء في الكتاب الأبيض لعام 1939م وبعث ببرقية إلى ملك بريطانيا وأخرى إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 11 مايس 1946م، ولبى الأمير دعوة الملوك والرؤساء العرب لحضور مؤتمر “أنشاص” في 28 مايس 1946م، وقرر المؤتمر تأييد مطالب عرب فلسطين واستنكار توصيات لجنة التحقيق الأنجلو _ أمريكية.
ج _ العلاقات مع سورية ولبنان: بقيت مشكلة الحدود بين شرقي الأردن وسورية تشغل بال البلدين لحسم الخلافات التي تقع بين العشائر الرحل المتنقلة بينهما، ووقعت اتفاقية حسن جوار بينهما في 31 تشرين الأول 1931م، بعد أن تم تخطيط الحدود وخاصة قسم شرق الأردن _ جبل الدروز، وتضمنت الاتفاقية تعهدًا مشتركًا بحماية الحدود والمحافظة على الحقوق المكتسبة لكل قطر في ضوء الحدود الجديدة. ومنذ عام 1935م شرعت الحكومة الأردنية بمباحثات تمهيدية مع الحكومة السورية لإعادة النظر في الاتفاقية الجمركية المعقودة بين البلدين في 10 مايس 1923م، وطالت المباحثات دون الوصول إلى نتيجة حتى قيام الحرب العالمية الثانية.وقد كان الأمير عبدالله يطمح إلى مشروع سورية الكبرى الذي يضم(سوريا وفلسطين ولبنان وشرقي الأردن) ورأى الفرصة مواتية باستسلام فرنسا للجيوش الألمانية في حزيران 1940م، فبعث بمذكرة إلى المندوب السامي البريطاني في تموز 1940م حثه فيها على إصدار تصريح من جانب بريطانيا لدعم فكرة الوحدة السورية، إلا أنه رفض الطلب ودعا الأمير إلى مزيد من الصبر وعدم التدخل في الشؤون السورية. وتعددت طلبات الأمير بهذا الاتجاه، وعندما أعلنت فرنسا إلغاء الانتداب على سورية ولبنان واستقلالهما، حينها شعر الأمر عبدالله أن الفرصة مواتية لتحقيق تلك الوحدة السورية، واعتقد أن إسهام الأردن الحربي للدول الحليفة سيدعم مسعاه، وبعث برقية إلى المستر تشرشل وزير المستعمرات البريطانية في 22/ 6/ 1941م، وبعد ذلك بأسبوع طلب مجلس الوزراء الأردني من الأمير الاتصال بالحكومات السورية واللبنانية والفلسطينية والتعاون وإياها على العمل لتحقيق الوحدة السورية، إلا أن المعتمد البريطاني في عمان حذر الأمير وحكومته من مغبة الاتصال بالحكومات السورية المذكورة. وواصل الأمير مساعيه مع الجانب البريطاني الذي كان يطلب منه التريث، وحاول الاتصال مع بعدد من الزعماء السوريين واللبنانيين، وفي 24 شباط 1943م ألقى المستر أيدن بيانًا في مجلس العموم زاد الموقف اضطرابًا وتعقيدًا في الشرق الأوسط، إذ جاء فيه أن حكومة صاحب الجلالة ستنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الثقافية والاقتصادية والسياسية، وكذلك أي مبادرة لأي مشروع يجب أن يأتي من جانب العرب إلا أنه حسب معلوماته لم يقدم أي مشروع يحظى بموافقة الجميع. فكان لتلك الكلمات مفعول السحر في العالم العربي، فدعا الأمير عبدالله إلى عقد مؤتمر وطني في عمان في 5 _ 6 آذار 1943م، وأسفر عن تبني مشروعين لوحدة بلاد الشام، المشروع الأول: دولة دستورية نظامها ملكي دستوري، والمشروع الآخر: دولة اتحادية مركزية تشمل حكومات الدول الأربع وعاصمتها دمشق، ويكون الأمير عبدالله رئيسًا للدولة الموحدة أو الاتحادية. واقترح المؤتمرون إقامة اتحاد عربي مؤلف من الدولة السورية الموحدة والعراق، يكون نواة للاتحاد العربي العام تتولى رئاسته أوسع الدول العربية نفوذًا وثروةً ونفوسًا، أو تكون دورية بين الدول الأعضاء. وكان رد فعل الجنرال كاترو _ المندوب السامي الفرنسي في دمشق _ على مقررات مؤتمر عمان الإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية في لبنان وسورية، وأجريت في صيف 1943م وانتخب شكري القوتلي رئسًا للجمهورية السورية، وألف سعد الله الجابري الوزارة السورية الجديدة، واسفرت انتخابات لبنان عن انتخاب الشيخ بشارة الخوري رئيسًا للجمهورية، ورياض الصلح رئيسًا للوزراء.وأثير موضوع الوحدة السورية في المؤتمر العربي التحضيري في الإسكندرية في تشرين الأول 1944م، وأكد المندوب الأردني(توفيق أبو الهدى) على أهمية الموضوع ورغبة سكان الأقطار السورية في الحكم الملكي الدستوري، إلا أن المندوب السوري (سعد الله الجابري) رفض المشروع الأردني، وأصر على تمسك شعب سوريا بالنظام الجمهوري، وأصبح مشروع سورية الكبرى موضوع الساعة في الصحف والإذاعات العربية، وتناولته الأحزاب والهيئات الشعبية المختلفة، وأصبح على كل لسان وشفة. ووقفت بريطانيا موقفًا سلبيًا من هذا المشروع، وعارضته فرنسا بكل ما لديها من نفوذ في سوريا ولبنان، وقاومته الصهيونية العالمية مقاومة عنيفة؛ لأنه يتعارض ومخططاتها في فلسطين، وسعت مصر والسعودية إلى إفشاله؛ لأن قيام دولة كبرى في الأقطار السورية، يهدد زعامة الأولى في العالم العربي، ويشكل خطرًا على نفوذ الثانية في بلاد الشام، وإن كانا يريان بأن في ذلك المشروع فصم عرى الجامعة العربية، إذ طغيان النفوذ البريطاني على سورية الكبرى، سيرمي بالجامعة العربية كلها في أحضان بريطانيا. وفي 22 تشرين الثاني 1946م اتخذ مجلس الجامعة العربية قرارًا باعتبار المشروع مسألة منتهية.
د _ العلاقات مع العربية السعودية: نصَّت المعاهدة المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة البريطانية نيابةً عن إمارة شرق الأردن، على أن تعين الحكومة البريطانية محققًا في الدعاوى التي تنشأ عن الغزوات التي تحدث بين بدو شرق الأردن وبدو العربية السعودية، وفي 22 حزيران 1930م، أصدرت الحكومة الأردنية قانونًا مؤقتًا منح بموجبه المحقق البريطاني المستر ماكدونالد صلاحيات واسعة للنظر في الخلافات التي تنشأ بين بدو البلدين. وأجري تبادل الاعتراف الرسمي بين الحكومة الأردنية والحكومة السعودية لأول مرة في 6 مايس 1933م، ومنذئذ شرعت الحكومتان بالتفاوض لعقد معاهدة صداقة وحسن جوار واتفاقية لتسليم المجرمين وبروتوكول تحكيم بين البلدين.وكان ممثل الإمارة الأردنية في هذه المفاوضات السكرتير العام للحكومة توفيق أبو الهدى والزعيم جون كلوب قائد قوة البادية ومساعد قائد الجيش، وممثل الحكومة البريطانية وزيرها المفوض في جدة السير اندرويان، والمعتمد البريطاني في عمان الكولونيل كوكس، وتم التوقيع على المعاهدة وبروتوكول التحكيم وملحق بالمعاهدة بحروفها الأولى في القدس في 27 تموز 1933م، وتبودلت وثائق الإبرام في القاهرة بتاريخ 21 كانون الأول 1933م.وبموجب هذه المعاهدة تعهد الفريقان بالمحافظة على حسن العلاقات بينهما،وقد كان عبدالعزيز آل سعود يدعم المعارضة الأردنية في دمشق، وعارضت العربية السعودية قيام دولة سورية الكبرى.
ه _ العلاقات مع العراق: ساد العلاقات الأردنية _ العراقية في هذه الفترة التفاهم والتعاون في مختلف الميادين، ففي 26 آذار 1931م وقعت معاهدة صداقة بين الحكومتين نصَّت على الاعتراف المتبادل بينهما وعلى سعيهما لعقد اتفاقات تتناول الشؤون التجارية والبريدية والجمركية والصحية والإقامة والانتقال وتسليم المجرمين، ومراقبة الأمن على الحدود ومنع التعديات، وتبودلت وثائق إبرام هذه المعاهدة في عمان في 24 تشرين الأول 1931م. وفي صيف 1932م خططت الحدود بين البلدين، وفي العام نفسه تم افتتاح طريق حيفا _ بغداد عبر الأراضي الأردنية، وأقيمت شبكة اتصالات هاتفية بين البلدين، وفي 1934م اتمت شركة نفط العراق تمديد الأنابيب من آبارها في كركوك إلى حيفا عبر شرق الأردن. ولما قام انقلاب رشيد عالي في العراق التجأ عبدالاله الوصي على العرش إلى عمان مع مجموعة من كبار السياسيين العراقيين، وأسهم الجيش الأردني في القضاء على حركة رشيد عالي وإعادة الوصي إلى بغداد، ومنذ ذلك التاريخ توثقت الصلات بين عمان وبغداد، وأصبح التشاور في الشؤون الخارجية من التقاليد بين الحكومتين، وفي عام 1945م شرع الأمير عبدالله وابن أخيه الأمير عبدالاله في بحث إمكانية توحيد شرق الأردن والعراق، وفي أيلول من العام التالي قام الأمير عبدالله بزيارة للعراق أسفرت عن الاتفاق بين العاهلين الهاشمين على مشروع اتحاد البلدين يشمل الشؤون الخارجية والثقافية والعسكرية، وإقامة اتحاد جمركي.
و _ شرق الأردن والجامعة العربية: ظلت الدعوة إلى الوحدة العربية حية في نفوس العرب، وتمثلت في المؤتمرات الشعبية والرسمية مثل المؤتمر العربي الذي انعقد في القدس عام 1931م، ومؤتمر بلودان عام 1937م، ومؤتمر البرلمانات العربية عام 1938م.وعشية القضاء على انقلاب رشيد عالي في العراق في 29 أيار 1941م تولت بريطانيا زمام المبادرة وأعلنت على لسان وزير خارجيتها أنتوني أيدن عطفها وتأييدها لكل دعوة إلى الوحدة العربية، فكان الأمير عبدالله أول من استجاب للتصريح، وقدَّم مشروع وحدة سورية الكبرى بمثابة نواة أولى لوحدة عربية شاملة، كما كان نوري السعيد من رواد هذه الدعوة، وتكللت مساعيه عام 1943م بالنجاح، إذ اتفق مع مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر على الدعوة إلى مؤتمر عربي يعقد في الإسكندرية في أيلول 1944م، وانعقد المؤتمر بحضور مندوبين عن كل من شرق الأردن والعراق وسورية ولبنان والسعودية واليمن، وأسفر عن إقرار بروتوكول الإسكندرية في 7 تشرين الأول 1944م، وتألفت لجنة خاصة لوضع ميثاق جامعة الدول العربية، وأبرم الميثاق في 2 نيسان 1945م، ونشر في الجريدة الرسمية الأردنية في 19 منه، وعُدّ نافذ المفعول اعتبارًا من 10 أيار 1945م.
الباب الثالث: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عهد الإمارة
_ الحياة الاقتصادية:
بلغت مساحة شرق الأردن في عهد الإمارة 34700 ميل مربع، تشكل الصحراء(البادية) 83,5% منها، ويعتمد ما يزيد عن 85% من سكان الإمارة على الزراعة وتربية الماشية، وشعر الفلاح في عهد الإمارة بالاطمئنان والأمن وأقبل على الزراعة بهمة وحماس، وسعت الحكومة إلى دفع عجلة التطور الزراعي إلى الأمام بإنشاء مصرف زراعي لتمويل الفلاحين بالقروض، وباشر هذا المصرف عمله في 17 نيسان 1922م، ومنذ عام 1932م خصصت له 3500 جنية فلسطيني، حصة سنوية تدفع من خزينة المالية، وكان يدير هذا المصرف مجلس مكون من وكلاء وزارات المالية والزراعة والداخلية، وممثلين عن دائرة الأراضي وغرفة التجارة والمزارعين. وأنشئ أول محجر بيطري لمعالجة الحيوانات المريضة في شهر آب 1923م، وصدر أول قانون للحراج والغابات في 3 أيلول 1924م، نص على ضرورة تعيين مناطق الحراج وتأليف لجنة فنية لهذه الغاية، وتشكلت أول “لجنة اقتصادية عليا” في البلاد عام 1924م، وعقدت أول اجتماع لها في الغرفة التجارية بعمان في 17 تشرين الثاني 1924م، وقررت إقامة أول معرض صناعي زراعي في العاصمة، وافتتح في 3 مايس 1925م، فكان أول معرض من نوعه في البلاد، وعرضت فيه الأشغال القطنية والحريرية والخشبية والفضية، وأشغال القش والشعر وصناعة الأحذية والحفر والتصوير، وعرضت فيه أيضًا بعض المحصولات الزراعية مثل الحنطة والشعير والزبيب.
وكانت التجارة في أيدي جاليات سورية وفلسطينية استقرت في البلاد منذ العهد العثماني، واقتصرت في بداية الأمر على استيراد بعض الحاجيات البسيطة من سورية وفلسطين والعراق، وأحيانًا من مصر وأوروبا غير أن الحرب العالمية الثانية كانت نقطة تحول مهمة في التجارة الأردنية، إذ شهدت البلاد نشاطًا تجاريًا واسعًا، وأصبحت عمان قبلة أنظار التجار، من البلاد العربية المجاورة، وذلك لعدم وجود قيود صارمة على الاستيراد وتحويل العملات الأجنبية، وعملت الحكومة على إبرام عدة اتفاقيات تجارية مع الأقطار العربية المجاورة، ففي 1923م عقدت اتفاقًا تجاريًا مع سورية ولبنان نص على إعفاء الحاصلات والمنتجات المحلية من رسوم الاستيراد ونقل البضائع الواردة عن طريق ميناء بيروت بواسطة السكك الحديدية، وتوالت الاتفاقيات بهذا الاتجاه، مع السعودية في 2 تشرين الثاني 1925م، ومع فلسطين في 26 أيلول 1928م، وقد كانت شرقي الأردن تحتل المنزلة الثانية بعد العراق في استيراد البضائع عبر فلسطين، وكانت فلسطين المنفذ الوحيد لتصدير المنتجات الأردنية، وبلغت قيمة المحصولات الأردنية التي صدرت برسم الترانزيت عبر فلسطين في عامي 1935 وَ1936م 6000 جنية فلسطيني، وبلغت الصادرات من الحبوب بين عامي 1932 وَ1937م ما بين 15 وَ 20 ألف طن، وارتفعت قيمة هذه الصادرات إلى 285 ألف جنية عام 1941م، وإلى 1044000 جنية عام 1944م. وكانت أمارة شرقي الأردن تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المصدرة إلى سوريا ولبنان، والمرتبة السابعة بين الدول المستوردة من هذين القطرين العربيين.
أما الصناعة فقد كانت بدائية ومقتصرة على بعض الصناعات اليدوية والحرف المحلية من حدادة ونجارة وخياطة وتطريز، ولم تعرف البلاد المصانع أو المعامل أو المناجم في هذه الفترة. واكتشفت مادة الفوسفات قرب الرصيفة شمال شرقي عمان عام 1932م، وتأسست آنذاك شركة للتنقيب عن هذه المادة واستخراجها، وظل إنتاجها محدودًا إلى أن زيد رأسمالها عام 1945م. ونص صك الانتداب البريطاني لشرق الأردن والمعاهدة الأردنية _ البريطانية لعام 1928م على حق بريطانيا في الإشراف على استثمار ثروات البلاد الطبيعية، ولم تسمح حكومة الانتداب بإبرام أي اتفاق أو منح أي امتياز لشركة أو أشخاص غير بريطانيين، فمنحت امتيازًا إلى شركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة (شركة بريطانية مقرها في لندن) في 5 آذار 1926م لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في كل فلسطين وشرق الأردن باستثناء منطقة القدس. ومنح امتياز استثمار أملاح البحر الميت إلى الميجور تولوك والمستر نوفوميسكي في 1 كانون الثاني 1930م، وعملا شركة سمياها “الشركة الفلسطينية للبوتاس” لاستخراج الأملاح المعدنية من البحر الميت واستثمارها لمدة 75 عامًا، وتكون حصة الحكومتين الفلسطينية والأردنية من الأرباح بما يعادل 5% من قيمة الإنتاج المباع، وتكون حصة حكومة الأردن نصف حصة حكومة فلسطين؛ لأن أعمال الشركة ومعاملها على الشاطئ الغربي من البحر الميت(في الأراضي الفلسطينية).
واستمرت الحكومة الأردنية في جباية معظم الضرائب وفقًا للقوانين العثمانية حتى عام 1932م، لتنظم بعدها الضرائب الأردنية: ضرائب أراضي، وأبنية، ومواشي، ودخل سنوي، ورخص صناعات ومهن، ورسوم جمارك ومكوس بموجب قانون الجمارك لعام 1926م، وكانت الحكومة تزيدها كلما شعرت بالحاجة إلى المال، فكانت هذه الضريبة تشكل 15% من مجموع الواردات العام لعام 1937 _ 1938م، وأصبحت عام 1945 _ 1946م تشكل 19% من مجموع الواردات. وفرضت ضريبة الزكاة عام 1944م.
وملخص القول أن هذه الفترة قد اتصفت بالخمول الاقتصادي، فلم تشهد البلاد تطورًا حقيقيًا في الزراعة والصناعة، ولم يتجاوز دخل الفرد الأردني عام 1934 _ 1935م 1218 جنيهًا فلسطينيًا، بينما الفرد المصري في العام نفسه 2780 جنيهًا فلسطينيًا، ودخل الفرد الفسلطيني 4940 جنيهًا، وحرمت البلاد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، ولم تسهم حكومة الانتداب في تطوير الاقتصاد الأردني بل كانت المعونة المالية التي تقدمها لشرقي الأردن تذهب إلى الجيش.
_ الحياة الاجتماعية:
يقدر عدد السكان في عهد الإمارة بين مائتي ألف وأربعمائة ألف نسمة، ينقسمون من حيث أنماط معيشتهم إلى ثلاث فئات، هي: الفلاحون، وسكان المدن، والبدو الرعاة. ويشكل الفلاحون ما يزيد عن 85% من مجموع السكان، ويسكنون القرى بالقرب من مصادر المياه والأراضي الخصبة، ويقيم في تلك القرى عدد من أهل الحرف الذين يقدمون خدمات لسكانها، كالحداد والنجار والبقال والحلاق، ولا توجد في القرى طبقات اجتماعية بالمعنى المعروف، فإنتاجية الأرض جعلت الفوارق بينهم ضئيلة، وكل من يجمع ثروة كبيرة يهاجر إلى المدينة، ولذلك تقتصر الفوارق الاجتماعية فيها على الشهرة والنفوذ في المجتمع، وتعتمد الوجاهة على الملكية الواسعة والروابط الأسرية والعمر والمزايا الشخيصة، والروابط الأسرية في القرية قوية، فالأب صاحب السلطة العليا، والتعاون في العمل فرض على كل فرد في الأسرة، وكان الفلاح في عهد الإمارة ينظر إلى البدوي وساكن المدينة بعين الخوف والكراهية، فالأول يغزوه ويسلب ممتلكاته، والآخر يمثل الظلم الذي يعانيه من موظفي الحكومة والدرك. وتأصلت في نفس الفلاح كراهية السلطة عبر القرون، بسبب التجربة المرة التي عاناها في العهد العثماني، وكان ينظر بازدراء إلى عادات سكان المدن وسلوكهم، ويُعدُّ نفسه أكثر فئات المجتمع ممارسة للعبادة وتمسكًا بالتقاليد الدينية.
ولم يكن في عهد الإمارة مدينة بالمعنى التقليدي للمدن العربية بل وجدت تجمعات سكانية في أربد والسلط وعمان والكرك أقرب إلى القرية الكبيرة منها إلى المدن، ونمت هذه التجمعات وازدادت أهميتها بعد أن أصبحت مراكزًا للإدارة والقضاء والنشاط السياسي والديني والتعليمي، وتجمعت فيها فئات الحرفين ورجال الأعمال والأثرياء من أهالي القرى الطامحين إلى حياة أفضل، وكان في كل مدينة مستشفى وعدد من المساجد والكنائس والحوانيت، ومدرسة حكومية أو أكثر وعدد من المدارس الخاصة، ولم تظهر الصحف إلا في العاصمة عمان، وكان في بعض المدن شبكة للإنارة الكهربائية وأخرى للمياه، ولم يكن للمدن مخطط هندسي. واقتصرت وسائل الترفيه فيها على بعض النوادي الأدبية ذات الأغراض السياسية، وبعض المقاهي التي يرتادها الرجال فقط. وكان فيها طبقتان اجتماعيتان: الأولى مؤلفة من كبار الملاك والتجار والموظفين المدنيين والعسكريين ورجال الدين، والأخرى طبقة الحرفيين والبقالين والعمال، وتشكل غالبية سكان المدينة. وينقسم سكان البادية من حيث أنماط معيشتهم إلى فئتين، هما: رعاة الإبل ورعاة الأغنام، وتقيم الأولى في قلب البادية، وتتنقل الأخرى بين المناطق المأهولة بالسكان وتزاول الزراعة الموسمية في بعض الأحيان، ويطلق اسم “البدو” على رعاة الإبل، أما رعاة الأغنام فيسمون “شوايا”، ورعاة المعز “معزة”، ورعاة الأبقار “بقارة”، ويُعدُّ رعاة الإبل ارستقراط البدو وأشدهم بأسًا. وتأتي عشائر “الصلبة” في أدنى السلم الاجتماعي البدوي، وهي تجوب البادية لتصنع الأدوات وتقدم الخدمات التي يحتاجها البدو، فهي بمثابة طبقة من الحرفيين، لا تنتسب إلى قبيلة معينة، وإنما تلجأ إلى القبائل الكبرى وتدخل في حمايتها، ولا تزاول الغزو ولا تدخل في حرب؛ ولذلك لا يسمح لها بالزواج من القبائل البدوية الأخرى. ولكل قبيلة بدوية “صانعها” أي حدادها وينتقل معها، ويتوارث أبناؤه حرفته، لكن لا يشترك في القتال معها، ولا يعتدى عليه إذا وقع أسيرًا بيد قبيلة أخرى، ولكل صانع أخ من البدو يحميه ويحصل له على أجرته إذا امتنع أحد عن دفعها. ولكل قبيلة مراعيها ومسالكها المعروفة، وقد تتفق بعضها على الشراكة في المراعي أو الآبار، وقد يعتدي بعضها على بعض فيطردها عمَّا تعتاد عليه من مرعى أو آبار. وأشهر القبائل التي تزاول رعي الإبل في البادية الأردنية، هي: الرولة، وبنو صخر، والحويطات، والسرحان. أما القبائل التي تربي الأغنام والماعز، فأهمها: بنو عطية، وبنو حسن، وقبائل الأغوار.
وتُعدُّ القبيلة أكبر الوحدات الاجتماعية في البادية، وتنقسم إلى عدة عشائر، والعشيرة إلى عدة فرق، والفريق إلى عدة أفخاذ، والفخذ إلى عدة حمايل، والحمولة إلى عدة أسر، وتتألف الأسرة من الأب والأم والأجداد والأبناء المتزوجين وزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين وبناتهم غير المتزوجات، أي أنها تتألف، في الغالب، من ثلاثة أجيال: الأحفاد والآباء والأجداد. والوحدة الاجتماعية المهمة في حياة البدوي، هي “الخمسة”، وتضم جميع الأقارب من الأب الذين هم في دائرة الجد الخامس (أو الدرجة الخامسة من القرابة)، وتظهر أهمية هذه الوحدة في الخصومات وقضايا الثأر والدية، فإذا قتل شخص من قبيلة ما آخر من قبيلة ثانية، فإن جميع الرجال الذين هم ضمن دائرة القرابة الخامسة لهم الحق في طلب الثأر، ويُعدُّ أقارب القاتل ضمن الدائرة نفسها مشاركين في مسؤولية الجريمة وبالتالي مطلوبين للثأر. والزعامة أو المشيخة في القبيلة أو العشيرة في غالب الأحيان وراثية، ويساعد كل شيخ “مجلس” من الأعيان يلتقي يوميًا في “مضافة” الشيخ. والشيخ يمثل قبيلته أو عشيرته لدى السلطة، ويحمي شرفها ويعمل لخيرها، ويقضي في الشؤون الخاصة والخلافات بين الأفراد، ويستقبل الضيوف في بيته. وقد أولت الحكومة البدو اهتمامًا خاصًا، فأنشأت “نيابة للعشائر” في أول حكومة أردنية، وألغت في منتصف عام 1926م، وأصبحت شؤون البدو تابعة لنظارة العدلية، وصدر أول قانون لمحاكم العشائر في 1 تشرين الأول 1924م، ونصَّ على إنشاء محاكم للعشائر بأمر من ناظر العدلية، وتنحصر وظيفتها في النظر في الدعاوى الناشئة عن خلافات بين العشائر. ونص القانون على إنشاء محكمة العشائر الاستثنائية في العاصمة لإبداء الرأي في الأحكام التي تصدرها محاكم العشائر. وفي عام 1929م صدر أول قانون للإشراف على البدو، ومراقبة حركاتهم وتنقلاتهم، وفي 10 شباط 1936م صدر قانون جديد وألغى السابق، وفي 12 شباط 1936م صدر قانون آخر بتأليف محكمة استئناف عشائرية ذات صلاحيات مطلقة للنظر والبت في الدعاوى الحقوقية والجزائية التي تعرض عليها بصورة استئنافية من محاكم العشائر. وصدر في اليوم نفسه “قانون محاكم العشائر لسنة 1936” الذي نصَّ على تأليف محكمة العشائر. ولكسب ولاء مشايخ البدو قرر المجلس التنفيذي الأردني في 6 كانون الثاني 1932م منح الذين يشتركون منهم في تعداد مواشي عشيرتهم 15% من الضرائب المستحقة على الجمال، و32% من الغرامة المفروضة على الحيوانات التي حُكِمَ بأنها مهربة.
أما الأقليات في المجتمع الأردني فتتمثل في: الشركس، وهي أقلية مسلمة سهل امتزاجها بالسكان، وأقليات مسيحية نحو الطائفة الأرثوذكسية، والكاثوليك، واللاتين، والبروتستانتية، والأرمنية، وكان المسيحيون أكثر ثقافة وغنًى؛ ولذلك احتلوا المناصب العديدة في الحكم والإدارة، وكانت لهم “مجالس طوائف دينية” تنظر في أمور الزواج والطلاق والمهر والنفقة والإعانة بين الزوج والزوجة والوصية، وقد عين قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1933م تلك الطوائف، ونص على تشكيل محكمة استئناف للنظر في القرارات والأحكام التي تصدر عن مجالس الطوائف. وفي تشرين الأول 1933م صدر نظام للمجالس الطائفية للروم الأرثوذكس أكبر هذه الطوائف، نصَّ على تشكيل مجالس طائفية أرثوذكسية في الكرك ومأدبا وعمان والسلط والحص وعجلون، ويتألف كل مجلس من كاهن رئيسًا وعضوين من الكهنة أو العلمانيين وعضو ملازم من أي منهما يقوم مقام أحد العضوين عند غيابه. وتنتخب الطائفة رئيس المجلس وأعضاءه من أبناء الطائفة الأردنيين.
الباب الرابع: التعليم في عهد الإمارة
اقتصر التعليم الحديث في شرقي الأردن، أبان الحكم العثماني، على بعض المدارس الأولية، وأربع مدارس ابتدائية في أربد والسلط والكرك ومعان، وانتشرت المدارس الأهلية التي كانت على نوعين الكتاتيب ومدارس الطوائف، فكانت الأولى تدرس حفظ القرآن وتجويده معلومات بسيطة في اللغة العربية والحاسب، وكانت الأخرى تتبع الكنائس المسيحية التي تشرف عليها، ومعظمها تابعة لبطريركية الروم والأرثوذكس في القدس، وزاد عدد المدارس الحكومية في عهد الدولة العربية السورية، وبلغ مجموعها 20 مدرسة أولية وابتدائية، ومنذ تأسيس الإمارة بذلت عناية خاصة للتعليم، فبلغ عدد المدارس الحكومية عام 1922م 44 مدرسةً. وفي 1923م احتفل بوضع حجر الأساس للمدرسة السلطانية في السلط، وانعقد فيها أول مؤتمر للمعلمين في شرق الأردن في صيف العام نفسه. واتجهت أنظار المثقفين العرب الذين التحقوا بالأمير عبدالله إلى جعل الإمارة نواة لنهضة علمية عربية عامة، وتأسس أول مجمع علمي في البلاد في 1923م برئاسة سعيد الكرمي، وألحقت بالمجمع مصلحة الآثار، وتقرر إصدار مجلة علمية باسم “المجمع العلمي في الشرق العربي”.
وقررت مديرية المعارف العامة توحيد برامج التدريس في جميع المدارس الحكومية في آب 1923م، وتشكل “أول مجلس معارف” في البلاد في الشهر ذاته برئاسة رئيس المستشارين وعضوية كل من مدير المعارف العامة والمفتش الملكي ومدير الصحة ومدير الأشغال، وأوكلت إليه مهمة اختيار المعلمين وموظفي المعارف بالإضافة إلى الإشراف على مناهج التدريس، وفي 20 أيلول من العام نفسه حل مجلس المعارف وتقرر تشكيل مجلس جديد من سبعة أشخاص يعينهم مجلس النظار(الوزراء) من مديري الدوائر ومن أهل الفضل، وفي 19 تشرين الثاني 1923م تشكل المجلس الجديد. وانفصلت مصلحة الآثار عن مديرية المعارف في أيلول 1923م، وأصبحت مديرية مستقلة مرتبطة برئيس الحكومة، وفي 22 تموز 1925م صدر أول قانون للعاديات من أجل المحافظة على آثار البلاد وصيانتها من العبث وتنظيم عمليات التنقيب عنها. وصدر أول نظام للمدارس في 1 حزيران 1925م، تعينت بموجبه واجبات مدير المدرسة وصلاحياته، ونظام الامتحانات وواجبات المدرسين وشروط قبول التلاميذ وانتقالهم والعقوبات التي تفرض عليهم، ومهمات الضباط(المراقبين) في المدرسة، ووظائف المفتشين. وأقيم أول مهرجان رياضي لمدارس الإمارة عند افتتاح المعرض الصناعي الزراعي في 13 مايس 1925م. وفي 5 نيسان 1926م صدر “قانون التدريسات الابتدائية” فحل محل جميع القوانين والأنظمة التعليمية السابقة الخاصة بالدراسة الابتدائية، ونص على إلزام أهالي القرى أو الأحياء في المدن بدفع رواتب المعلم أو المعاون وأجور المدرسة التي لديهم، وأصبح لمفتش التدريسات الابتدائية حق الإشراف على بناء المدارس وفق المخططات التي تقدمها مديرية المعارف وتحددت المواد التدريسية في المدارس الابتدائية بـ: القرآن الكريم، والقراءة، والخط، والحساب، والهندسة، والجغرافيا، والتاريخ العربي، والعلوم الطبيعية، وحفظ الصحة، والعلوم المدنية، والأخلاقية، والاقتصادية، والأشغال اليدوية، والرسم، والأناشيد، والرياضة البدنية، وألعاب المدارس، والتدريب العسكري للبنين والبنات.
وألغي “قانون مجلس المعارف” لعام 1923م في 28 تموز 1926م، وصدر قانون جديد نص على تشكيل “مجلس المعارف الاستشاري”، وألغي هذا القانون في 19 كانون الثاني 1929م وتألفت عوضًا عن لجنة برئاسة مدير المعارف وعضوية مفتش المعارف ومدير المدارس الثانوية في الإمارة وعدد ممن ينسبهم مدير المعارف من الأساتذة الأخصائيين، وغدت مهمة هذه اللجنة ابداء الرأي في برامج المدارس واختيار الكتب المدرسية وأنظمة المدارس الداخلية، والأمور العلمية والفنية المختصة بالتدريسات. وكان أهم حدث في تاريخ التعليم في عهد الإمارة، صدور نظام المعارف لعام 1939م، الذي قسمت الإمارة بموجبه إلى مناطق معارف ثلاث، هي: منطقة عجلون، ومنطقة البلقاء، ومنطقة الكرك ومعان. وأصبح لكل منطقة مفتش للمعارف يقوم بتفتيش جميع المدارس الأميرية فيها ومراقبة ترقية الطلاب، والإشراف على المدارس الخاصة، وتقديم التوصيات لمدير المعارف بشأن ترفيع ونقل المعلمين والمعلمات والقيام بأية واجبات إدارية أخرى قد يعينها له مدير المعارف، وقسمت المدارس بموجب هذا النظام إلى قسمين: مدارس أميرية تدار من قبل الحكومة، ومدارس خصوصية تؤسس وتدار من قبل الأفراد، أو الجمعيات، أو الطوائف والهيئات الدينية، أما من حيث مستوياتها التدريسية فقسمت إلى خمسة أنواع، هي: مدارس القرى الأولية، والمدارس الأولية في المدن، والمدارس الابتدائية، والمدارس الثانوية، والمدارس الاختصاصية. ومدة الدارسة في الأولية خمس سنوات، وسبع سنوات في المدارس الابتدائية تسمى السنتان الأخيرتان منها بالدورة الابتدائية العليا، وتصدر عن المدارس الأولية والابتدائية شهادة التخرج يصدقها مفتش المعارف المختص. ومدة الدارسة في المدارس الثانوية أربع سنوات، تكون السنتان الأوليان منها دورة ثانوية متوسطة، والسنتان الأخيرتان دورة ثانوية عليا، وتصدر عن المدارس الثانوية المتوسطة شهادة التخرج ويصدقها مدير المعارف، وينتهي التعليم الثانوي الكامل “بفحص شهادة الدراسة الثانوية الأردنية”، ويدفع طالب الدورة المتوسطة ليرتين فلسطينيتين، وطالب الدورة العليا ثلاث ليرات فلسطينية عن كل سنة دراسية. ويقصد بالمدارس الاختصاصية المدارس الصناعية والزراعية، ولم يكن حينها سوى مدرسة الصنائع والفنون في عمان. وأنشئت أول وزارة للمعارف في 24 أيلول 1940م. وعدل “نظام المعارف” لعام 1939م في 17 آب 1944م وأصبح التعليم الابتدائي الكامل ينتهي بفحص عام يسمى “فحص شهادة الدراسة الابتدائية الأردنية” وتصدر شهادة اجتياز الفحص من قبل وزير المعارف. وفي أيلول 1944م صدرت تعليمات فحص شهادة الدراسة الثانوية الأردنية، ونصت على تأليف لجنة فحص مؤلفة من مدير المعارف رئيسًا وعضوية مفتشي المعارف ومن ينتخبهم لهذا الغرض، لانتخاب واضعي الأسئلة ومراقبي الفحوص ومصححيها والتعليمات اللازمة لإجراء الفحص.
ويمكن عرض نمو التعليم في عهد الإمارة من خلال الآتي:
أ_ المدارس الأميرية: كان نموها بطيئًا، إذ كان عددها في 1922 _ 1923م 44 مدرسة 38 للبنين وَ6 للبنات، وعدد المعلمين 69 ومعلمتان فقط، وبلغ عددها في نهاية عهد الأمارة 1946 _ 1947م 77 مدرسة 67 للبنين و10 للبنات، وعدد المعلمين 176، والمعلمات 40. وكان في البلاد مدرستنان ثانويتان في هذه الفترة، هما: مدرسة السلط الثانوية 1923 _ 1946م، ومدرسة إربد التجهيرية 1925 _ 1932م التي ألغي الصفان الثانويان الأخيران منها في 1932م واقتصر التعليم فيها على المرحلة المتوسطة طوال عهد الإمارة. وكان معدل ما تنفقه الحكومة الأردنية سنويًا على الشخص الواحد في الإمارة من أجل التعليم ضئيلًا جدًّا، إذ قدر في 1934 _ 1935م بـ 75 ملا فلسطينيًا، مقابل 182 ملا في فلسطين، و114 ملا في العراق. ونسبة ما انفقته الحكومة الأردنية على شؤون التعليم إلى مجموع النفقات العامة للدولة بدأت بـ 4,4% في العام المالي 1924 _ 1925م، وأخذت تزداد تدريجيًا حتى بلغت في 1928 _ 1929م بـ 7,3%، ثم أخذت تنخفض تدريجيًا حتى بلغت الحضيض عام 1944 _ 1945م بـ 1,06%.
ب _ المدارس الخاصة: كان لها دور مهم في النهضة التعليمية في عهد الإمارة، وتضم هذه المدارس الكتاتيب الإسلامية في القرى والمدن التي تعلم القرآن والقراءة والكتابة وشيئًا من الحساب، والمدارس التي أنشأتها الطوائف المسيحية في البلاد والبعثات التبشيرية، ولم تقتصر على تعليم أبناء تلك الطوائف بل استقبلت التلاميذ من مختلف الأديان والمذاهب، وكانت المدارس الخاصة معادلة في مجموعها لعدد المدارس الحكومية، كما كان عدد تلامذتها مماثلًا لعدد تلامذة المدارس الحكومية. وكانت المادة 14 من القانون الأساسي الأردني الصادر 1929م قد نصَّت على حق الطوائف الدينية والأقليات في إنشاء مدارس خاصة بها لتعليم أفرادها بلسانها “شريطة أن تراعي المقتضيات العامة المنصوص عليها في القانون”، وحدد قانون المعارف لعام 1939م شروط تأسيس هذه المدارس وتعيين المعلمين فيها، وصدر أول نظلم للمدارس الخاصة في شرق الأردن في 20 كانون الثاني 1945م، واشترط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة المعارف عند تأسيس أية مدرسة خاصة، وإشراف الوزارة على مناهج التدريس والكتب المقررة والمصادقة على شهادات المعلمين والمعلمات، وأن يكون مدير المدرسة الخاصة مجازًا من مدرسة ثانوية أو دار معلمين ابتدائية أو حائزًا على مؤهلات علمية مصدقة من وزارة المعارف، وحرم إنشاء مدارس للتعليم المختلط إلا في الثلاثة الصفوف الأولى، وحرم أيضًا تعيين معلمين في مدارس البنات الخاصة ولو لمدة مؤقتة.
وأصبحت جميع المدارس الخاصة خاضعة لتفتيش مفتشي المعارف وأطباء الصحة ومهندس النافعة، وبالمقابل منح تلامذتها حق التقدم لجميع الامتحانات الحكومية، ونمت المدارس الخاصة مع نمو المدارس الحكومية، وبلغ عدد في 1925 _ 1926م 33 مدرسة، وبعد ثلاثة أعوام ارتفع عددها إلى 100 مدرسة، منها 57 مدرسة للطوائف(44 للبنين و13 للبنات)، وتضم 1659 تلميذًا و700 تلميذة. و43 مدرسة للمسلمين تضم 1172 تلميذًا. وأخذ عدد المدارس الخاصة يتناقص حتى أصبح في 1931 _ 1932م 93 مدرسة، منها 44 تابعة للطوائف المسيحية، و49 تابعة للمسلمين، أما عدد التلاميذ فقد تضاعف إذ بلغ 2526 تلميذًا و744 تلميذة. ثم أخذ عدد هذه المدارس بالازدياد وبلغ في 1934 _ 1935م 116 مدرسة ضمت 200 معلم ومعلمة، وفي العام التالي بلغ عددها 118 مدرسة ضمت 5612 تلميذًا و214 معلمًا، وهذا العدد يساوي عدد التلاميذ في مدارس الحكومة في ذلك العام، أما في 1936 _ 1937م فقد انخفض عدد المدارس الخاصة إلى 102 مدرسة ضمت 4710 تلميذًا وَ172 معلمًا ومعلمةً. ولم يشهد العام التالي زيادة في عدد المدارس الخاصة، وإنما ازداد عدد المعلمين إلى 194 معلمًا ومعلمةً، وارتفع عدد التلاميذ إلى 5526 تلميذًا وتلميذةً. وانخفض عدد المدارس الخاصة قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية إلى 77 مدرسة في العام الدراسي 1938 _ 1939م، ضمت 219 معلمًا ومعلمةً وَ3571 تلميذًا وتلميذة، أي أن عدد التلاميذ قد انخفض إلى نصف ما كان عليه قبل عام واحد.
ج _ المدارس المهنية: لا توجد منها في هذه الفترة إلا مدرسة الصنائع والفنون في عمان، وكانت تضم شعبة للحدادة وأخرى للنجارة، وتتألف من صف تمهيدي وثلاثة صفوف صناعية، وكانت تقبل خريجي المدارس الأولية في الصف التمهيدي، بينما تقبل خريجي المدارس الابتدائية الكاملة في الصف الأول الصناعي، وقد احتوت على قسم داخلي للتلاميذ، إلا أن عدد خريجيها كان ضئيلًا فلم يزد في 1947 _ 1948م عن عشرة.
د_ التعليم الجامعي والبعثات العلمية: اعتادت مديرية المعارف أن تبعث بعدد محدود من خريجي المدارس الثانوية المتفوقين للدراسة في جامعات البلاد العربية المجاورة على نفقتها، كما تبعث بالمتفوقات من خريجات المدارس الثانوية إلى دار المعلمات الابتدائية في القدس، وبلغ عدد الطلبة الأردنيين الموفدين إلى الجامعة الأمريكية في بيروت 5 طلاب عام 1928 _ 1929م، كما بلغ عدد الطالبات الموفدات إلى دار المعلمات الابتدائية في القدس 3 طالبات، وظلت مديرية المعارف محافظة على هذا العدد من الموفدين لعدة سنوات. وفي 10 تشرين الأول 1934م قرر المجلس التنفيذي إناطة انتقاء أفراد البعثات العلمية بلجنة انتخاب الموظفين الدائمة، لكن منذ 1939م أوكل أمر انتقاء أفراد البعثات العلمية إلى لجنة من المفتشين برئاسة مدير المعارف، بحيث ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء للتصديق عليها.
أما بالنسبة للموظفين الأردنيين وخاصة أولئك الذين لم تتح لهم ظروفهم الالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية، فقد فضلوا الالتحاق بمدرسة حقوق القدس، وأصدرت الحكومة الأردنية تعليماتها في 9 شباط 1935م بجواز ذلك، شريطة أن يتقدم الموظف بطلب رسمي إلى رئيس الوزراء مرفق بتقرير من رئيس دائرته حول سلوكه ومقدرته، ويحيل رئيس الوزراء جميع الطلبات إلى لجنة خاصة لانتقاء الموظفين المؤهلين، ونصَّت تلك التعليمات على أن تمنح حكومة شرق الأردن شهادة النجاح في القانون بناء على تقرير من مدير المدرسة، وعدّ “شهادة الدروس الحقوقية” التي تمنحها المدرسة أو شهادة النجاح التي يعطيها المجلس التنفيذي الأردني مؤهلًا للتعيين في أي منصب قضائي أو إداري في شرق الأردن أو مؤهلًا للترقية، ونصَّت تلك التعليمات أيضًا على تفضيل شهادة هذه المدرسة للتعيين في الوظائف القضائية والإدارية على أية شهادة من أية مدرسة حقوق أخرى في البلاد العربية، وتشكلت لجنة خاصة لاختيار الموظفين الراغبين في الالتحاق بالمدرسة المذكورة في 24 آذار 1935م، من المستشار القضائي (بريطاني)، ورئيس محكمة الاستئناف والمفتش الإداري، ورغم ذلك ظل عدد الجامعيين في الإمارة محدودًا.
ويلي تلك الأبواب خمسة ملاحق، جاء في الملحق الأول: صك الانتداب البريطاني على فلسطين وشرق الأردن، في 24 يوليو 1922م. وأفرد في الملحق الثاني: المعاهدة المبرمة بين صاحب الجلالة البريطانية وصاحب السمو أمير شرق الأردن في 20 شباط 1928م. وفي الملحق الثالث: القانون الأساسي لشرق الأردن. وأورد في الملحق الرابع: قائمة بأعضاء المجلس التشريعي 2/ 4/ 1929م _ 1/ 11/ 1947م. وفي الملحق الخامس: قائمة بأسماء الوزراء ورؤساء الوزارات الأردنية في عهد الإمارة 11/ 4/ 1921م _ 25/ 5/ 1946م. ويلي تلك الملاحق قائمة مصادر الدراسة ومراجعها، وبعدها فهرس المحتويات، يليه فهرس للمواقع الجغرافية، ففهرس للأعلام، وينهي الكتاب بخارطة لإمارة شرق الأردن.